[align=center]عناية المسلمين بالنحو خدمةً للقرآن الكريم
" اكتسب المسلمون معارف غزيرة من الوحي الكريم ، وكان من ثمار ذلك توجُّههم نحو طلبِ العلم والسعي في مدارسته ، ومن هنا جاء الحرص على خدمة القرآن الكريم ، بحسب ما توفَّر لديهم من وسائل وقدرات علمية . وإذا كان جَمْعُ القرآن يمثل الخطوة الأولى في سبيل العناية بالقرآن الكريم ، فإنَّ وَضْعَ علم النحو يمثل الخطوة الثانية في سبيل المحافظة على سلامة أداء النص القرآني ، بعد أن أخذ اللحن يشيع على ألسنة الناس (1) ، ولم يكن نزول الوحي الكريم قلبًا للجوانب العَقَدية في حياة الناس فحسب ، بل كان أيضًا قلبًا للعادات اللغوية التي نشؤوا عليها ، إذ واجه العرب في قراءة القرآن ظواهر لم يكونوا في سلائفهم التي فُطِروا عليها متفقين ، وكان منها تعدُّد اللهجات ، واختلافها في القرب مِنْ لغة القرآن أو البعد عنها ، ولهذه اللغة من قواعد النطق ما لا يسهل إتقانُه على جميع المتلقِّين يومئذ ، ولا بد لهم من المران حتى يألفوا النص الجديد (2) .
وقد أجمع الذين تصدَّوا لنشأة علوم العربية على أن القرآن الكريم كان الدافع الرئيس لعلماء السلف لوَضْع علم النحو والإعراب ؛ وذلك لأنَّ ظهور اللحن وتَفَشِّيه في الكلام ، وزحفه إلى لسان مَنْ يتلو القرآن ، هو الباعث على تدوين اللغة ، واستنباط قواعد النحو منها ، وعلم العربية شأنه شأن كلِّ العلوم تتطلبه الحوادث والحاجات (3) ، وليس ثمة من علم يظهر فجأة من غير سابقةِ تفكير وتأمُّل فيما يتعلق به ، وهذا قد يستدعي غموض نشأة بعض العلوم ومعرفة واضعها التي ابتدأها .
ويعود التفكير في علم النحو إلى ظاهرة شيوع اللحن والخشية على القرآن منها ؛ وذلك لأن رغبة العرب المسلمين في نشر دينهم إلى الأقوام المختلفة أنشأ أحوالًا جديدة في واقع اللغة ، ما كان العربُ يعهدونها من قبل ، إذ كانت الفطرة اللغوية قبل الإسلام سليمةً صافية . واستمر الحال على هذا في عصر نزول القرآن ، بَيْدَ أن الرواة يذكرون أن بوادر اللحن قد بدأت في الظهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن تلك الروايات أنه سمع رجلًا يلحن في كلامه فقال : « أَرْشِدوا أخاكم » (4) .
ويورد الدارسون بعض الروايات على تَسَرُّب اللحن إلى ألسنة الناس في عهد الخلفاء الراشدين ، وذلك أثر من آثار اختلاط العرب الفصحاء بغيرهم من الشعوب غير العربية ، ممَّا أضعف السليقةَ اللغوية لديهم .
ويروي القرطبي (5) عن أبي مُلَيكة أن أعرابيًّا قدم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : مَنْ يُقرئني ممَّا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فأقرأه رجلٌ (( براءة )) ، فقرأ { أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ } (التوبة: 3) بجرِّ (( رسوله )) . فقال الأعرابي : أوقد بَرِئ الله من رسوله ؟ فإن يكن الله بَرئ من رسوله فأنا أبرأُ منه . فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال : يا أعرابيُّ ، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني قدمْتُ المدينة ، ولا علمَ لي بالقرآن فسألت : مَنْ يقرئني ؟ فأقرأني هذا سورة براءة فقال : (( أنَّ الله بريء من المشركين ورسولِه )) فقلت : أوقد بَرِئ الله من رسوله ؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه . فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابي . قال : فكيف هي يا أمير المؤمنين ؟ قال :
(( ورسولُه )) . فقال الأعرابي : وأنا أبرأ ممَّن برئ الله ورسولُه منه ، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألاَّ يُقرئَ الناسَ إلا عالمٌ باللغة ، وأمر أبا الأسود فوضع النحو " (6).
[align=justify]المصادر :
(1) مراحل تطور الدرس النحوي 28 .
(2) المفصل في تاريخ النحو العربي 32 .
(3) أصول علم العربية في المدينة 286 .
(4) المستدرك 2 / 439 ، كتاب التفسير ، تفسير سورة السجدة . وقال : صحيح الإسناد .
(5) الجامع لأحكام القرآن 1 / 24 . وانظر نزهة الألباء 8 .
(6) أ.د. أحمد محمد الخراط
الأستاذ في كلية الدعوة بالمدينة المنورة
لندوة
عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه
-1421هـ -[/align][/align]
" اكتسب المسلمون معارف غزيرة من الوحي الكريم ، وكان من ثمار ذلك توجُّههم نحو طلبِ العلم والسعي في مدارسته ، ومن هنا جاء الحرص على خدمة القرآن الكريم ، بحسب ما توفَّر لديهم من وسائل وقدرات علمية . وإذا كان جَمْعُ القرآن يمثل الخطوة الأولى في سبيل العناية بالقرآن الكريم ، فإنَّ وَضْعَ علم النحو يمثل الخطوة الثانية في سبيل المحافظة على سلامة أداء النص القرآني ، بعد أن أخذ اللحن يشيع على ألسنة الناس (1) ، ولم يكن نزول الوحي الكريم قلبًا للجوانب العَقَدية في حياة الناس فحسب ، بل كان أيضًا قلبًا للعادات اللغوية التي نشؤوا عليها ، إذ واجه العرب في قراءة القرآن ظواهر لم يكونوا في سلائفهم التي فُطِروا عليها متفقين ، وكان منها تعدُّد اللهجات ، واختلافها في القرب مِنْ لغة القرآن أو البعد عنها ، ولهذه اللغة من قواعد النطق ما لا يسهل إتقانُه على جميع المتلقِّين يومئذ ، ولا بد لهم من المران حتى يألفوا النص الجديد (2) .
وقد أجمع الذين تصدَّوا لنشأة علوم العربية على أن القرآن الكريم كان الدافع الرئيس لعلماء السلف لوَضْع علم النحو والإعراب ؛ وذلك لأنَّ ظهور اللحن وتَفَشِّيه في الكلام ، وزحفه إلى لسان مَنْ يتلو القرآن ، هو الباعث على تدوين اللغة ، واستنباط قواعد النحو منها ، وعلم العربية شأنه شأن كلِّ العلوم تتطلبه الحوادث والحاجات (3) ، وليس ثمة من علم يظهر فجأة من غير سابقةِ تفكير وتأمُّل فيما يتعلق به ، وهذا قد يستدعي غموض نشأة بعض العلوم ومعرفة واضعها التي ابتدأها .
ويعود التفكير في علم النحو إلى ظاهرة شيوع اللحن والخشية على القرآن منها ؛ وذلك لأن رغبة العرب المسلمين في نشر دينهم إلى الأقوام المختلفة أنشأ أحوالًا جديدة في واقع اللغة ، ما كان العربُ يعهدونها من قبل ، إذ كانت الفطرة اللغوية قبل الإسلام سليمةً صافية . واستمر الحال على هذا في عصر نزول القرآن ، بَيْدَ أن الرواة يذكرون أن بوادر اللحن قد بدأت في الظهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن تلك الروايات أنه سمع رجلًا يلحن في كلامه فقال : « أَرْشِدوا أخاكم » (4) .
ويورد الدارسون بعض الروايات على تَسَرُّب اللحن إلى ألسنة الناس في عهد الخلفاء الراشدين ، وذلك أثر من آثار اختلاط العرب الفصحاء بغيرهم من الشعوب غير العربية ، ممَّا أضعف السليقةَ اللغوية لديهم .
ويروي القرطبي (5) عن أبي مُلَيكة أن أعرابيًّا قدم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : مَنْ يُقرئني ممَّا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فأقرأه رجلٌ (( براءة )) ، فقرأ { أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ } (التوبة: 3) بجرِّ (( رسوله )) . فقال الأعرابي : أوقد بَرِئ الله من رسوله ؟ فإن يكن الله بَرئ من رسوله فأنا أبرأُ منه . فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال : يا أعرابيُّ ، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني قدمْتُ المدينة ، ولا علمَ لي بالقرآن فسألت : مَنْ يقرئني ؟ فأقرأني هذا سورة براءة فقال : (( أنَّ الله بريء من المشركين ورسولِه )) فقلت : أوقد بَرِئ الله من رسوله ؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه . فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابي . قال : فكيف هي يا أمير المؤمنين ؟ قال :
(( ورسولُه )) . فقال الأعرابي : وأنا أبرأ ممَّن برئ الله ورسولُه منه ، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألاَّ يُقرئَ الناسَ إلا عالمٌ باللغة ، وأمر أبا الأسود فوضع النحو " (6).
[align=justify]المصادر :
(1) مراحل تطور الدرس النحوي 28 .
(2) المفصل في تاريخ النحو العربي 32 .
(3) أصول علم العربية في المدينة 286 .
(4) المستدرك 2 / 439 ، كتاب التفسير ، تفسير سورة السجدة . وقال : صحيح الإسناد .
(5) الجامع لأحكام القرآن 1 / 24 . وانظر نزهة الألباء 8 .
(6) أ.د. أحمد محمد الخراط
الأستاذ في كلية الدعوة بالمدينة المنورة
لندوة
عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه
-1421هـ -[/align][/align]
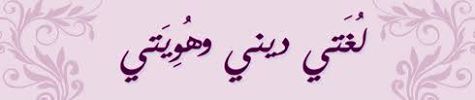
تعليق