قصيدة النثر ما هي ؟
نقلا عن موقع
نقلاُ عن الأستاذ عبدالقادر الجنابي
في مؤتمر قصيدة النثر الذي انعقد في الجامعة الأمريكية في بيروت لثلاثة أيام في يومالسبت 20 آيار 2005
1- صحيح أن مصطلح قصيدة النثر كان شائعا منذ القرن الثامن عشر. فوفقا لسوزان برنار أن أول من أستخدمه هو اليميرت عام 1777، ووفقا لمونيك باران في دراستها عن الايقاع في شعر سان جون بيرس ،أن المصطلح هذا يعود إلى شخص اسمه غارا في مقال له حول "خرائب" فونلي ، وذلك عام 1791. وفي دراسة قيمة ، صدرت في باريس عام 1936 ،
حول "قصيدة النثر في آداب القرن الثامن عشر الفرنسية"، يتضح أن المصطلح كان متداولا في النقاشات الأدبية. على أن بودلير أحدث تغييرا في مصطلح قصيدة النثر، وأطلقها كجنس أدبي قائم بذاته ،بل أول من أخرج المصطلح من دائرة النثر الشعري إلى دائرة النص: الكتلة المؤطرة ولم يكن اعتراف بودلير بمرجعية اليزيوس برتران في هذا المجال اعتباطيا أو مجرد اعتراف بالجميل . وإنما كان تلميحا إلى "معجزة نثر شعري" كان يحلم بانجازها. ذلك أن اليزيوس برتران ، هذا الشاعر الرومانتيكي ، قد ترك تعليمات إلى العاملين على طبع كتابه "غاسبار الليل" ، أن يتركوا فراغا بين فقرة وأخرى مشابها للفراغ المستعمل عادة في تصميمات كتب الشعر، وبهذا يكون أول من التفت إلى تقديم نص نثري ملموم ومؤطر في شكل لم يُعرف من قبل.
كما أن بودلير كان واضحا أنه يعني شيئا جديدا غير موجود ، وذلك عندما كتب في رسالته الشهيرة إلى هوسييه ، "من منا لم يحلمْ في أيام الطموح بمعجزة نثرٍ شعري". إذن من الخطأ الكبير أن نحاول العثور على أشكال لقصيدة النثر البودليرية في ماضي النثر الفرنسي . ذلك أن بودلير في مشروعه نحو لغة شعرية تستطيع ان تتقاطب وما يتجدد مدينيا في شوارع الحياة الحديثة ، جعل كل الشظايا والقِطَع التي كتبت قبله ، تنام كأشباح في ليل النثر الفرنسي ؛
آثارا توحي ولا تُري أية إمكانية نظرية تأسيسية.
2- من الخطأ الشائع اعتبار قصيدة النثر تطورا للنثر الشعري الكلاسيكي الفرنسي وتكملةً له.
ذلك أن ما كان يُطلق عليه قصيدة نثر هو أعمال روائية تتوسل محاسن البديع وتستعير إيقاعات النظم ، لكي ترتقي إلى مصاف الأعمال الشعرية. بينما قصيدة النثر هي قصيدة أداتها النثر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن، أولا، السبب وراء الفكرة التي تقول أن ظهور قصيدة النثر كان تصديا لطغيان العروض ، هو أن النثر، أداة قصيدة النثر، خال من كل قواعد عروضية وبالتالي يمنح حرية أكبر للشاعر لكي يعبر عن انفعالاته الباطنة.
وثانيا : أن تصاعد الرومانتيكية أعطى معنى جديدا لمفردة "الغنائية" lyrique. فبعد أن كانت تُطلق على الشعر الذي يُنظم بقصدِ التغنّي به في موضوعات أو الرواية أو السرد القصصي على أوتار القيثارة القديمة المسماة بالليرا أي القيثارة ، (وهذا يعني ان عنصر الموسيقى جزء حاسم في صياغتها) ... صار لها معنى جديد اعتبارا من الربع الأول من القرن التاسع عشر،
هو: الوظيفة المشاعرية كالحسية المُعبَّر عنها بالصور، بالعاطفة الفردية وأحاسيس الفرد الداخلية ، وباتت مصطلحا يطلق على كل عمل أدبي حتى النثر (وفقا لقاموس ليتريه) يعبر عن الوجدان والعواطف ومتحرر كليا من مضمرات الموسيقى : واقترِحُ كلمة "الوجدانية" كمقابل لـ Lyrique لكي يتضح هذا التغيير الانقلابي والحداثي في الحسية الشعرية التي مهدت الطريق لظهور قصيدة النثر.
3- قصيدة النثر ولدت على الورقة أي كتابيًّا وليس كالشعر على الشفاه أي شفويا. لم ترتبط بالموسيقى كالشعر ولم يقترح كتابها أن تُغنّى ، ولا يمكن أن تُقرأ ملحميا أو بصوت جهوري
يحافظ على الوقفة الإيقاعية القائمة بين بيت وآخر/ سطر وآخر كما في قصائد حركة
"النظم الحر" (وأقصد Vers Libre، لأن ترجمة هذا المصطلح بـ"شعر حر" يخلق سوء فهم مفاده أن الصراع بين الشعر Poésie والنثر، بينما في الحقيقة الصراع هو بين النثر والنظم). إن غياب التقطيع أو التشطير في قصيدة النثر يشكل علامتها الأساسية.ففي النظم الحر، في نهاية كل سطر / بيتٍ فراغ يسميه كلوديل البياض.. وهذا البياض هو لحظة تنفس إيقاعي ضروري لجمالية القصيدة المشطّرة ،كما يتغير فيها الإيقاع من شاعر إلى شاعر بسبب هذه الوقفة القطع في سير الإيقاع ،هذا البياض يمنح القصيدة الحرة هيئتها الشعرية ، بينما قصيدة النثر تكتسب هيئتها وحضورها الشعري من بنية الجملة وبناء الفقرة... والبياض غير موجود (رغم وجود الفواصل والعلامات فيها لأسباب يقتضيها بناء الجملة) إلا في نهاية الفقرة التي تجعل القارئ مستمرا في القراءة حتى النهاية.
وألا ننسى أن أغلب قصائد النثر تتكون من فقرة واحدة ، وبعضها من فقرتين. علينا ألا ننسى أيضا أن "الشعر" كلمة عامة وشاملة يمكن أن تطلق على أي شيء ، بينما كلمة قصيدة تدل على وجود مستقل، بناء لغوي قائم بذاته...
4- قصيدة النثر لا يختلف بناؤها عن قصر المتاهة المذكور في الأساطير اليونانية. يمكن لشاعر قصيدة النثر أن يبدأ من أي مدخل يشاء :
"كان يا ما كان... ""عندما كنا... ""ذات ليلة، عندما.... "
أو على طريقة الشاعر الصديق عباس بيضون ، التي تختار الدخول على نحو مفاجئ :
"الأربعة النائمون على الطاولة وسط الجبال لم يشعروا بخيال الطائر وهو يتضخم في الغرفة.."
المدخل إذن سهل جدا ، ما هو صعب المنال في كتابة قصيدة النثر هو الخروج/ نهاية القصيدة.
لا يكفي أن تعرف كيف تبدأ فحسب وإنما عليك أن تعرف كيف تخرج من ، أي تختم القصيدة ،
كما يقول روبرت بلاي.
5- شاعر قصيدة النثر يَعرفُ مسبقا وذهنيا وإلى حد ما حجم الكتلة/ مساحة القَصر. ذلك أن قَصر المتاهة بناء مكون من حيطان تتعاقب وتتقاطع؛ قصيدة النثر فقرة مكونة من جمل تتلاحق بحدةٍ شديدةٍ هبوطا مما تدفع القارئ إلى أن "يستقرئ العواطف البعيدة أو يجسّ الرِعدات الدقيقة... مستضيئا بالجملة اللاحقة ليُبصر السابقة"، كما قال بشر فارس في تلخيصه عن نوع من القصة القصيرة دون أن يدري انه كان يعرف قصيدة النثر.
6- على أن هناك عنصرا مكونا أساسيا الذي فقط من خلاله يمكننا أن نُميز قصيدة النثر عن باقي الكتل ، النصوص والأشعار النثرية. إنه اللاغرضية (والبعض يترجم gratuité بالمجانية). وهو أشبه بالخيط الذي أعطته أريان إلى ثيسيوس الذي بقي يتتبعه حتى عرف طريقه الى المخرج من المتاهة.
الاختصار brièvetéإذن ، هو نتيجة تقاطب عنصرين اساسيين يعملان داخل قصيدة النثر،
كل وفق حركته ؛ قاعدته : الحدّة intensité حيث السرد المتحرك المنقطع السلك بين حائط وآخر، جملة وأخرى ، يشدنا بسلسة واحدة من البداية حتى النهاية دون أي تباطؤ.. واللاغرضية gratuité ، هو سلك الخيط الذي يقود من المدخل / البداية إلى المخرج /الخاتمة وعلينا أن نتتبعها وإلا سنضيع في متاهة نثر شعري له ألف رأس وألف ذيل ، بينما غايتنا كتلة "لا رأس لها ولا ذيل" كما وضح بودلير..تكمن شعرية قصيدة النثر في هذه اللاغرضية... المجانية. فالنثر بحد ذاته غير قادر على التخلص من وظيفة الوصف بغرضية منطقية. فبفضل عنصر اللاغرضية، يتخلص السرد الذي هو سمة رئيسية في قصيدة النثر، من جفوته، ومنطقيته النثرية، فهو هنا ليس وصف مخطط روائي يريد أن يصل إلى نتيجة ما ، وإنما لغرض فني جمالي محض. عندما يبدأ أنسي الحاج قصيدة له بـ"ذلك العهد يدُ ماموت لم تكن ظهرتْ..." "ذلك العهد" ليس هنا لغاية سياقية تاريخية معلومة ، وإنما لخلق إيحاء جمالي لحدث غير موجود.
7- يجب ألا نخلط بين قصيدة النثر والشظية الفلسفية كما عند نيتشه، ففي هذه الشظايا/ الكتل النثرية القصيرة، ثمة قصد فلسفي وغرضية واضحة ، أو متسترة وراء موعظة ما.
قصيدة النثر هي النثر قصيدةً : كتلة "يتأتى قصَرُها من نظامها الداخلي ، ومن كثافتها النوعية ومن حدتها المتزنة". ليس لها أية غرضية، بل خالية من أي تلميح إلى مرجع شخصي :
كتلة قائمة بذاتها.. أو كما كتب الشاعر الفرنسي ادموند جالو عام 1942،"قطعة نثر موجزة على نحو كاف، منتظمة ومرصوصة مثل قطعة الكريستال يتلاعب فيها مائة انعكاس مختلف
... إبداع حر لا ضرورة أخرى له سوى متعة المؤلف ، خارج أي تصميم ملفق مسبقا ، في بناء شيء متقلص، إيحاءاتُه بلا نهاية، على غرار الهايكو الياباني"
8- "تنطوي قصيدة النثر" النثر، كما تقول سوزان برنار، "في آن على قوة فوضوية،هدامة تطمح إلى نفي الأشكال الموجودة، وقوة منظِمة تهدف إلى بناء (كلٍّ) شعريٍّ؛ ومصطلح قصيدة النثر نفسه يُظهرُ هذه الثنائية". في قصيدة النثر، إذن، توتر كامن يطيح بأية إمكانية توازن بين نقيضين بقدر ما يحتضنهما. وهذا يعني أن قصيدة النثر، كما تقول بربارة جونسن في دراستها الرائدة عن ثورة بودلير الثانية، تتسم بقوتين: إذا الشعرُ هو عَرْضٌ ذو سمة بمواجهة النثر كعرض بلا سمة واضحة، فقصيدة النثر إذا، تتميز بقوتين متعارضتين: حضور ضد غياب السمة و"إحالة الى قانون الشعر" ضد "إحالة الى قانون النثر"... فقصيدة النثر لا هي نقيض ولا هي توليف، إنما هي المجال الذي اعتبارا منه تبطل وظيفة الاستقطابية وبالتالي التناظر بين الحضور والغياب، بين الشعر والنثر". ومن هنا يتفق معظم النقاد على أنهم أمام جنس أدبي شاذ غرضه تهديم الأنواع genres . ناهيك من أن شكلها الوحيد الأوحد، ينطوي أيضا على بعد تهديمي بصري وبالتالي مفهومي ، يقوم بنسف الأفكار المسبقة والعادات المفهومية لدى القارئ الذي ما أن يرى أبياتا أو عبارات مقطعة حتى يصرخ أنها قصيدة، إذ في نظره ليست نثرا.
8- سيداتي سادتي : ما هي قصيدة النثر؟ إنها كل هذا وليس.
لكن الشيءَ المؤكد هو انها نقيض قصيدة النثر العربية السائدة التي لا تلبي مطلبا واحدا مما أتفق جل النقاد عليه، رغم كل الاختلافات بينهم، بشأن قصيدة النثر. هناك أنماط من قصيدة النثر: البارناسية، الرمزية، التكعيبية، السوريالية، الظاهراتية، والأمريكية الغارقة بقضية اللغة والسرد الغرائبي. لكن في كل هذه الأنماط، الشكل واحد أوحد: كتلة قوامها نثر متواصل في جمل تجانس أي نثر آخر.
9- بطبيعة الحال يحق لكل شاعر أن يكتبَ كلٌ وفق نبض أحاسيسه وصوته الخاص، وليسمّ مخلوقاتَهُ كما يشاء، فقط عليه أن يَعرفَ إن مصداقية الشكل والمضمون هي عين ثقة الشاعر بما يقول. وقد يعترض شاعر على أن التسمية ليست ضرورية، ربما، لكن لماذا يسمي "قصيدة نثر" عملا اعتنى بتقطيعه موسيقيا متوسلا كل المحاسن البديعية التي ترفضها قصيدة النثر...
بل حتى شدد على وقفات تُعتبر عاملَ بطءٍ إذا استخدمت في كتلة قصيدة النثر؟
أليس اعتباطا أن يسمّيَ شاعرٌ يكتب عادةً أشعارا موزونة، كلّ قصيدة لا يتمكن من ضبطها عروضيا، قصيدة نثر وليس شعرا فحسب! وكأن الشعرَ في نظره ليس سوى تفعيلات قُررت سلفا.
10- رفض الحدود المرسومة لا يتم إلا عندما يعرف الشاعر ما هي هذه الحدود، وبماذا تتميز...حتى يكون لرفضه فضاؤه هو، مُنقى من كل شوائب التسميات التي كانت من طبيعة تلك الحدود المرفوضة. لقد وقف بروتون ضد فكرة الأجناس الأدبية، معتبرا أن الشعر تعبيرٌ عن استرداد المخيلة البشرية لحقوقها، وليس جنسا أدبيا خاضعا لقوانين مدرسية.... ومن هنا لم يسمّ كـُتـَلهُ النثرية قصائد نثرية رغم أن النقادَ يعتبرون بعضَها قصائدَ نثرٍ بامتياز!إن الإصرار على تسمية عمل جوهرُه يتعارض ، شكلا ومضمونا، مع ما يتميز به هذا الاسم، لهو في نظري، تعبيرٌ عن اعتباطية العمل نفسه.
_______________________________________
قصيدة النثر ومنظومة الحس العربي
كتبه د. ميلاد متى
نقلاً عن الرابط
ما توقفت قصيدة النثر عن إرباك القراء و الناقدين معا ً، منذ ظهورها " رسميا ً " في القرن التاسع عشر في فرنسا مع شارل بودلير ، حين نشر Paris Spleen سنة 1869، كقصيدة نثر ، و التي قال فيها M.Riffaterre : " نوع أدبي يحمل إردافا ً خُلفيا ً كإسم " . و مع ذلك فإن بودلير نفسه شاء أن يقدّم التعريف الأول لهذا النوع " كأعجوبة النثر الشعري ، موسيقي ّ ، و مع ذلك دون وزن ، و من دون قافية . مِطواع ، إلا أنه صارم ٌ و عاصف ٌ إلى حد يتماثل فيه مع نبضات الروح العاطفية ، مع اليقظة الحالمة في مدّها و جزرها ، و مع وخزات الضمير " .و يبدو أن بودلير بعد هذا التعريف الرومانسي المبهم ، قد فتح الباب لنـزعة أدبية سيعزّها و يدللها شعراء في الشرق و الغرب ، كنوع مثالي به يملأون رغبتهم القوية في تعقيدات تركيبية و تأنقات أسلوبية ، حتى أن أية محاولة تعريف واحد كلي ٍّ لهذا النوع ستنتهي بالفشل . أما تعريفRiffaterre فيحمل إشكالية الشعر و النثر منذ أن ظهر الشعر و النثر . فيتضارب مفهوماهما المعجميان التقليديان في أسئلةٍ أقلّها : كيف يكون النثر شعرا ً ؟ و العكس : كيف يكون الشعر نثرا ً ؟ والأصح : كيف نستخرج من النثر شعرا ً ؟ .هذا إذا سلّمنا أننا نملك معايير النثر و الشعر و مفاهيمهما المحددة . وإذا سلّمنا أننا نمسك بناصية الأدب الذي لا يزال غامضا ً، حتى أن أحداً اليوم ، لم يعد يكلّف نفسه مشقة البحث عن تعريفات جديدة له .
يقول ميخائيل نعيمة : " اللغة في القاموس مومياء . أما على ألسنه الناس و شفاههم فكيان حي يزخر بأمواج الأفكار و الخيالات ، و يلتهب بكل أصناف الميول و الإحساسات " فلا عجب إذا ً ، إذا قرأنا عن النحو في قصيدة هي ألفية ابن مالك الشهيرة . و لا عجب إذا عرف القارئ أن طبيباً لبنانياً كتب أطروحته في الأمراض الجلدية شعرا ً، و باللغة التشيكية ، وزنا ً و قافية ً .
الشعر و النثر صنعتان كلاميتان تتقاطعان و تتمازجان ، تنـزلقان باستمرار الواحدة نحو الأخرى , كمن عقباهما على قشرة موز. و حتى لا نغالي في استحالة التعريف ، فإننا نستطيع القول أن قصيدة النثر تبدو للوهلة الأولى مركّباً يستطيع أن يحتوي بعض أو كل ميزات الغنائية . عدا أنه مكتوب ٌ نثرا ً – بالرغم من أنه لا يُعد ّ كذلك – على مساحة الصفحة . هذا المركّب يختلف عن النثر الشعري بقصره و تضامّه . و عن النثر الحر بانعدام الوقفات (=الانقطاعات ) في السطر الواحد ( باعتباره بديلا ً عن البيت أو الجملة ) ، و عن المقطع النثري القصير بما فيه من ايقاعات واضحة ، و تأثيرات صوتية و مجاز و تخيّلات و كثافة في التعبير . و قد يحمل أحيانا ً قوافي داخلية و تعاقب إيقاعات ٍ ( = أوزان ) سريعة . و يمتد طوله عامة ، من نصف صفحة ( مقطع أو مقطعين ) ، إلى صفحتين أو ثلاثة.
هذه الميزات تنطبق على القصيدة النثرية الغربية كما تنطبق على القصيدة النثرية العربية ، و التي سمّاها بعض الدارسين بـ " شعر الحداثة " ، أو " الشعر المعاصر " . و هما تسميتان طغيا إبّان و بعد الإخفاقات و الانكسارات و النكسات العربية الكبرى سياسيا ً و اجتماعيا ً في أواخر الخمسينات و الستينات . فولدت قصيدة النثر العربية من رحِمَي ِ السياسة و المجتمع المهترئين العقيمين آنذاك ، ثائرة ، رافضة ، فاضحة ، هاجمة ، مدمّرة ، محطمة الشكل اللغوي و المضمون التراثي . تغذّيها الثقافة الغربية ولا سيما الفرنسية كما عند أنسي الحاج و بول شاوول .
و برزت رؤيوية سريالية . و أحيانا ً كثيرة ً، هلوسية ، هذرية ، فوضوية عابثة ، لا تهدف إلى شيء ، سوى ربما ، إلى جمالية الغريب و المألوف و اللامنطق .
إلا أن قصيدة النثر العربية اليوم ، وبعد تجربة دامت أكثر من أربعين سنة ، تبدو أكثر نضجا ً و التصاقا ً بالحياة ، تبدو أكثر شفافية ً و هدوءاً . تغلب عليها المعاناة الغنائية من دون أن تتخلى عن نبرتها الثورية المبطنة بالألم ، حيث تتداخل فيها التأثيرات الحضارية و الثقافية .
لقد باتت ملاذا ً لطالبي المساحات الحرة ، حيث لا قوانين و لا معايير تعبيرية مُلتزمة و مُلزمة . هي ملاذ يوافق الحس العربي من حيث :
1- أيدولوجية الفوضى : فوضى في السياسة و المجتمع والاقتصاد . و حتى في الفنون ، و أهمها فوضى الغناء و انحطاطه ، فحدّث ولا حرج .
يقابلها فوضى القصيدة : التراكم و الغموض و الإغراب . و فوضى الشكل : كتابة أفقية ثم عامودية ، ثم انحدارية مائلة ، متقطّعة :
هل يذكر النهر ؟
كانوا يسمونه وردة الميتين
و يمشون خلف المياه
إلى
آخر
العمر
ها هو يمضي بطيئا ً
إنها – أي القصيدة – شِعر ٌ أشعث ، كالشعر الأشعث : مغبرّة ، متغيرة ، متلبدة و منتشرة .
2- الضغط : و منه الاقتصادي و الديني و الذكوري . يقابله كبت ٌ كلامي و انقطاع فجائي أحيانا ً، و ضغط في المعاني و عدم اكتمال الصورة .
3- الرفض : الداخلي غير المُعلن و مخالفة الواقع . فالقصيدة رفضية ، غاضبة ، مغلّفة بالانزياح نحو الممنوع و المُحرّم بلغة اللبس و الإبهام تارة ً ، و بالجرأة و الوقاحة و العُجمة و السوقية طورا ً Vulgarism حتى في قصائد النساء الشاعرات اللواتي سفرن عن وجوههن و لغتهن ّ في آن ٍ معا ً .
4- حال العُدم (= الفقدان ) و العَدَم ( ضد الوجود ) ، لحلّ معضلة الإنسان العربي . أنتجت قصيدة العبثية و اللامنطق و الهلوسة . متخذة ً من الدفق الخيالي و الرؤيوي ركيزة الإبداع .
كل هذا و أكثر ساهم و رفد قصيدة النثر . و عندنا ، أن البحث عن مبررات و عوامل خارجية لتعريف هذا النوع الأدبي ، لا يكفي و لا يمكن تعميمه . فإن بعض كتّاب قصيدة النثر ، ممن خلقوا لأنفسهم عالما ً خارج عالم السياسة و الاقتصاد و الدين ، قدّموا إبداعات ٍ يمكن تصنيفها في باب الفن للفن ، و شعارهم النـزعة الجمالية .
و على هذا ، فإن أفضل مقاربة علمية عملية لقصيدة النثر ، هي تلك المبنية على تعاليم الألسنية ، بحيث يتفكك هذا المركّب إلى عناصره اللغوية الأساسية : من الأصوات ( = الإيقاعات ) ، إلى الحقول المعجمية ، إلى الوظائف الكلامية ، إلى الأنماط النصية ...
و في رأينا أن هذا النوع Genre تمكن دراسته من خلال المقارنة بين الأنواع الكلامية الأخرى : النثر و الشعر و النثر الشعري و الشعر الحر . لأن قصيدة النثر توصّلت إلى التعبير عن روح الشعر متخطية ً القواعد الشكلية المتعارف عليها للنظم التقليدي .
و يُنظر ُ من حيث التخصص - في : كتابة المقطع و الكلام المنقطع ( = غير المُنهى ) ، و استقلالية النص الذاتية . كما يُبحث ُ في التماسك ووحدة المقطع ، و الكثافة و الفعل الشعري القوي . و الهندسة المشغولة : البناء – التطوّر – التوازي – الأصداء و تأثير الانغلاق . و تنوّع الأنماط الكلامية و أشكال الكتابة : السردي ، الوصفي ، الحواري و التأملي ... و أيضا ً في تنوّع التصنيف: الغنائي و الملحمي و الخارق . ولا ننسى الكتابة الشعرية ( = الأسلوب ) : الصور و الإيماء و الإيجاز و الغموض ، و اللمح و المجاز و عدم الملاءمة الدلالية ، و القيمة الرمزية و التشكيلية ...
و بعد ُ، فإننا نستذكر قول ستيفان مالارمي Stephane Mallarme وقد أحسن الإصابة : " الشعر في كل مكان من اللغة ، في كل مكان حيث الإيقاع ، ففي ما نسميه النثر ، شعر من كل إيقاع ٍ يمكن تصوّره ، و بعضه رائع ٌ . و في الواقع ليس هناك من نثر : هناك الألف باء ، ثم الأشكال الشعرية ، أقل أو أكثر صرامة ً ، و أقل أو أكثر إطنابا ً . ففي كل محاولة تعبيرية ( = أسلوب ) أصول شعرية ".
قصيدة النثر هي هذا الشعر في لغة ما . هي حاضرة حضور الأنواع الأخرى التي سبقت و لا تزال . و ستكون أنواعٌ أخر لشعرٍ آخر في لغةٍ أخرى . ما دام هناك مادةٌ هي اللغة ، و ما دام هناك صانع ٌ / شاعرٌ / فنانٌ / ثائرٌ .
نقلا عن موقع
نقلاُ عن الأستاذ عبدالقادر الجنابي
في مؤتمر قصيدة النثر الذي انعقد في الجامعة الأمريكية في بيروت لثلاثة أيام في يومالسبت 20 آيار 2005
1- صحيح أن مصطلح قصيدة النثر كان شائعا منذ القرن الثامن عشر. فوفقا لسوزان برنار أن أول من أستخدمه هو اليميرت عام 1777، ووفقا لمونيك باران في دراستها عن الايقاع في شعر سان جون بيرس ،أن المصطلح هذا يعود إلى شخص اسمه غارا في مقال له حول "خرائب" فونلي ، وذلك عام 1791. وفي دراسة قيمة ، صدرت في باريس عام 1936 ،
حول "قصيدة النثر في آداب القرن الثامن عشر الفرنسية"، يتضح أن المصطلح كان متداولا في النقاشات الأدبية. على أن بودلير أحدث تغييرا في مصطلح قصيدة النثر، وأطلقها كجنس أدبي قائم بذاته ،بل أول من أخرج المصطلح من دائرة النثر الشعري إلى دائرة النص: الكتلة المؤطرة ولم يكن اعتراف بودلير بمرجعية اليزيوس برتران في هذا المجال اعتباطيا أو مجرد اعتراف بالجميل . وإنما كان تلميحا إلى "معجزة نثر شعري" كان يحلم بانجازها. ذلك أن اليزيوس برتران ، هذا الشاعر الرومانتيكي ، قد ترك تعليمات إلى العاملين على طبع كتابه "غاسبار الليل" ، أن يتركوا فراغا بين فقرة وأخرى مشابها للفراغ المستعمل عادة في تصميمات كتب الشعر، وبهذا يكون أول من التفت إلى تقديم نص نثري ملموم ومؤطر في شكل لم يُعرف من قبل.
كما أن بودلير كان واضحا أنه يعني شيئا جديدا غير موجود ، وذلك عندما كتب في رسالته الشهيرة إلى هوسييه ، "من منا لم يحلمْ في أيام الطموح بمعجزة نثرٍ شعري". إذن من الخطأ الكبير أن نحاول العثور على أشكال لقصيدة النثر البودليرية في ماضي النثر الفرنسي . ذلك أن بودلير في مشروعه نحو لغة شعرية تستطيع ان تتقاطب وما يتجدد مدينيا في شوارع الحياة الحديثة ، جعل كل الشظايا والقِطَع التي كتبت قبله ، تنام كأشباح في ليل النثر الفرنسي ؛
آثارا توحي ولا تُري أية إمكانية نظرية تأسيسية.
2- من الخطأ الشائع اعتبار قصيدة النثر تطورا للنثر الشعري الكلاسيكي الفرنسي وتكملةً له.
ذلك أن ما كان يُطلق عليه قصيدة نثر هو أعمال روائية تتوسل محاسن البديع وتستعير إيقاعات النظم ، لكي ترتقي إلى مصاف الأعمال الشعرية. بينما قصيدة النثر هي قصيدة أداتها النثر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن، أولا، السبب وراء الفكرة التي تقول أن ظهور قصيدة النثر كان تصديا لطغيان العروض ، هو أن النثر، أداة قصيدة النثر، خال من كل قواعد عروضية وبالتالي يمنح حرية أكبر للشاعر لكي يعبر عن انفعالاته الباطنة.
وثانيا : أن تصاعد الرومانتيكية أعطى معنى جديدا لمفردة "الغنائية" lyrique. فبعد أن كانت تُطلق على الشعر الذي يُنظم بقصدِ التغنّي به في موضوعات أو الرواية أو السرد القصصي على أوتار القيثارة القديمة المسماة بالليرا أي القيثارة ، (وهذا يعني ان عنصر الموسيقى جزء حاسم في صياغتها) ... صار لها معنى جديد اعتبارا من الربع الأول من القرن التاسع عشر،
هو: الوظيفة المشاعرية كالحسية المُعبَّر عنها بالصور، بالعاطفة الفردية وأحاسيس الفرد الداخلية ، وباتت مصطلحا يطلق على كل عمل أدبي حتى النثر (وفقا لقاموس ليتريه) يعبر عن الوجدان والعواطف ومتحرر كليا من مضمرات الموسيقى : واقترِحُ كلمة "الوجدانية" كمقابل لـ Lyrique لكي يتضح هذا التغيير الانقلابي والحداثي في الحسية الشعرية التي مهدت الطريق لظهور قصيدة النثر.
3- قصيدة النثر ولدت على الورقة أي كتابيًّا وليس كالشعر على الشفاه أي شفويا. لم ترتبط بالموسيقى كالشعر ولم يقترح كتابها أن تُغنّى ، ولا يمكن أن تُقرأ ملحميا أو بصوت جهوري
يحافظ على الوقفة الإيقاعية القائمة بين بيت وآخر/ سطر وآخر كما في قصائد حركة
"النظم الحر" (وأقصد Vers Libre، لأن ترجمة هذا المصطلح بـ"شعر حر" يخلق سوء فهم مفاده أن الصراع بين الشعر Poésie والنثر، بينما في الحقيقة الصراع هو بين النثر والنظم). إن غياب التقطيع أو التشطير في قصيدة النثر يشكل علامتها الأساسية.ففي النظم الحر، في نهاية كل سطر / بيتٍ فراغ يسميه كلوديل البياض.. وهذا البياض هو لحظة تنفس إيقاعي ضروري لجمالية القصيدة المشطّرة ،كما يتغير فيها الإيقاع من شاعر إلى شاعر بسبب هذه الوقفة القطع في سير الإيقاع ،هذا البياض يمنح القصيدة الحرة هيئتها الشعرية ، بينما قصيدة النثر تكتسب هيئتها وحضورها الشعري من بنية الجملة وبناء الفقرة... والبياض غير موجود (رغم وجود الفواصل والعلامات فيها لأسباب يقتضيها بناء الجملة) إلا في نهاية الفقرة التي تجعل القارئ مستمرا في القراءة حتى النهاية.
وألا ننسى أن أغلب قصائد النثر تتكون من فقرة واحدة ، وبعضها من فقرتين. علينا ألا ننسى أيضا أن "الشعر" كلمة عامة وشاملة يمكن أن تطلق على أي شيء ، بينما كلمة قصيدة تدل على وجود مستقل، بناء لغوي قائم بذاته...
4- قصيدة النثر لا يختلف بناؤها عن قصر المتاهة المذكور في الأساطير اليونانية. يمكن لشاعر قصيدة النثر أن يبدأ من أي مدخل يشاء :
"كان يا ما كان... ""عندما كنا... ""ذات ليلة، عندما.... "
أو على طريقة الشاعر الصديق عباس بيضون ، التي تختار الدخول على نحو مفاجئ :
"الأربعة النائمون على الطاولة وسط الجبال لم يشعروا بخيال الطائر وهو يتضخم في الغرفة.."
المدخل إذن سهل جدا ، ما هو صعب المنال في كتابة قصيدة النثر هو الخروج/ نهاية القصيدة.
لا يكفي أن تعرف كيف تبدأ فحسب وإنما عليك أن تعرف كيف تخرج من ، أي تختم القصيدة ،
كما يقول روبرت بلاي.
5- شاعر قصيدة النثر يَعرفُ مسبقا وذهنيا وإلى حد ما حجم الكتلة/ مساحة القَصر. ذلك أن قَصر المتاهة بناء مكون من حيطان تتعاقب وتتقاطع؛ قصيدة النثر فقرة مكونة من جمل تتلاحق بحدةٍ شديدةٍ هبوطا مما تدفع القارئ إلى أن "يستقرئ العواطف البعيدة أو يجسّ الرِعدات الدقيقة... مستضيئا بالجملة اللاحقة ليُبصر السابقة"، كما قال بشر فارس في تلخيصه عن نوع من القصة القصيرة دون أن يدري انه كان يعرف قصيدة النثر.
6- على أن هناك عنصرا مكونا أساسيا الذي فقط من خلاله يمكننا أن نُميز قصيدة النثر عن باقي الكتل ، النصوص والأشعار النثرية. إنه اللاغرضية (والبعض يترجم gratuité بالمجانية). وهو أشبه بالخيط الذي أعطته أريان إلى ثيسيوس الذي بقي يتتبعه حتى عرف طريقه الى المخرج من المتاهة.
الاختصار brièvetéإذن ، هو نتيجة تقاطب عنصرين اساسيين يعملان داخل قصيدة النثر،
كل وفق حركته ؛ قاعدته : الحدّة intensité حيث السرد المتحرك المنقطع السلك بين حائط وآخر، جملة وأخرى ، يشدنا بسلسة واحدة من البداية حتى النهاية دون أي تباطؤ.. واللاغرضية gratuité ، هو سلك الخيط الذي يقود من المدخل / البداية إلى المخرج /الخاتمة وعلينا أن نتتبعها وإلا سنضيع في متاهة نثر شعري له ألف رأس وألف ذيل ، بينما غايتنا كتلة "لا رأس لها ولا ذيل" كما وضح بودلير..تكمن شعرية قصيدة النثر في هذه اللاغرضية... المجانية. فالنثر بحد ذاته غير قادر على التخلص من وظيفة الوصف بغرضية منطقية. فبفضل عنصر اللاغرضية، يتخلص السرد الذي هو سمة رئيسية في قصيدة النثر، من جفوته، ومنطقيته النثرية، فهو هنا ليس وصف مخطط روائي يريد أن يصل إلى نتيجة ما ، وإنما لغرض فني جمالي محض. عندما يبدأ أنسي الحاج قصيدة له بـ"ذلك العهد يدُ ماموت لم تكن ظهرتْ..." "ذلك العهد" ليس هنا لغاية سياقية تاريخية معلومة ، وإنما لخلق إيحاء جمالي لحدث غير موجود.
7- يجب ألا نخلط بين قصيدة النثر والشظية الفلسفية كما عند نيتشه، ففي هذه الشظايا/ الكتل النثرية القصيرة، ثمة قصد فلسفي وغرضية واضحة ، أو متسترة وراء موعظة ما.
قصيدة النثر هي النثر قصيدةً : كتلة "يتأتى قصَرُها من نظامها الداخلي ، ومن كثافتها النوعية ومن حدتها المتزنة". ليس لها أية غرضية، بل خالية من أي تلميح إلى مرجع شخصي :
كتلة قائمة بذاتها.. أو كما كتب الشاعر الفرنسي ادموند جالو عام 1942،"قطعة نثر موجزة على نحو كاف، منتظمة ومرصوصة مثل قطعة الكريستال يتلاعب فيها مائة انعكاس مختلف
... إبداع حر لا ضرورة أخرى له سوى متعة المؤلف ، خارج أي تصميم ملفق مسبقا ، في بناء شيء متقلص، إيحاءاتُه بلا نهاية، على غرار الهايكو الياباني"
8- "تنطوي قصيدة النثر" النثر، كما تقول سوزان برنار، "في آن على قوة فوضوية،هدامة تطمح إلى نفي الأشكال الموجودة، وقوة منظِمة تهدف إلى بناء (كلٍّ) شعريٍّ؛ ومصطلح قصيدة النثر نفسه يُظهرُ هذه الثنائية". في قصيدة النثر، إذن، توتر كامن يطيح بأية إمكانية توازن بين نقيضين بقدر ما يحتضنهما. وهذا يعني أن قصيدة النثر، كما تقول بربارة جونسن في دراستها الرائدة عن ثورة بودلير الثانية، تتسم بقوتين: إذا الشعرُ هو عَرْضٌ ذو سمة بمواجهة النثر كعرض بلا سمة واضحة، فقصيدة النثر إذا، تتميز بقوتين متعارضتين: حضور ضد غياب السمة و"إحالة الى قانون الشعر" ضد "إحالة الى قانون النثر"... فقصيدة النثر لا هي نقيض ولا هي توليف، إنما هي المجال الذي اعتبارا منه تبطل وظيفة الاستقطابية وبالتالي التناظر بين الحضور والغياب، بين الشعر والنثر". ومن هنا يتفق معظم النقاد على أنهم أمام جنس أدبي شاذ غرضه تهديم الأنواع genres . ناهيك من أن شكلها الوحيد الأوحد، ينطوي أيضا على بعد تهديمي بصري وبالتالي مفهومي ، يقوم بنسف الأفكار المسبقة والعادات المفهومية لدى القارئ الذي ما أن يرى أبياتا أو عبارات مقطعة حتى يصرخ أنها قصيدة، إذ في نظره ليست نثرا.
8- سيداتي سادتي : ما هي قصيدة النثر؟ إنها كل هذا وليس.
لكن الشيءَ المؤكد هو انها نقيض قصيدة النثر العربية السائدة التي لا تلبي مطلبا واحدا مما أتفق جل النقاد عليه، رغم كل الاختلافات بينهم، بشأن قصيدة النثر. هناك أنماط من قصيدة النثر: البارناسية، الرمزية، التكعيبية، السوريالية، الظاهراتية، والأمريكية الغارقة بقضية اللغة والسرد الغرائبي. لكن في كل هذه الأنماط، الشكل واحد أوحد: كتلة قوامها نثر متواصل في جمل تجانس أي نثر آخر.
9- بطبيعة الحال يحق لكل شاعر أن يكتبَ كلٌ وفق نبض أحاسيسه وصوته الخاص، وليسمّ مخلوقاتَهُ كما يشاء، فقط عليه أن يَعرفَ إن مصداقية الشكل والمضمون هي عين ثقة الشاعر بما يقول. وقد يعترض شاعر على أن التسمية ليست ضرورية، ربما، لكن لماذا يسمي "قصيدة نثر" عملا اعتنى بتقطيعه موسيقيا متوسلا كل المحاسن البديعية التي ترفضها قصيدة النثر...
بل حتى شدد على وقفات تُعتبر عاملَ بطءٍ إذا استخدمت في كتلة قصيدة النثر؟
أليس اعتباطا أن يسمّيَ شاعرٌ يكتب عادةً أشعارا موزونة، كلّ قصيدة لا يتمكن من ضبطها عروضيا، قصيدة نثر وليس شعرا فحسب! وكأن الشعرَ في نظره ليس سوى تفعيلات قُررت سلفا.
10- رفض الحدود المرسومة لا يتم إلا عندما يعرف الشاعر ما هي هذه الحدود، وبماذا تتميز...حتى يكون لرفضه فضاؤه هو، مُنقى من كل شوائب التسميات التي كانت من طبيعة تلك الحدود المرفوضة. لقد وقف بروتون ضد فكرة الأجناس الأدبية، معتبرا أن الشعر تعبيرٌ عن استرداد المخيلة البشرية لحقوقها، وليس جنسا أدبيا خاضعا لقوانين مدرسية.... ومن هنا لم يسمّ كـُتـَلهُ النثرية قصائد نثرية رغم أن النقادَ يعتبرون بعضَها قصائدَ نثرٍ بامتياز!إن الإصرار على تسمية عمل جوهرُه يتعارض ، شكلا ومضمونا، مع ما يتميز به هذا الاسم، لهو في نظري، تعبيرٌ عن اعتباطية العمل نفسه.
_______________________________________
قصيدة النثر ومنظومة الحس العربي
كتبه د. ميلاد متى
نقلاً عن الرابط
ما توقفت قصيدة النثر عن إرباك القراء و الناقدين معا ً، منذ ظهورها " رسميا ً " في القرن التاسع عشر في فرنسا مع شارل بودلير ، حين نشر Paris Spleen سنة 1869، كقصيدة نثر ، و التي قال فيها M.Riffaterre : " نوع أدبي يحمل إردافا ً خُلفيا ً كإسم " . و مع ذلك فإن بودلير نفسه شاء أن يقدّم التعريف الأول لهذا النوع " كأعجوبة النثر الشعري ، موسيقي ّ ، و مع ذلك دون وزن ، و من دون قافية . مِطواع ، إلا أنه صارم ٌ و عاصف ٌ إلى حد يتماثل فيه مع نبضات الروح العاطفية ، مع اليقظة الحالمة في مدّها و جزرها ، و مع وخزات الضمير " .و يبدو أن بودلير بعد هذا التعريف الرومانسي المبهم ، قد فتح الباب لنـزعة أدبية سيعزّها و يدللها شعراء في الشرق و الغرب ، كنوع مثالي به يملأون رغبتهم القوية في تعقيدات تركيبية و تأنقات أسلوبية ، حتى أن أية محاولة تعريف واحد كلي ٍّ لهذا النوع ستنتهي بالفشل . أما تعريفRiffaterre فيحمل إشكالية الشعر و النثر منذ أن ظهر الشعر و النثر . فيتضارب مفهوماهما المعجميان التقليديان في أسئلةٍ أقلّها : كيف يكون النثر شعرا ً ؟ و العكس : كيف يكون الشعر نثرا ً ؟ والأصح : كيف نستخرج من النثر شعرا ً ؟ .هذا إذا سلّمنا أننا نملك معايير النثر و الشعر و مفاهيمهما المحددة . وإذا سلّمنا أننا نمسك بناصية الأدب الذي لا يزال غامضا ً، حتى أن أحداً اليوم ، لم يعد يكلّف نفسه مشقة البحث عن تعريفات جديدة له .
يقول ميخائيل نعيمة : " اللغة في القاموس مومياء . أما على ألسنه الناس و شفاههم فكيان حي يزخر بأمواج الأفكار و الخيالات ، و يلتهب بكل أصناف الميول و الإحساسات " فلا عجب إذا ً ، إذا قرأنا عن النحو في قصيدة هي ألفية ابن مالك الشهيرة . و لا عجب إذا عرف القارئ أن طبيباً لبنانياً كتب أطروحته في الأمراض الجلدية شعرا ً، و باللغة التشيكية ، وزنا ً و قافية ً .
الشعر و النثر صنعتان كلاميتان تتقاطعان و تتمازجان ، تنـزلقان باستمرار الواحدة نحو الأخرى , كمن عقباهما على قشرة موز. و حتى لا نغالي في استحالة التعريف ، فإننا نستطيع القول أن قصيدة النثر تبدو للوهلة الأولى مركّباً يستطيع أن يحتوي بعض أو كل ميزات الغنائية . عدا أنه مكتوب ٌ نثرا ً – بالرغم من أنه لا يُعد ّ كذلك – على مساحة الصفحة . هذا المركّب يختلف عن النثر الشعري بقصره و تضامّه . و عن النثر الحر بانعدام الوقفات (=الانقطاعات ) في السطر الواحد ( باعتباره بديلا ً عن البيت أو الجملة ) ، و عن المقطع النثري القصير بما فيه من ايقاعات واضحة ، و تأثيرات صوتية و مجاز و تخيّلات و كثافة في التعبير . و قد يحمل أحيانا ً قوافي داخلية و تعاقب إيقاعات ٍ ( = أوزان ) سريعة . و يمتد طوله عامة ، من نصف صفحة ( مقطع أو مقطعين ) ، إلى صفحتين أو ثلاثة.
هذه الميزات تنطبق على القصيدة النثرية الغربية كما تنطبق على القصيدة النثرية العربية ، و التي سمّاها بعض الدارسين بـ " شعر الحداثة " ، أو " الشعر المعاصر " . و هما تسميتان طغيا إبّان و بعد الإخفاقات و الانكسارات و النكسات العربية الكبرى سياسيا ً و اجتماعيا ً في أواخر الخمسينات و الستينات . فولدت قصيدة النثر العربية من رحِمَي ِ السياسة و المجتمع المهترئين العقيمين آنذاك ، ثائرة ، رافضة ، فاضحة ، هاجمة ، مدمّرة ، محطمة الشكل اللغوي و المضمون التراثي . تغذّيها الثقافة الغربية ولا سيما الفرنسية كما عند أنسي الحاج و بول شاوول .
و برزت رؤيوية سريالية . و أحيانا ً كثيرة ً، هلوسية ، هذرية ، فوضوية عابثة ، لا تهدف إلى شيء ، سوى ربما ، إلى جمالية الغريب و المألوف و اللامنطق .
إلا أن قصيدة النثر العربية اليوم ، وبعد تجربة دامت أكثر من أربعين سنة ، تبدو أكثر نضجا ً و التصاقا ً بالحياة ، تبدو أكثر شفافية ً و هدوءاً . تغلب عليها المعاناة الغنائية من دون أن تتخلى عن نبرتها الثورية المبطنة بالألم ، حيث تتداخل فيها التأثيرات الحضارية و الثقافية .
لقد باتت ملاذا ً لطالبي المساحات الحرة ، حيث لا قوانين و لا معايير تعبيرية مُلتزمة و مُلزمة . هي ملاذ يوافق الحس العربي من حيث :
1- أيدولوجية الفوضى : فوضى في السياسة و المجتمع والاقتصاد . و حتى في الفنون ، و أهمها فوضى الغناء و انحطاطه ، فحدّث ولا حرج .
يقابلها فوضى القصيدة : التراكم و الغموض و الإغراب . و فوضى الشكل : كتابة أفقية ثم عامودية ، ثم انحدارية مائلة ، متقطّعة :
هل يذكر النهر ؟
كانوا يسمونه وردة الميتين
و يمشون خلف المياه
إلى
آخر
العمر
ها هو يمضي بطيئا ً
إنها – أي القصيدة – شِعر ٌ أشعث ، كالشعر الأشعث : مغبرّة ، متغيرة ، متلبدة و منتشرة .
2- الضغط : و منه الاقتصادي و الديني و الذكوري . يقابله كبت ٌ كلامي و انقطاع فجائي أحيانا ً، و ضغط في المعاني و عدم اكتمال الصورة .
3- الرفض : الداخلي غير المُعلن و مخالفة الواقع . فالقصيدة رفضية ، غاضبة ، مغلّفة بالانزياح نحو الممنوع و المُحرّم بلغة اللبس و الإبهام تارة ً ، و بالجرأة و الوقاحة و العُجمة و السوقية طورا ً Vulgarism حتى في قصائد النساء الشاعرات اللواتي سفرن عن وجوههن و لغتهن ّ في آن ٍ معا ً .
4- حال العُدم (= الفقدان ) و العَدَم ( ضد الوجود ) ، لحلّ معضلة الإنسان العربي . أنتجت قصيدة العبثية و اللامنطق و الهلوسة . متخذة ً من الدفق الخيالي و الرؤيوي ركيزة الإبداع .
كل هذا و أكثر ساهم و رفد قصيدة النثر . و عندنا ، أن البحث عن مبررات و عوامل خارجية لتعريف هذا النوع الأدبي ، لا يكفي و لا يمكن تعميمه . فإن بعض كتّاب قصيدة النثر ، ممن خلقوا لأنفسهم عالما ً خارج عالم السياسة و الاقتصاد و الدين ، قدّموا إبداعات ٍ يمكن تصنيفها في باب الفن للفن ، و شعارهم النـزعة الجمالية .
و على هذا ، فإن أفضل مقاربة علمية عملية لقصيدة النثر ، هي تلك المبنية على تعاليم الألسنية ، بحيث يتفكك هذا المركّب إلى عناصره اللغوية الأساسية : من الأصوات ( = الإيقاعات ) ، إلى الحقول المعجمية ، إلى الوظائف الكلامية ، إلى الأنماط النصية ...
و في رأينا أن هذا النوع Genre تمكن دراسته من خلال المقارنة بين الأنواع الكلامية الأخرى : النثر و الشعر و النثر الشعري و الشعر الحر . لأن قصيدة النثر توصّلت إلى التعبير عن روح الشعر متخطية ً القواعد الشكلية المتعارف عليها للنظم التقليدي .
و يُنظر ُ من حيث التخصص - في : كتابة المقطع و الكلام المنقطع ( = غير المُنهى ) ، و استقلالية النص الذاتية . كما يُبحث ُ في التماسك ووحدة المقطع ، و الكثافة و الفعل الشعري القوي . و الهندسة المشغولة : البناء – التطوّر – التوازي – الأصداء و تأثير الانغلاق . و تنوّع الأنماط الكلامية و أشكال الكتابة : السردي ، الوصفي ، الحواري و التأملي ... و أيضا ً في تنوّع التصنيف: الغنائي و الملحمي و الخارق . ولا ننسى الكتابة الشعرية ( = الأسلوب ) : الصور و الإيماء و الإيجاز و الغموض ، و اللمح و المجاز و عدم الملاءمة الدلالية ، و القيمة الرمزية و التشكيلية ...
و بعد ُ، فإننا نستذكر قول ستيفان مالارمي Stephane Mallarme وقد أحسن الإصابة : " الشعر في كل مكان من اللغة ، في كل مكان حيث الإيقاع ، ففي ما نسميه النثر ، شعر من كل إيقاع ٍ يمكن تصوّره ، و بعضه رائع ٌ . و في الواقع ليس هناك من نثر : هناك الألف باء ، ثم الأشكال الشعرية ، أقل أو أكثر صرامة ً ، و أقل أو أكثر إطنابا ً . ففي كل محاولة تعبيرية ( = أسلوب ) أصول شعرية ".
قصيدة النثر هي هذا الشعر في لغة ما . هي حاضرة حضور الأنواع الأخرى التي سبقت و لا تزال . و ستكون أنواعٌ أخر لشعرٍ آخر في لغةٍ أخرى . ما دام هناك مادةٌ هي اللغة ، و ما دام هناك صانع ٌ / شاعرٌ / فنانٌ / ثائرٌ .
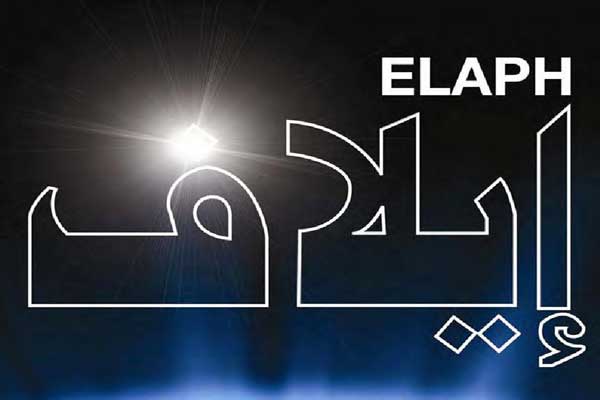



تعليق