حوار مع الشاعر الناقد:
الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن أحمد الفَيفي
1- التقليد الأدبي:
س) تنبثق جهود نقادنا وأدبائنا من تقليد للغربيين في اجتهادهم ;رؤاهم، حتى أننا نلمس من لا يعتمد الاستشهاد بأحد الأدباء الغربيين كأنه ليس أديبا أو لم يذق طعم الأداب الراقي. فما رأيكم في هذا الصنف من المثقفين؟ ومتى تستحثنا دواعي الأصالة لنفكر وفق مقتضيات تعليمات شريعتنا؟
ج1) تبدو ثقافة التقليد راسخة الجذور في الثقافة العربيّة منذ القِدَم، واستفحلت أكثر مذ أُقفل باب الاجتهاد الفقهيّ وغير الفقهيّ، أي منذ القرن الرابع الهجريّ تقريبًا؛ حيث أصبحت غاية النبوغ أن يقلّد التلميذ شيخه ويستنّ سننه، إلى درجة محاكاته في التأليف والأسلوب والسلوك. وهكذا توارثت الأجيال هذه الثقافة، تغرس عقليّتها في الطفل منذ نعومة أظفاره، فيشبّ وهو لا يرى طموحًا أعلى من أن يكون حافظًا، وأن يظهر نسخة طبق الأصل عن أبيه، أو عن شيخه، ملغيًا داخله أيّ نزوع إلى التفرّد أو الاستقلال؛ لأن الثقافة نفسها قد حرّمت التفرّد أو الاستقلال، وعدّته شذوذًا، وانحرافًا، وتردّيًا في مهاوي الضلال والنار. ولذلك كثيرًا ما تجد العربيّ متخاجِئًا عن كلّ جديد، يكاد لا يخرج عن نموذج شيخه- مَثَلِه الأعلى- إلى الواقع، ومنه واقعه الذاتيّ، إلاّ إلى الأحلام والأوهام والخيالات. متأرجحًا أبدًا بين نموذجين: نموذجٍ موروث، ونموجٍ موهوم. أمّا الفئة النقيضة من التقليديّين، فتذهب إلى نكران الماضي والانتماء إليه بكلّ ما في الانتماء من معنى. تفعل هذا في نوعٍ من الولاء للآخر والبراء من الذات. حتى لتبلغ ببعضهم حالُهُ تلك من الانبهار المَرَضي، المفضي إلى التبعيّة، إلى الشعور بالدونيّة إزاء الغرب، لا ثقافيًّا فحسب، بل عِرقيًّا أيضًا. وعليه، فإن الفوارق بين الشعب العربيّ والشعوب الغربيّة- بحسب ذلك العقل المعتوه حضاريًّا المهووس بكلّ غربيّ- فوارق جينيّة موروثة، لا بيئيّة مكتسبة! ومثل هذا كسابقه أعمى البصيرة والبصر، مكانه إحدى المصحّات النفسيّة الحضاريّة، لو وُجدتْ مثل تلك المصحّات. ولن تُشفى تلك العقليّة المقلِّدة حتى تعترف بمرضها أوّلاً، ثم تتخذ العقل نبراسًا فيما تقبل أو ترفض.
2- أسلمة الأدب:
س)تدعو رابطة الأدب الإسلامي إلى أسلمة الأدب، واعتماد فكر مميز عن الكتابة الجاهلية. ما رأيكم في توجهها؟
ج2) أدبيّة الأدب كامنة في بنائه اللغوي والفنّي، لا في عقيدة صاحبه أو هويّته. ولو كان الحُكم على أدبيّة الأدب بالدِّين والأخلاق، لأسقطنا معظم التراث الأدبي والأدب المعاصر، فضلاً عن آداب الأمم الأخرى. لكن هناك هوسًا بأسلمة أشياء كثيرة اليوم، ومنها الأدب، وفق رؤى ضيّقة للإسلام نفسه، ومعايير من التصنيف ما أنزل الله بها من سلطان، ولا جاءت عن رسول الإسلام، ولا كانت في العصور الإسلاميّة الأولى. وهذا تيّار ظهر في سياق المحاكاة والتقليد كذلك، فما أن سمع بعض الناس عن (الأدب الشيوعي)، و(الالتزام الاشتراكي)، و(الالتزام الوجودي)، حتى تنادوا إلى ما أسموه بـ(الأدب الإسلامي). وكما ذكرتُ في مقام سابق فإن في مصطلح "الأدب الإسلامي" وأشباهه احتكارًا لصفة "إسلاميّ" لتيارٍ أو حزبٍ أو جماعةٍ أو جامعة. مع أن الإسلام جاء إلى الناس كافّة، والاتصاف به للمسلمين جميعًا، لا لفئةٍ أو تيّار أو توجّه. فإذن المصطلح من أساس وضعه مغالطةٌ كُبرى، تحاكي تسميات بعض التيارات الأدبيّة أو الإيديولوجيّة الغربيّة أو الشرقيّة، في غفلةٍ عن أن الإسلام ليس تيّارًا ولا إيديولوجيا حزبيّة، إضافة إلى أنه لا يحقّ اختطافُ دين أُمّة لإلصاق اسمه على بعضها دون بعض. ولذلك جاء هذا المصطلح بدعة، لا سابقة لها في التاريخ الإسلامي. وكان يمكن أن يُسمى هذا الاتجاه بـ"أدب الدعوة الإسلامية"، مثلاً، لكنه هوس التصنيف، الذي ينطوي على الاستئثار، ولا يبرأ من اتهام الآخرين. وهذا الحرص على التصنيف- بما يحمله من إقصائيّة- قد أوقع هذا التوجّه نفسه في مأزق التصنيف، لا مع المعاصر فحسب، ولكن مع التراث أيضًا؛ إذ هل نَعُدّ شاعرًا كالمتنبي إسلاميًّا، ناهيك عن أبي تمّام أو أبي نواس؟ بل هل سُمّي شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، (حسان بن ثابت)، شاعرًا إسلاميًّا، أو حتى شاعر الإسلام، فيما حُرم من ذلك اللقب شاعر كالحطيئة أو ابن مقبل أو النجاشي الحارثي؟ كلاّ، لم يحدث ذلك قط، بل كان الجميع يستظلّون بالإسلام ويتّصفون به، عقيدة وهويّة، بعيدًا عن الزجّ بلقبه في شؤون الأدب أو غير الأدب من نتاج الناس وشؤون الحياة. ومن هنا فإن (موجة التصنيفات والألقاب) الحديثة، التي انطلقتْ عن خلفيّات فِكريّة أو سياسيّة، والتي جاءت ردّة فعلٍ لبعض التصنيفات الأخرى غربيّة أو شرقيّة، لم تُفلح جميعها في أدبيّتها؛ لأنها في الأصل تصنيفاتٌ حركيّة انتهت بانتهاء تيّاراتها. وأكبر مثال على هذا ما سُمّي (الأدب الاشتراكي)، الذي وُلد ميتًا، ليندثر دوره باندثار إيديولوجيّته أو تلاشيها. وكذا الأمر في (الأدب الوجودي)، حتى لقد أدرك بعض منظّري هذا التيّار الأخير ضرورة الحريّة الفرديّة في الأدب، فأخذوا يتحدّثون عن أن خدمة الأدب لقضيّة ما يجب أن لا تكون إلزامًا بل التزامًا، نابعًا من الذات المبدعة، فكان (جان بول سارتر)- منظّر هذه المدرسة الوجوديّة الأوّل- لا يرى وجوب الالتزام على الشاعر، بل على الناثر، حسب كتابه "ما الأدب". وقد تجلّى لديه ذلك الالتزام النثري في مسرحيته "الشيطان والرحمن"، على سبيل المثال.
الشعر بين الخير والشر:
3- س) يدعي بعض الأدباء بأن الشعر والخير لا يلتقيان، ويستدل آخرون بالقولة :" إن الدين بمعزل عن الشعر"، ما رأيكم في أهل هذا التوجه؟
ج3) هذا ليس توجّهًا، بل مقولة قديمة (للأصمعي)، كما أوردها عنه (المرزباني)، في كتابه "الموشح"، حين قال: "طريق الشِّعر إذا أدخلته في باب الخير لان. ألا ترى شِعر حسّان بن ثابت كان عَلا في الجاهليّة والإسلام، فلمّا دخل شِعره في باب الخير- من مراثي النبي صلى الله عليه وسلّم، وحمزة، وجعفر، رضوان الله عليهما، وغيرهم- لان شِعرُه، وطريق الشِّعر هو طريق الفحول، مثل امرئ القيس، وزهير، والنابغة، من صفات الدِّيار، والرَّحْل، والهجاء، والمديح، والتشبيب بالنساء، وصفة الخمر، والخيل، والحروب، والافتخار؛ فإذا أدخلته في باب الخير لان." فقام الجدل قديمًا وحديثًا حول كلمة الأصمعي تلك، ودافع أصحاب الاتجاه المثاليّ الأخلاقيّ في الأدب ضدّها، ظنًّا أن مفهومها ينفي صلاح الأدب بصلاح الأخلاق. والحقّ أن الواقع يُثبت صدق منظور الأصمعي ذاك، شئنا أم أبينا. غير أن هذا يقتضي الإيضاح والتفسير: لِمَ يقوَى الأدب في الشرّ ويضعف في الخير؟ ألا تتأتّى قُوّة الأدب بالشرّ من كونه يستجيب لحاجات إنسانيّة ونوازع عالميّة، أو قل تستجيب له تلك الحاجات والنوازع، التي لا تخُصّ جنسًا ولا دِينًا ولا فئة؟ ومن هناك فإن شِعر الحرب، مثلاً، أو الجنس، يجد صداه لدى كل إنسان، لا لما فيه من إبداعٍ بالضرورة، بل لما يحمل من مضامين نفسيّة، تطهيرًا، أو إرواءً، قبولاً، أو رفضًا، استحسانًا، أو استقباحًا. إن نظرة الأصمعي للقضيّة نظرة واقعيّة صادقة. لا تدعو إلى الاحتفاء بالشرّ، كما يخُيّل إلى دعاة الأدب الأخلاقيّ، فيقفون موقفهم منها، بل تقرّر حقيقة إنسانيّة وواقعًا بشريًّا. وقد حلّلتُ تفاصيل ذلك وناقشت القضيّة المطروحة في السؤال في دراسة لي تحت عنوان "مسافة الشِّعريّة بين التيّار النفسيّ والتيّار الفكريّ". ولمّا فَطِنَ العرب والمسلمون إلى خصوصيّة الأدب تلك، قالوا بأنه: "يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره". كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قَبِلَ شِعرًا- (لا يقبله المتنطّعون اليوم)- في مسجده الشريف، شِعرًا يُستهلّ بالغزل الحِسِّي، متضمنًا وصف جسد المرأة، ولذة الخمر، ممّا لو قاله الشاعر في غير شِعرٍ لأقيم عليه الحدّ.. بل لقد أهدى الرسول كعب بن زهير بردته على قصيدته اللاميّة، ومن شاء فليراجع تلك القصيدة، ليعرف رحابة الموقف من الشِّعر في الإسلام. وليراجع شِعر حسّان بن ثابت أيضًا، أو النابغة الجعدي، أو غيرهما ممّن يُعَدُّون من صحابة رسول الله، وسيجد أنه شِعر في كثير منه غير ملتزم بمعايير رابطة الأدب الإسلاميّ، مثلاً! وكذا ظلّ نقادنا القدامى يردّدون: إن "الأدب بمعزلٍ عن الدِّين"، ومن هؤلاء (أبو الحسن الجرجاني)، الذي قال في كتابه المشهور "الوساطة بين المتنبي وخصومه": "لو كانت الدِّيانة عارًا على الشِّعر، وكان سوء الاعتقاد سببًا لتأخّر الشاعر، لوجب أن يُمحى اسمُ أبي نواس من الدواوين، ويحذف ذِكْرُه إذا عُدّت الطبقات، ولَكان أَولاهم بذلك أهل الجاهليّة، ومن تشهد الأُمّة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزِّبَعرى وأضرابُهما، ممّن تناول رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعاب من أصحابه، بُكْماً خرسًا، وبِكاء مفحمين؛ ولكنّ الأمرين متباينان، والدِّين بمعزلٍ عن الشِّعر."
لكن ليس صحيحًا أن الشِّعر والخير لا يلتقيان بشكل مطلق، وإنما الإشكال يتمثّل أوّلاً في مفهومنا لطبيعة الشِّعر ومفهومنا للخير. فعلى حين تظلّ للأدب طبيعة ليست لغيره من النصوص، وللشِّعر ذلك الحقل الواسع من حريّة التعبير، فإن الشاعر البارع بإمكانه أن يجعل الخير ميدان تعبير، شريطة أن يوفِّق بين الجماليّة والمسؤوليّة، وأن يخاطب النفس والمخيّلة أوّلاً، لا العقل المجرّد والعقيدة.
[color="red"]قصيدة النثر:[/color]
4-س)تثير ما تسمى " قصيدة النثر" كثيرا من ردود الأفعال، والناس فيها يختصمون بين رافض ومؤيد؟ ما قولك؟
ج4) قصيدة النثر فيها ما يمكن أن يُعدّ نتاجًا خِصبًا وجميلاً، غير أن الخصومة حولها تتمثل موضوعيًّا- أو هكذا ينبغي- في أمرين رئيسين: المصطلح، ودعاوى الجدّة (أو بالأحرى أنها تجديدٌ في جنس الشِّعر). ولقد ناقشت هذا في دراسات مختلفة، منها كتابي "حداثة النَّصّّ الشّعريّ في المملكة العربيّة السعوديّة (قراءة نقديّة في تحوّلات المشهد الإبداعيّ)"، 2005. وأضيف هنا: إن شِعر التفعيلة- قبل قصيدة النثر- جاء تغييرًا جذريًّا في الذوق العربيّ، وفي الشخصيّة الشِّعريّة العربيّة، التي ترى الوزن ركنًا ركينًا في البناء الشِّعريّ. جاء ذلك التغيير كي تتماثل الشخصيّة الشعريّة العربيّة- وإن قَسْرًا- مع الشخصيّة الشِّعريّة الغربيّة. تلك الشخصيّة الأخيرة التي نجد ملامحها منذ القِدَم، ومن ثمّ فليس ما سمي (الشِّعر الحُرّ) تحوّلاً حديثًا أو تطوّرًا في السياق الغربيّ، بل هو مكوّن قديم، أراد بعض شداة القصيدة العربيّة في القرن العشرين أن يتجرّعه العرب وهم لا يكادون يسيغونه. وشيئًا فشيئًا انزلقت التبعيّة التقليديّة لكل وارد من هناك إلى التنصّل من الإيقاع برمّته، بترك التفعيلة إلى ما يسمّى قصيدة النثر. وتلك الشخصيّة الشِّعريّة الغربيّة- التي نجد ملامحها منذ القِدَم- يُلمِح إليها، مثلاً، أرسطو، حسبما يشير إلى ذلك صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (696- 764هـ= 1296- 1363م)، في كتابه "الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم"، حيث يقول: "قال أرسطو- خطيب اليونان وشاعرهم- وليس الشِّعر عندهم ما يكون ذا وزن وقافية، ولا ذاك رُكن فيه، بل الرُّكن في ذلك إيراد المقدّمات المخيّلة فحسب، فإن كانت المقدّمة التي ترد في القياس الشِّعري مخيّلة فقط، تمحّض القياس شِعْرِيًّا، وإن انضمَّ إلى المقدّمة قول إقناعيّ، تركّبت المقدّمة من معنيَين: شعريّ وإقناعيّ... ولليونان عَروضٌ لبحور الشعر والتفاعيل عندهم تُسمّى الأيدي والأرجل." ومحدّد الجنس الشِّعري وفق هذا المنظور هو التخييل فقط، بقطع النظر عن الموسيقى الشِّعرية، وما كذلك هو الجنس الشِّعري وفق المزاج العربيّ منذ عرف العربُ الشِّعر، وإلاّ فإن كثيرًا من النثر العربي منذ العصر الجاهلي يُعدّ شِعرًا بحسب التوصيف السابق، ومنه سجع الكُهّان؛ لأن مقدّماته مخيّلة، بل فوق ذلك هو لا يخلو من التنغيم والإيقاع؛ كما أن نصوصًا إسلاميّة كالمواقف والمخاطبات لدى النِّفري- على سبيل المثال- محض شِعر إذن، وهو ما لم يزعمه النِّفري نفسه! بيد أن هناك من يزعمه اليوم، ويصرّ على فرضه، بل يصفه تطوّرًا جديدًا للشِّعر العربي، وربما قال: إنه يَجُبُّ ما قبله من شِعر! مع أنه موجود في تراث النثر العربي منذ القرن الثالث الهجري، التاسع الميلادي، وقبل ذلك، كما أشرنا!
والخلاصة: أن للشِّعر العربي هويّةً تختلف عن هويّة الشِّعر الغربيّ، اختُطفتْ وغُرّبتْ عن منابتها. وعليه، فإن من يريد فرض قصيدة النثر، بوصفها شِعرًا، إنما يقتبس فهمًا غربيًّا لماهيّة الشِّعر، غريبًا عن الفهم العربيّ لماهيّة الشِّعر. وتلك الماهيّة الشِّعريّة المقتبسة مستوعَبةٌ سلفًا في (النثر الفنّي العربي) منذ القِدَم، لكنها لا تكفي- بحسب الذوق العربيّ والتجربة العربيّة- لتكوين نصّ يندرج فيما يَعُدُّه العربُ من الجنس الشعريّ. ومَثَل أولئك كمن يريد أن يُرغم العربيّ على تصديق أن بغلاً هو حصانٌ عربيّ أصيل، لا لشيء إلاّ لأن فيه بعض الشَّبَه بالخيل.. أو أن نبتة لبلابٍ متسلّقة هي نخلةٌ من أرض هَجَر أو العراق! وعندئذٍ ستكون بضاعة أولئك أسوأ في العيون العربيّة ممّن قيل فيه: إنه كجالب التمر إلى هَجَر؛ لأن جلوبة جالب قصيدة النثر مردودةٌ جملةً، لا لعدم جودتها؛ بل لأنها مختلفة نوعيًّا.
ا
الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن أحمد الفَيفي
1- التقليد الأدبي:
س) تنبثق جهود نقادنا وأدبائنا من تقليد للغربيين في اجتهادهم ;رؤاهم، حتى أننا نلمس من لا يعتمد الاستشهاد بأحد الأدباء الغربيين كأنه ليس أديبا أو لم يذق طعم الأداب الراقي. فما رأيكم في هذا الصنف من المثقفين؟ ومتى تستحثنا دواعي الأصالة لنفكر وفق مقتضيات تعليمات شريعتنا؟
ج1) تبدو ثقافة التقليد راسخة الجذور في الثقافة العربيّة منذ القِدَم، واستفحلت أكثر مذ أُقفل باب الاجتهاد الفقهيّ وغير الفقهيّ، أي منذ القرن الرابع الهجريّ تقريبًا؛ حيث أصبحت غاية النبوغ أن يقلّد التلميذ شيخه ويستنّ سننه، إلى درجة محاكاته في التأليف والأسلوب والسلوك. وهكذا توارثت الأجيال هذه الثقافة، تغرس عقليّتها في الطفل منذ نعومة أظفاره، فيشبّ وهو لا يرى طموحًا أعلى من أن يكون حافظًا، وأن يظهر نسخة طبق الأصل عن أبيه، أو عن شيخه، ملغيًا داخله أيّ نزوع إلى التفرّد أو الاستقلال؛ لأن الثقافة نفسها قد حرّمت التفرّد أو الاستقلال، وعدّته شذوذًا، وانحرافًا، وتردّيًا في مهاوي الضلال والنار. ولذلك كثيرًا ما تجد العربيّ متخاجِئًا عن كلّ جديد، يكاد لا يخرج عن نموذج شيخه- مَثَلِه الأعلى- إلى الواقع، ومنه واقعه الذاتيّ، إلاّ إلى الأحلام والأوهام والخيالات. متأرجحًا أبدًا بين نموذجين: نموذجٍ موروث، ونموجٍ موهوم. أمّا الفئة النقيضة من التقليديّين، فتذهب إلى نكران الماضي والانتماء إليه بكلّ ما في الانتماء من معنى. تفعل هذا في نوعٍ من الولاء للآخر والبراء من الذات. حتى لتبلغ ببعضهم حالُهُ تلك من الانبهار المَرَضي، المفضي إلى التبعيّة، إلى الشعور بالدونيّة إزاء الغرب، لا ثقافيًّا فحسب، بل عِرقيًّا أيضًا. وعليه، فإن الفوارق بين الشعب العربيّ والشعوب الغربيّة- بحسب ذلك العقل المعتوه حضاريًّا المهووس بكلّ غربيّ- فوارق جينيّة موروثة، لا بيئيّة مكتسبة! ومثل هذا كسابقه أعمى البصيرة والبصر، مكانه إحدى المصحّات النفسيّة الحضاريّة، لو وُجدتْ مثل تلك المصحّات. ولن تُشفى تلك العقليّة المقلِّدة حتى تعترف بمرضها أوّلاً، ثم تتخذ العقل نبراسًا فيما تقبل أو ترفض.
2- أسلمة الأدب:
س)تدعو رابطة الأدب الإسلامي إلى أسلمة الأدب، واعتماد فكر مميز عن الكتابة الجاهلية. ما رأيكم في توجهها؟
ج2) أدبيّة الأدب كامنة في بنائه اللغوي والفنّي، لا في عقيدة صاحبه أو هويّته. ولو كان الحُكم على أدبيّة الأدب بالدِّين والأخلاق، لأسقطنا معظم التراث الأدبي والأدب المعاصر، فضلاً عن آداب الأمم الأخرى. لكن هناك هوسًا بأسلمة أشياء كثيرة اليوم، ومنها الأدب، وفق رؤى ضيّقة للإسلام نفسه، ومعايير من التصنيف ما أنزل الله بها من سلطان، ولا جاءت عن رسول الإسلام، ولا كانت في العصور الإسلاميّة الأولى. وهذا تيّار ظهر في سياق المحاكاة والتقليد كذلك، فما أن سمع بعض الناس عن (الأدب الشيوعي)، و(الالتزام الاشتراكي)، و(الالتزام الوجودي)، حتى تنادوا إلى ما أسموه بـ(الأدب الإسلامي). وكما ذكرتُ في مقام سابق فإن في مصطلح "الأدب الإسلامي" وأشباهه احتكارًا لصفة "إسلاميّ" لتيارٍ أو حزبٍ أو جماعةٍ أو جامعة. مع أن الإسلام جاء إلى الناس كافّة، والاتصاف به للمسلمين جميعًا، لا لفئةٍ أو تيّار أو توجّه. فإذن المصطلح من أساس وضعه مغالطةٌ كُبرى، تحاكي تسميات بعض التيارات الأدبيّة أو الإيديولوجيّة الغربيّة أو الشرقيّة، في غفلةٍ عن أن الإسلام ليس تيّارًا ولا إيديولوجيا حزبيّة، إضافة إلى أنه لا يحقّ اختطافُ دين أُمّة لإلصاق اسمه على بعضها دون بعض. ولذلك جاء هذا المصطلح بدعة، لا سابقة لها في التاريخ الإسلامي. وكان يمكن أن يُسمى هذا الاتجاه بـ"أدب الدعوة الإسلامية"، مثلاً، لكنه هوس التصنيف، الذي ينطوي على الاستئثار، ولا يبرأ من اتهام الآخرين. وهذا الحرص على التصنيف- بما يحمله من إقصائيّة- قد أوقع هذا التوجّه نفسه في مأزق التصنيف، لا مع المعاصر فحسب، ولكن مع التراث أيضًا؛ إذ هل نَعُدّ شاعرًا كالمتنبي إسلاميًّا، ناهيك عن أبي تمّام أو أبي نواس؟ بل هل سُمّي شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، (حسان بن ثابت)، شاعرًا إسلاميًّا، أو حتى شاعر الإسلام، فيما حُرم من ذلك اللقب شاعر كالحطيئة أو ابن مقبل أو النجاشي الحارثي؟ كلاّ، لم يحدث ذلك قط، بل كان الجميع يستظلّون بالإسلام ويتّصفون به، عقيدة وهويّة، بعيدًا عن الزجّ بلقبه في شؤون الأدب أو غير الأدب من نتاج الناس وشؤون الحياة. ومن هنا فإن (موجة التصنيفات والألقاب) الحديثة، التي انطلقتْ عن خلفيّات فِكريّة أو سياسيّة، والتي جاءت ردّة فعلٍ لبعض التصنيفات الأخرى غربيّة أو شرقيّة، لم تُفلح جميعها في أدبيّتها؛ لأنها في الأصل تصنيفاتٌ حركيّة انتهت بانتهاء تيّاراتها. وأكبر مثال على هذا ما سُمّي (الأدب الاشتراكي)، الذي وُلد ميتًا، ليندثر دوره باندثار إيديولوجيّته أو تلاشيها. وكذا الأمر في (الأدب الوجودي)، حتى لقد أدرك بعض منظّري هذا التيّار الأخير ضرورة الحريّة الفرديّة في الأدب، فأخذوا يتحدّثون عن أن خدمة الأدب لقضيّة ما يجب أن لا تكون إلزامًا بل التزامًا، نابعًا من الذات المبدعة، فكان (جان بول سارتر)- منظّر هذه المدرسة الوجوديّة الأوّل- لا يرى وجوب الالتزام على الشاعر، بل على الناثر، حسب كتابه "ما الأدب". وقد تجلّى لديه ذلك الالتزام النثري في مسرحيته "الشيطان والرحمن"، على سبيل المثال.
الشعر بين الخير والشر:
3- س) يدعي بعض الأدباء بأن الشعر والخير لا يلتقيان، ويستدل آخرون بالقولة :" إن الدين بمعزل عن الشعر"، ما رأيكم في أهل هذا التوجه؟
ج3) هذا ليس توجّهًا، بل مقولة قديمة (للأصمعي)، كما أوردها عنه (المرزباني)، في كتابه "الموشح"، حين قال: "طريق الشِّعر إذا أدخلته في باب الخير لان. ألا ترى شِعر حسّان بن ثابت كان عَلا في الجاهليّة والإسلام، فلمّا دخل شِعره في باب الخير- من مراثي النبي صلى الله عليه وسلّم، وحمزة، وجعفر، رضوان الله عليهما، وغيرهم- لان شِعرُه، وطريق الشِّعر هو طريق الفحول، مثل امرئ القيس، وزهير، والنابغة، من صفات الدِّيار، والرَّحْل، والهجاء، والمديح، والتشبيب بالنساء، وصفة الخمر، والخيل، والحروب، والافتخار؛ فإذا أدخلته في باب الخير لان." فقام الجدل قديمًا وحديثًا حول كلمة الأصمعي تلك، ودافع أصحاب الاتجاه المثاليّ الأخلاقيّ في الأدب ضدّها، ظنًّا أن مفهومها ينفي صلاح الأدب بصلاح الأخلاق. والحقّ أن الواقع يُثبت صدق منظور الأصمعي ذاك، شئنا أم أبينا. غير أن هذا يقتضي الإيضاح والتفسير: لِمَ يقوَى الأدب في الشرّ ويضعف في الخير؟ ألا تتأتّى قُوّة الأدب بالشرّ من كونه يستجيب لحاجات إنسانيّة ونوازع عالميّة، أو قل تستجيب له تلك الحاجات والنوازع، التي لا تخُصّ جنسًا ولا دِينًا ولا فئة؟ ومن هناك فإن شِعر الحرب، مثلاً، أو الجنس، يجد صداه لدى كل إنسان، لا لما فيه من إبداعٍ بالضرورة، بل لما يحمل من مضامين نفسيّة، تطهيرًا، أو إرواءً، قبولاً، أو رفضًا، استحسانًا، أو استقباحًا. إن نظرة الأصمعي للقضيّة نظرة واقعيّة صادقة. لا تدعو إلى الاحتفاء بالشرّ، كما يخُيّل إلى دعاة الأدب الأخلاقيّ، فيقفون موقفهم منها، بل تقرّر حقيقة إنسانيّة وواقعًا بشريًّا. وقد حلّلتُ تفاصيل ذلك وناقشت القضيّة المطروحة في السؤال في دراسة لي تحت عنوان "مسافة الشِّعريّة بين التيّار النفسيّ والتيّار الفكريّ". ولمّا فَطِنَ العرب والمسلمون إلى خصوصيّة الأدب تلك، قالوا بأنه: "يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره". كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قَبِلَ شِعرًا- (لا يقبله المتنطّعون اليوم)- في مسجده الشريف، شِعرًا يُستهلّ بالغزل الحِسِّي، متضمنًا وصف جسد المرأة، ولذة الخمر، ممّا لو قاله الشاعر في غير شِعرٍ لأقيم عليه الحدّ.. بل لقد أهدى الرسول كعب بن زهير بردته على قصيدته اللاميّة، ومن شاء فليراجع تلك القصيدة، ليعرف رحابة الموقف من الشِّعر في الإسلام. وليراجع شِعر حسّان بن ثابت أيضًا، أو النابغة الجعدي، أو غيرهما ممّن يُعَدُّون من صحابة رسول الله، وسيجد أنه شِعر في كثير منه غير ملتزم بمعايير رابطة الأدب الإسلاميّ، مثلاً! وكذا ظلّ نقادنا القدامى يردّدون: إن "الأدب بمعزلٍ عن الدِّين"، ومن هؤلاء (أبو الحسن الجرجاني)، الذي قال في كتابه المشهور "الوساطة بين المتنبي وخصومه": "لو كانت الدِّيانة عارًا على الشِّعر، وكان سوء الاعتقاد سببًا لتأخّر الشاعر، لوجب أن يُمحى اسمُ أبي نواس من الدواوين، ويحذف ذِكْرُه إذا عُدّت الطبقات، ولَكان أَولاهم بذلك أهل الجاهليّة، ومن تشهد الأُمّة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزِّبَعرى وأضرابُهما، ممّن تناول رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعاب من أصحابه، بُكْماً خرسًا، وبِكاء مفحمين؛ ولكنّ الأمرين متباينان، والدِّين بمعزلٍ عن الشِّعر."
لكن ليس صحيحًا أن الشِّعر والخير لا يلتقيان بشكل مطلق، وإنما الإشكال يتمثّل أوّلاً في مفهومنا لطبيعة الشِّعر ومفهومنا للخير. فعلى حين تظلّ للأدب طبيعة ليست لغيره من النصوص، وللشِّعر ذلك الحقل الواسع من حريّة التعبير، فإن الشاعر البارع بإمكانه أن يجعل الخير ميدان تعبير، شريطة أن يوفِّق بين الجماليّة والمسؤوليّة، وأن يخاطب النفس والمخيّلة أوّلاً، لا العقل المجرّد والعقيدة.
[color="red"]قصيدة النثر:[/color]
4-س)تثير ما تسمى " قصيدة النثر" كثيرا من ردود الأفعال، والناس فيها يختصمون بين رافض ومؤيد؟ ما قولك؟
ج4) قصيدة النثر فيها ما يمكن أن يُعدّ نتاجًا خِصبًا وجميلاً، غير أن الخصومة حولها تتمثل موضوعيًّا- أو هكذا ينبغي- في أمرين رئيسين: المصطلح، ودعاوى الجدّة (أو بالأحرى أنها تجديدٌ في جنس الشِّعر). ولقد ناقشت هذا في دراسات مختلفة، منها كتابي "حداثة النَّصّّ الشّعريّ في المملكة العربيّة السعوديّة (قراءة نقديّة في تحوّلات المشهد الإبداعيّ)"، 2005. وأضيف هنا: إن شِعر التفعيلة- قبل قصيدة النثر- جاء تغييرًا جذريًّا في الذوق العربيّ، وفي الشخصيّة الشِّعريّة العربيّة، التي ترى الوزن ركنًا ركينًا في البناء الشِّعريّ. جاء ذلك التغيير كي تتماثل الشخصيّة الشعريّة العربيّة- وإن قَسْرًا- مع الشخصيّة الشِّعريّة الغربيّة. تلك الشخصيّة الأخيرة التي نجد ملامحها منذ القِدَم، ومن ثمّ فليس ما سمي (الشِّعر الحُرّ) تحوّلاً حديثًا أو تطوّرًا في السياق الغربيّ، بل هو مكوّن قديم، أراد بعض شداة القصيدة العربيّة في القرن العشرين أن يتجرّعه العرب وهم لا يكادون يسيغونه. وشيئًا فشيئًا انزلقت التبعيّة التقليديّة لكل وارد من هناك إلى التنصّل من الإيقاع برمّته، بترك التفعيلة إلى ما يسمّى قصيدة النثر. وتلك الشخصيّة الشِّعريّة الغربيّة- التي نجد ملامحها منذ القِدَم- يُلمِح إليها، مثلاً، أرسطو، حسبما يشير إلى ذلك صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (696- 764هـ= 1296- 1363م)، في كتابه "الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم"، حيث يقول: "قال أرسطو- خطيب اليونان وشاعرهم- وليس الشِّعر عندهم ما يكون ذا وزن وقافية، ولا ذاك رُكن فيه، بل الرُّكن في ذلك إيراد المقدّمات المخيّلة فحسب، فإن كانت المقدّمة التي ترد في القياس الشِّعري مخيّلة فقط، تمحّض القياس شِعْرِيًّا، وإن انضمَّ إلى المقدّمة قول إقناعيّ، تركّبت المقدّمة من معنيَين: شعريّ وإقناعيّ... ولليونان عَروضٌ لبحور الشعر والتفاعيل عندهم تُسمّى الأيدي والأرجل." ومحدّد الجنس الشِّعري وفق هذا المنظور هو التخييل فقط، بقطع النظر عن الموسيقى الشِّعرية، وما كذلك هو الجنس الشِّعري وفق المزاج العربيّ منذ عرف العربُ الشِّعر، وإلاّ فإن كثيرًا من النثر العربي منذ العصر الجاهلي يُعدّ شِعرًا بحسب التوصيف السابق، ومنه سجع الكُهّان؛ لأن مقدّماته مخيّلة، بل فوق ذلك هو لا يخلو من التنغيم والإيقاع؛ كما أن نصوصًا إسلاميّة كالمواقف والمخاطبات لدى النِّفري- على سبيل المثال- محض شِعر إذن، وهو ما لم يزعمه النِّفري نفسه! بيد أن هناك من يزعمه اليوم، ويصرّ على فرضه، بل يصفه تطوّرًا جديدًا للشِّعر العربي، وربما قال: إنه يَجُبُّ ما قبله من شِعر! مع أنه موجود في تراث النثر العربي منذ القرن الثالث الهجري، التاسع الميلادي، وقبل ذلك، كما أشرنا!
والخلاصة: أن للشِّعر العربي هويّةً تختلف عن هويّة الشِّعر الغربيّ، اختُطفتْ وغُرّبتْ عن منابتها. وعليه، فإن من يريد فرض قصيدة النثر، بوصفها شِعرًا، إنما يقتبس فهمًا غربيًّا لماهيّة الشِّعر، غريبًا عن الفهم العربيّ لماهيّة الشِّعر. وتلك الماهيّة الشِّعريّة المقتبسة مستوعَبةٌ سلفًا في (النثر الفنّي العربي) منذ القِدَم، لكنها لا تكفي- بحسب الذوق العربيّ والتجربة العربيّة- لتكوين نصّ يندرج فيما يَعُدُّه العربُ من الجنس الشعريّ. ومَثَل أولئك كمن يريد أن يُرغم العربيّ على تصديق أن بغلاً هو حصانٌ عربيّ أصيل، لا لشيء إلاّ لأن فيه بعض الشَّبَه بالخيل.. أو أن نبتة لبلابٍ متسلّقة هي نخلةٌ من أرض هَجَر أو العراق! وعندئذٍ ستكون بضاعة أولئك أسوأ في العيون العربيّة ممّن قيل فيه: إنه كجالب التمر إلى هَجَر؛ لأن جلوبة جالب قصيدة النثر مردودةٌ جملةً، لا لعدم جودتها؛ بل لأنها مختلفة نوعيًّا.
ا
لشاعر الناقد:
الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن أحمد الفَيفي
(رئيس لجنة الشؤون الثقافيّة والإعلامية في مجلس الشورى السعودي- الأستاذ في جامعة الملك سعود بالرياض)
الأربعاء 13 محرّم 1431هـ= 30 ديسمبر 2009م
الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن أحمد الفَيفي
(رئيس لجنة الشؤون الثقافيّة والإعلامية في مجلس الشورى السعودي- الأستاذ في جامعة الملك سعود بالرياض)
الأربعاء 13 محرّم 1431هـ= 30 ديسمبر 2009م
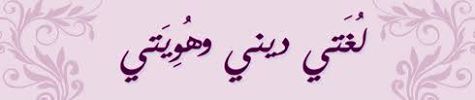


تعليق