المصدر الميمي: حاجته، وجوده في القرآن الكريم، إشكالية المصطلح والمصطلح البديل
بقلم: مهند حسن الشاوي
بقلم: مهند حسن الشاوي
بسم الله الرحمن الرحيم
تعوّد علماء الصرف المتأخرون، وهم من يدرسون أحوال هيئات الكلمة المختلفة وما تؤدي من معانٍ مختصة، بعيداً عن الأثر الإعرابي وعامله، أن يدرجوا موضوع المصادر ضمن مصنفاتهم. ودراسة هيئات المصادر بحسب القياس الصرفي، تجعلهم يقسمونها قسمين: مصادر قياسية ومصادر سماعية.
والمقصود بالأولى (القياسية) هي المصادر التي تقع تحت ضابطة مطردة ، وتشمل جميع مصادر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، فيستطيع من ألمّ بهذه الضوابط معرفة هيئة أي مصدر بمجرد تعيين الفعل ، فإذا قيل له: كسّر، قال: تكسيرا، وإذا قيل له: تضامن، قال: تضامناً، وإذا قيل له: اعشوشب، قال: اعشيشاباً، وهكذا.. بغض النظر عما شذّ.
والمقصود بالثانية (السماعية) هي المصادر التي لا ضابط لها، بل يرجع الى معرفة هيآتها الى لغة العرب من قرآن أو حديث أو شعر أو ما جمعته المعاجم اللغوية في ذلك، ولا يستطيع أحد أن يصل إليها بعملية قياسية، بل يقف هنا عاجزاً معولاً على السماع فقط، وتختص بمصدر الفعل الثلاثي كضرب وجحد وقام ونحوها.. بغض النظر عن الضوابط الجزئية التي وضعت لبعض المعاني كوزن فعلان للاضطراب وفعالة للصنعة ونحوهما مما لا يشكل قاعدة مطردة على نحو الكلية.
إن مسألة مصدر الفعل الثلاثي ومعرفة ضابطه تعد من أهم الصعوبات التي تواجه المثقف العربي المهتم بلغته، حيث أنه إذا أراد أن يعبر عن مصدر ما لفعل ثلاثي ويكون مضبوطاً فلا بد له من وجود معجم بقربه، لتشعب هيئات هذا الفعل الى اثنين وثلاثين باباً كما نقلها صاحب المراح عن سيبويه، وهي: قَتْل، وفِسْق، وشُغْل، ورَحْمَة، ونِشْدَة، وكُدْرَة، ودَعْوَى، وذِكْرَى، وبُشْرَى، ولَيَّان، وحِرْمان، وغُفْرَان، ونَزَوَان، وطَلَب، وخَنِق، وصَغِر، وهُدًى، وَغَلَبَة، وسَرِقَة، وذَهَاب، وصِرَاف، وسُؤَال، وزَهَادَة، ودِرَايَة، ودُخُول، وقَبُول، ووَجِيْف، وصُهُوبة، ومَدْخَل، ومَرْجِع، ومَسْعاة، ومَحْمَدة.
هنا لا بد من آلية تسهل على الكاتب والشاعر والأديب مسألة وجود ضابطة لمصدر الفعل الثلاثي، وكأن الواضع من قبل قد شعر بوجود هذه الضرورة، أقول كأنَّ، لعدم معرفتنا الى الآن على وجه الدقة كيفية وضع لغتنا، ولأن المدقق في مفرداتها واتساقها يعود دهشاً مبهوراً لما تضمنته من كنوز، وأعود الى قولي مصوراً لي خيالي وكأن الواضع قد شعر بضرورة وجود ضابطة تجمع المتفرق وتلم شعثه ضمن هيئة إضافية موحّدة مطردة، تصلح أن تكون مصدراً لكل فعل ثلاثي، وقد بحث عن مرجح لاختيار هذه الهيئة دون سواها،
فلم يجد هيئة تناسب المصدر هذا إلا ما كانت على هيئة هذا المسمى نفسه أي لفظة (مَصْدَر) لذا كانت الهيئة المنتخبة هي هيئة (مَفْعَل)
فأخذ المصادر السماعية أمثال: ضَرْب، ودُخُول، وطَلَب، وفِرار، وغيرها، ووحدها ضمن هيئة إضافية تكون بديلاً عنها، فقال: مَضْرَب، ومَدْخَل، وَمَطْلَب، ومَفَرّ.. ثمَّ شملت جزءاً منها بعضُ التغييرات أو الإضافات حسب قواعد الإعلال أو إلحاق التاء، فجاءت بعضها ملحقة بالتاء نحو: مكرمة، مظلمة، محمدة، محبّة، مذمّة،.. وهكذا،
وأبدلت الأخرى من (مَفْعَل) الى (مَفْعِل) بكسر العين في المعتلات: في المثال الواوي محذوف الفاء في مصدره، نحو: عدة، وثقة،.. فكانت: موعِد، ومَوْثِق، .. أما في الأجوف فالوجهان جائزان، فيقال في توبة وحيض: متاباً ومحيضاً. وبهذا تكون هذه الهيئة ضمن ضابطة مطردة تسهل الأمر على الأدباء والكتاب والشعراء في صياغة مصدر أي فعل ثلاثي دون الرجوع الى معجم،
لكننا نجد أن أكثرهم اليوم قد أعرض عن هذا المصدر كلياً هذا إذا اعتبرنا أنه كان يعرفه أصلاً. كما انَّ الصرفيين قبلهم لم يسرفوا في الكلام عنه، ولم يهتموا به كثيرا.
(طبعاً لا ننسى أن نذكر أن هذا المصدر قد وحّدت به بقية المصادر من رباعية وخماسية وسداسية بضابطة واحدة وهي أن يكون على وزن اسم مفعوله، لكن ما يهمنا هنا هو المصدر الثلاثي لعدم وجود ضابطة فيه).
تعوّد علماء الصرف المتأخرون، وهم من يدرسون أحوال هيئات الكلمة المختلفة وما تؤدي من معانٍ مختصة، بعيداً عن الأثر الإعرابي وعامله، أن يدرجوا موضوع المصادر ضمن مصنفاتهم. ودراسة هيئات المصادر بحسب القياس الصرفي، تجعلهم يقسمونها قسمين: مصادر قياسية ومصادر سماعية.
والمقصود بالأولى (القياسية) هي المصادر التي تقع تحت ضابطة مطردة ، وتشمل جميع مصادر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، فيستطيع من ألمّ بهذه الضوابط معرفة هيئة أي مصدر بمجرد تعيين الفعل ، فإذا قيل له: كسّر، قال: تكسيرا، وإذا قيل له: تضامن، قال: تضامناً، وإذا قيل له: اعشوشب، قال: اعشيشاباً، وهكذا.. بغض النظر عما شذّ.
والمقصود بالثانية (السماعية) هي المصادر التي لا ضابط لها، بل يرجع الى معرفة هيآتها الى لغة العرب من قرآن أو حديث أو شعر أو ما جمعته المعاجم اللغوية في ذلك، ولا يستطيع أحد أن يصل إليها بعملية قياسية، بل يقف هنا عاجزاً معولاً على السماع فقط، وتختص بمصدر الفعل الثلاثي كضرب وجحد وقام ونحوها.. بغض النظر عن الضوابط الجزئية التي وضعت لبعض المعاني كوزن فعلان للاضطراب وفعالة للصنعة ونحوهما مما لا يشكل قاعدة مطردة على نحو الكلية.
إن مسألة مصدر الفعل الثلاثي ومعرفة ضابطه تعد من أهم الصعوبات التي تواجه المثقف العربي المهتم بلغته، حيث أنه إذا أراد أن يعبر عن مصدر ما لفعل ثلاثي ويكون مضبوطاً فلا بد له من وجود معجم بقربه، لتشعب هيئات هذا الفعل الى اثنين وثلاثين باباً كما نقلها صاحب المراح عن سيبويه، وهي: قَتْل، وفِسْق، وشُغْل، ورَحْمَة، ونِشْدَة، وكُدْرَة، ودَعْوَى، وذِكْرَى، وبُشْرَى، ولَيَّان، وحِرْمان، وغُفْرَان، ونَزَوَان، وطَلَب، وخَنِق، وصَغِر، وهُدًى، وَغَلَبَة، وسَرِقَة، وذَهَاب، وصِرَاف، وسُؤَال، وزَهَادَة، ودِرَايَة، ودُخُول، وقَبُول، ووَجِيْف، وصُهُوبة، ومَدْخَل، ومَرْجِع، ومَسْعاة، ومَحْمَدة.
هنا لا بد من آلية تسهل على الكاتب والشاعر والأديب مسألة وجود ضابطة لمصدر الفعل الثلاثي، وكأن الواضع من قبل قد شعر بوجود هذه الضرورة، أقول كأنَّ، لعدم معرفتنا الى الآن على وجه الدقة كيفية وضع لغتنا، ولأن المدقق في مفرداتها واتساقها يعود دهشاً مبهوراً لما تضمنته من كنوز، وأعود الى قولي مصوراً لي خيالي وكأن الواضع قد شعر بضرورة وجود ضابطة تجمع المتفرق وتلم شعثه ضمن هيئة إضافية موحّدة مطردة، تصلح أن تكون مصدراً لكل فعل ثلاثي، وقد بحث عن مرجح لاختيار هذه الهيئة دون سواها،
فلم يجد هيئة تناسب المصدر هذا إلا ما كانت على هيئة هذا المسمى نفسه أي لفظة (مَصْدَر) لذا كانت الهيئة المنتخبة هي هيئة (مَفْعَل)
فأخذ المصادر السماعية أمثال: ضَرْب، ودُخُول، وطَلَب، وفِرار، وغيرها، ووحدها ضمن هيئة إضافية تكون بديلاً عنها، فقال: مَضْرَب، ومَدْخَل، وَمَطْلَب، ومَفَرّ.. ثمَّ شملت جزءاً منها بعضُ التغييرات أو الإضافات حسب قواعد الإعلال أو إلحاق التاء، فجاءت بعضها ملحقة بالتاء نحو: مكرمة، مظلمة، محمدة، محبّة، مذمّة،.. وهكذا،
وأبدلت الأخرى من (مَفْعَل) الى (مَفْعِل) بكسر العين في المعتلات: في المثال الواوي محذوف الفاء في مصدره، نحو: عدة، وثقة،.. فكانت: موعِد، ومَوْثِق، .. أما في الأجوف فالوجهان جائزان، فيقال في توبة وحيض: متاباً ومحيضاً. وبهذا تكون هذه الهيئة ضمن ضابطة مطردة تسهل الأمر على الأدباء والكتاب والشعراء في صياغة مصدر أي فعل ثلاثي دون الرجوع الى معجم،
لكننا نجد أن أكثرهم اليوم قد أعرض عن هذا المصدر كلياً هذا إذا اعتبرنا أنه كان يعرفه أصلاً. كما انَّ الصرفيين قبلهم لم يسرفوا في الكلام عنه، ولم يهتموا به كثيرا.
(طبعاً لا ننسى أن نذكر أن هذا المصدر قد وحّدت به بقية المصادر من رباعية وخماسية وسداسية بضابطة واحدة وهي أن يكون على وزن اسم مفعوله، لكن ما يهمنا هنا هو المصدر الثلاثي لعدم وجود ضابطة فيه).
وقد استعمل القرآن الكريم هذا المصدر في آياتٍ عدة استطعت أن أحصيَ منها عدداً منه لا بأس به على ما حققه المفسرون على اختلاف فيه بينهم، وهذا الإحصاء قد ينفع العالم والمتعلم وطالب الشواهد، وكان ضمن ذلك أن اخترت آية من مجموع الآيات التي تكرر نفس المصدر المعين فيها وأغفلَتُ الأخر، وهي:
(فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ) البقرة : 66
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) البقرة : 222
(فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) آل عمران : 188
(فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) المائدة : 3
(وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) التوبة : 120
(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ) التوبة : 114
(وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) هود : 41
(وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ) يوسف : 23
(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً) الكهف : 52
(وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) طه : 39
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً) طه : 124
(وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً) الفرقان : 71
(وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ) الروم : 23
(كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ) ص : 3
(قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) الشورى : 23
(وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ) الشورى : 44
(أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ) الجاثية : 21
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً) النبأ : 31
(أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) البلد : 14- 19.
(سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) القدر : 5
(فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ) البقرة : 66
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) البقرة : 222
(فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) آل عمران : 188
(فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) المائدة : 3
(وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) التوبة : 120
(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ) التوبة : 114
(وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) هود : 41
(وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ) يوسف : 23
(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً) الكهف : 52
(وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) طه : 39
(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً) طه : 124
(وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً) الفرقان : 71
(وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ) الروم : 23
(كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ) ص : 3
(قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) الشورى : 23
(وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ) الشورى : 44
(أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ) الجاثية : 21
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً) النبأ : 31
(أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) البلد : 14- 19.
(سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) القدر : 5
وقد أطلق الصرفيون على هذا المصدر المهم اسم (المصدر الميمي) ودعواهم أن سبب هذه التسمية هو ملازمة الميم لأوله، وأرى أن في هذا تحكماً وتكلفاً، لان بعض المصادر المختلفة تشترك معه بأنها تبدأ بالميم أيضاً، بل تلازم البعض منها، نحو: ميسور، ومعسور، ومجلود، ومفتون، ومجاهدة، ومناقشة، ومحاورة... ونحوها. وهي ليست منه.
والذي أراه هو أن يبدل بهذا المصطلح مصطلح جديد يتناسب مع أهمية المسمى كأن نسميه (المصدر الموحِّد) لأنه يوحد جميع مصادر الفعل الثلاثي السماعية في هيئة قياسية بضابطة واحدة
وأرى أن يسلط الضوء أكثر على هذا المصدر لما فيه من تيسير في اللغة على المثقفين والمتأدبين.
مهند حسن الشاوي
12 / 3 / 2010م
والذي أراه هو أن يبدل بهذا المصطلح مصطلح جديد يتناسب مع أهمية المسمى كأن نسميه (المصدر الموحِّد) لأنه يوحد جميع مصادر الفعل الثلاثي السماعية في هيئة قياسية بضابطة واحدة
وأرى أن يسلط الضوء أكثر على هذا المصدر لما فيه من تيسير في اللغة على المثقفين والمتأدبين.
مهند حسن الشاوي
12 / 3 / 2010م
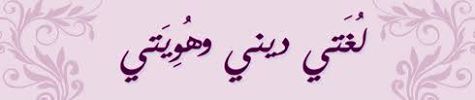
تعليق