ما سقط من كتب علم الصرف وأغفله النحاة
(اسم الفضالة)
بقلم: مهند حسن الشاوي
(اسم الفضالة)
بقلم: مهند حسن الشاوي
يقسم الصرفيون المشتقات من الأسماء، وهي ما أُخذ من المصدر أو الفعل على خلاف بينهم، سبعة أقسام: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم الآلة، واسمي الزمان والمكان.
وتدخل هذه الأقسام ضمن نوعين من الأسماء: اسم وصف،واسم جنس.
فاسم الفاعل والمفعول والتفضيل والصفة المشبهة إنما هي أوصاف تصح أن تكون نعوتاً في الجمل، وهي تعمل عمل الفعل وفق ضوابط معينة، لذا سميت أوصاف عاملة.
أما اسم الزمان والمكان والآلة فهي اسم جنس يصلح أن ينعت بغيره، وهذه المشتقات الثلاثة الأخيرة لا تعمل عمل فعلها، لذا فالنحاة لا يبدون لها اهتماماً، لكون اهتماماتهم منصبّة على العوامل ومعمولاتها، فتكون خارجة تخصصاً عن مثل هذه المواضيع.
وقد تقرر عندهم عدد المشتقات وكونها سبعة أقسام بالتواتر، خلال قرون، وهو ما تقيّدت به مصنفاتهم وكتبهم.
وقد أهملوا فيما نرى ثامن المشتقات وأغفلوا أمره، وما نعنيه هو ما نطلق عليه (اسم الفُضالة) والذي يندرج مع اسم الآلة واسمي الزمان والمكان في كونها ليست أوصافاً عاملة.
وتدخل هذه الأقسام ضمن نوعين من الأسماء: اسم وصف،واسم جنس.
فاسم الفاعل والمفعول والتفضيل والصفة المشبهة إنما هي أوصاف تصح أن تكون نعوتاً في الجمل، وهي تعمل عمل الفعل وفق ضوابط معينة، لذا سميت أوصاف عاملة.
أما اسم الزمان والمكان والآلة فهي اسم جنس يصلح أن ينعت بغيره، وهذه المشتقات الثلاثة الأخيرة لا تعمل عمل فعلها، لذا فالنحاة لا يبدون لها اهتماماً، لكون اهتماماتهم منصبّة على العوامل ومعمولاتها، فتكون خارجة تخصصاً عن مثل هذه المواضيع.
وقد تقرر عندهم عدد المشتقات وكونها سبعة أقسام بالتواتر، خلال قرون، وهو ما تقيّدت به مصنفاتهم وكتبهم.
وقد أهملوا فيما نرى ثامن المشتقات وأغفلوا أمره، وما نعنيه هو ما نطلق عليه (اسم الفُضالة) والذي يندرج مع اسم الآلة واسمي الزمان والمكان في كونها ليست أوصافاً عاملة.
واسم الفُضَالة: هو اسم مشتق من الحدث للدلالة على فضالته، أو ما تناثر منه. ويصاغ على زنة (فُعَالَة) من الثلاثي أو المزيد فيه.
قال ابن قتيبة في أدب الكاتب:
(وفُعَالَة تأتي كثيراً في فَضْلة الشيء وفيما يَسْقُط منه، فـ "النُّخَالة" اسم ما وقع عن النَّخْل، و"النُّحَاتة" اسم ما وقع عن النَّحْت، و"القُوَارة" اسم ما وقع عن التقوير، و"قُلامة الظفر" اسم ما وقع عن التقليم، و"السُّحَالة" اسم ما وقع عن السَّحْل، و"الخُلالَة" اسم ما وقع عن التخلل من الفم، و"الكُسَاحَة" اسم ما نبذ عن الكَسْح. وكذلك "القُمامَة" اسم ما وقع عن القَمِّ، وهو الكَسْح، و"الفُضَالَة" اسم ما بقي بعد الأخذ، و"النُّفَاية" اسم ما بقي بعد الاختيار).
وكما إنهم صاغوا الفضالة على هذا الوزن، فقد صاغوا النقاوة من الشيء على نفس الوزن لأن العرب غالباً ما تبني هيئة الشيء على ضدها، كما هو ظاهر لكل من خبر لغتهم. والجامع بينهما هو الندرة والتخلّف من الشيء.
قال ابن قتيبة: (وقد بَنَوا النُّقاوَة من الشيء أيضاً على فُعالة؛ إذ كان ضدَّ النُّفَاية؛ لأنهم كثيراً ما يبنون الشيء على بناء ضدّه. فقالوا مثلاً: خُلاصة السمن إي ما خلص منها).
ومما استطعنا إحصاءه من أسماء الفضالة مما صاغه العرب على هذا الوزن اعتماداً على معاجم اللغة ومصنفاتها قولهم:
براية العود، وبرادة الحديد، وثمالة الطعام والشراب؛ أي بقيته في البطن، وجرامة التمر، قال الأعشى [من الطويل]:
فَلَو كُنتُمُ نَخلاً لَكُنتُم جُرامَةً = وَلَو كُنتُمُ نَبلاً لَكُنتُم مَعاقِصا
وجفالة اللبن، وحفافة التبن والقتّ، وحفالة التمر، وحزازة الوسخ في الرأس، وحسافة التمر، وحذافة الأديم، وحوافة ورق القتّ، وخراطة العود، وخلالة الفم، وخشارة الناس، وخلاصة السمن، ورذالة المتاع، ورواية اللبن ورغاوته، وسحالة الفضّة والذهب، كقول ابن رشيق القيرواني [من السريع]:
يحكي أَصيلُ الجوِّ في نهرِها = سُحالةَ العَسْجدِ في المِبْرَدِ
وشفافة الماء واللبن، وصبابة الماء، كما ورد في النهج:
(ألا وإن الدنيا قد ولّت حذّاء، فلم يبقَ منها إلا صُبابة كصُبابة الإناء)
وصواحة الصوف، وطفاحة الخمر، وطُباخة ما يطبخ، وعصافة التبن، وعصارة الحنّاء، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
كَأَنَّ دِماءَ الهادِياتِ بِنَحرِهِ = عُصارَةُ حَنّاءٍ بِشَيبٍ مُخَضَّبِ
وعلالة اللبن، وغُسالة الثياب، وفتاتة الخبز، وفضالة الشيء، وقراطة أنف السراج، وقلامة الظفر، قال ابن المعتز [من البسيط]:
وَلاحَ ضَوءُ هِلالٍ كادَ يَفضَحُنا = مِثلَ القُلامَةِ قَد قُدَّت مِنَ الظُفُرِ
وقرامة الفرن، وحثالة القرظ، وقراضة الجلم، كما ورد في النهج:
(فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرظ، وقراضة الجلم)
وقشامة الطعام، وقشارة الشعير، وقطافة العنب، وقمامة البيت وكناسته، وفي الحديث:
(لكل شيء قمامة؛ وقمامة المسجد: لا والله، وبلى والله)
وقصاصة الهدب، ولماظة الطعام أي بقيته في الفم، كما ورد في النهج:
(ألا حُرٌّ يدعُ هذي اللماظة لأهلها)
ومشاطة الشعر، ومكاكة العظم، ومجاعة التمر المعجون باللبن، ونشارة الخشب ونحاتته، ونفاية الدراهم، ونتافة الإبط، ونسافة السويق، ونثارة الحنطة والشعير، ونشافة اللبن، ونقاوة الشيء، ونفاثة المصدور.
ويقال: إنَّه لَذُوْ بُرَايَةٍ: إذا كانَ ذا بَقِيَّةٍ بَعْدَ بَرْيِ السَّفَرِ إيّاه... ونحو ذلك من التراكيب.
ثُمَّ إنه قد يأتي اسم البقيّة بلا تاء، أي على زنة (فُعَال)، نحو رُفَات الموتى، قال تعالى:
(وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) [الإسراء49]
وحُطَام اليبيس، قال تعالى:
(ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً) [الزمر21]
وجُذَاذ الذهب، قال تعالى:
(فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) [الأنبياء58]
وفُضَاض الشيء، وفُتَات المسك ونحوه، قال قيس بن ذريح [من الطويل]:
كَأَنَّ هُبوبَ الريحِ مِن نَحوِ أَرضَكُم = يُثيرُ فُتاتَ المِسكِ وَالعَنبَرَ النَدى
وقال زهير [من الطويل]:
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ في كُلِّ مَنْزِلٍ = نَزَلْنَ بِه حَبُّ الْفَنَا لَمْ يُحَطَّمِ
وفُتَاتُ العِهْنِ والصُّوفِ: ما تَساقَطَ مِنْهُ. ورُذَال الشيء وهو ما تخلف بعد انتقاء جيده، ولباب البر، كما ورد في النهج:
(ولو شئت لاهتديت الطريق الى مُصفّى هذا العسل، ولُباب هذا القمح)
ومصاص الحسب، وسلاف العصير، ونُثار الخوان وهو الفتات المتناثر حوله من خبز ونحوه.
وما نراه هو أن يضاف هذا المشتق الى بقية المشتقات، ويندرج ضمنها في الكتب المصنفة في هذا العلم، وأن تقر مثل هذه الصيغة (فُعالة) من قبل المجامع العلمية للدلالة على فضالة الشيء أو ما تناثر منه أو نقاوته، والجامع بينها هو ندرة ذلك الشيء وقلته، وتخلّفه عن أصله، وهذا ما يعطي اللغة نمواً ومرونة، والأدباء والكتاب أفقاً أوسع في استعمال لغتهم وإمكانية الاشتقاق منها.
قال ابن قتيبة في أدب الكاتب:
(وفُعَالَة تأتي كثيراً في فَضْلة الشيء وفيما يَسْقُط منه، فـ "النُّخَالة" اسم ما وقع عن النَّخْل، و"النُّحَاتة" اسم ما وقع عن النَّحْت، و"القُوَارة" اسم ما وقع عن التقوير، و"قُلامة الظفر" اسم ما وقع عن التقليم، و"السُّحَالة" اسم ما وقع عن السَّحْل، و"الخُلالَة" اسم ما وقع عن التخلل من الفم، و"الكُسَاحَة" اسم ما نبذ عن الكَسْح. وكذلك "القُمامَة" اسم ما وقع عن القَمِّ، وهو الكَسْح، و"الفُضَالَة" اسم ما بقي بعد الأخذ، و"النُّفَاية" اسم ما بقي بعد الاختيار).
وكما إنهم صاغوا الفضالة على هذا الوزن، فقد صاغوا النقاوة من الشيء على نفس الوزن لأن العرب غالباً ما تبني هيئة الشيء على ضدها، كما هو ظاهر لكل من خبر لغتهم. والجامع بينهما هو الندرة والتخلّف من الشيء.
قال ابن قتيبة: (وقد بَنَوا النُّقاوَة من الشيء أيضاً على فُعالة؛ إذ كان ضدَّ النُّفَاية؛ لأنهم كثيراً ما يبنون الشيء على بناء ضدّه. فقالوا مثلاً: خُلاصة السمن إي ما خلص منها).
ومما استطعنا إحصاءه من أسماء الفضالة مما صاغه العرب على هذا الوزن اعتماداً على معاجم اللغة ومصنفاتها قولهم:
براية العود، وبرادة الحديد، وثمالة الطعام والشراب؛ أي بقيته في البطن، وجرامة التمر، قال الأعشى [من الطويل]:
فَلَو كُنتُمُ نَخلاً لَكُنتُم جُرامَةً = وَلَو كُنتُمُ نَبلاً لَكُنتُم مَعاقِصا
وجفالة اللبن، وحفافة التبن والقتّ، وحفالة التمر، وحزازة الوسخ في الرأس، وحسافة التمر، وحذافة الأديم، وحوافة ورق القتّ، وخراطة العود، وخلالة الفم، وخشارة الناس، وخلاصة السمن، ورذالة المتاع، ورواية اللبن ورغاوته، وسحالة الفضّة والذهب، كقول ابن رشيق القيرواني [من السريع]:
يحكي أَصيلُ الجوِّ في نهرِها = سُحالةَ العَسْجدِ في المِبْرَدِ
وشفافة الماء واللبن، وصبابة الماء، كما ورد في النهج:
(ألا وإن الدنيا قد ولّت حذّاء، فلم يبقَ منها إلا صُبابة كصُبابة الإناء)
وصواحة الصوف، وطفاحة الخمر، وطُباخة ما يطبخ، وعصافة التبن، وعصارة الحنّاء، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
كَأَنَّ دِماءَ الهادِياتِ بِنَحرِهِ = عُصارَةُ حَنّاءٍ بِشَيبٍ مُخَضَّبِ
وعلالة اللبن، وغُسالة الثياب، وفتاتة الخبز، وفضالة الشيء، وقراطة أنف السراج، وقلامة الظفر، قال ابن المعتز [من البسيط]:
وَلاحَ ضَوءُ هِلالٍ كادَ يَفضَحُنا = مِثلَ القُلامَةِ قَد قُدَّت مِنَ الظُفُرِ
وقرامة الفرن، وحثالة القرظ، وقراضة الجلم، كما ورد في النهج:
(فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرظ، وقراضة الجلم)
وقشامة الطعام، وقشارة الشعير، وقطافة العنب، وقمامة البيت وكناسته، وفي الحديث:
(لكل شيء قمامة؛ وقمامة المسجد: لا والله، وبلى والله)
وقصاصة الهدب، ولماظة الطعام أي بقيته في الفم، كما ورد في النهج:
(ألا حُرٌّ يدعُ هذي اللماظة لأهلها)
ومشاطة الشعر، ومكاكة العظم، ومجاعة التمر المعجون باللبن، ونشارة الخشب ونحاتته، ونفاية الدراهم، ونتافة الإبط، ونسافة السويق، ونثارة الحنطة والشعير، ونشافة اللبن، ونقاوة الشيء، ونفاثة المصدور.
ويقال: إنَّه لَذُوْ بُرَايَةٍ: إذا كانَ ذا بَقِيَّةٍ بَعْدَ بَرْيِ السَّفَرِ إيّاه... ونحو ذلك من التراكيب.
ثُمَّ إنه قد يأتي اسم البقيّة بلا تاء، أي على زنة (فُعَال)، نحو رُفَات الموتى، قال تعالى:
(وَقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً) [الإسراء49]
وحُطَام اليبيس، قال تعالى:
(ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً) [الزمر21]
وجُذَاذ الذهب، قال تعالى:
(فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) [الأنبياء58]
وفُضَاض الشيء، وفُتَات المسك ونحوه، قال قيس بن ذريح [من الطويل]:
كَأَنَّ هُبوبَ الريحِ مِن نَحوِ أَرضَكُم = يُثيرُ فُتاتَ المِسكِ وَالعَنبَرَ النَدى
وقال زهير [من الطويل]:
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ في كُلِّ مَنْزِلٍ = نَزَلْنَ بِه حَبُّ الْفَنَا لَمْ يُحَطَّمِ
وفُتَاتُ العِهْنِ والصُّوفِ: ما تَساقَطَ مِنْهُ. ورُذَال الشيء وهو ما تخلف بعد انتقاء جيده، ولباب البر، كما ورد في النهج:
(ولو شئت لاهتديت الطريق الى مُصفّى هذا العسل، ولُباب هذا القمح)
ومصاص الحسب، وسلاف العصير، ونُثار الخوان وهو الفتات المتناثر حوله من خبز ونحوه.
وما نراه هو أن يضاف هذا المشتق الى بقية المشتقات، ويندرج ضمنها في الكتب المصنفة في هذا العلم، وأن تقر مثل هذه الصيغة (فُعالة) من قبل المجامع العلمية للدلالة على فضالة الشيء أو ما تناثر منه أو نقاوته، والجامع بينها هو ندرة ذلك الشيء وقلته، وتخلّفه عن أصله، وهذا ما يعطي اللغة نمواً ومرونة، والأدباء والكتاب أفقاً أوسع في استعمال لغتهم وإمكانية الاشتقاق منها.
مهند حسن الشاوي
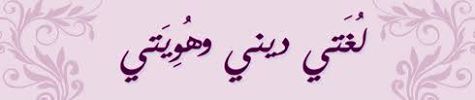
تعليق