الفرق الدلالي بين "إذا" و "إن" الشرطيتين
وبلاغة آية
وبلاغة آية
(فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ)
[الأعراف131]
[الأعراف131]
قد لا يستطع البعض التفريق بين أداتي الشرط (إذا) و(إن) من حيث دلالتيهما، ويحسب أن لهما نفس الدلالة
والواقع إن العرب تستعمل كلاً منهما في سياق خاص ومعنى من المعاني
والواقع إن العرب تستعمل كلاً منهما في سياق خاص ومعنى من المعاني
فـ (إذا) يستعملها العرب حين يكون السبب (الشرط) الداخلة عليه راجح الوقوع
فتقول (إذا أتيتني أكرمتك) حين تكون مرجحاً لإتيانه
وتقول (إذا طلعت الشمس أزورك)
ولهذا كانت (إذا) تدخل غالباً على لفظ الماضي لدلالة المضي على رجحان الوقوع أيضاً
فتقول (إذا أتيتني أكرمتك) حين تكون مرجحاً لإتيانه
وتقول (إذا طلعت الشمس أزورك)
ولهذا كانت (إذا) تدخل غالباً على لفظ الماضي لدلالة المضي على رجحان الوقوع أيضاً
أما (إن) فيستعملها العرب إذا كان السبب مرجوح الوقوع، أو راجح العدم
فتقول (إن تأتِني أكرمْك) حين تكون غير مرجح لإتيانه
ولا يجوز أن تقول (إن طلعت الشمس أزرك)
ولهذا كله كانت (إن) تستعمل في الأمور النادرة وغير الراجحة
فتقول (إن تأتِني أكرمْك) حين تكون غير مرجح لإتيانه
ولا يجوز أن تقول (إن طلعت الشمس أزرك)
ولهذا كله كانت (إن) تستعمل في الأمور النادرة وغير الراجحة
قال الزمخشري في الكشاف في ذيل تفسير هذه الآية:
(فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ)
فإن قلت: كيف قيل (فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ) بـ إذا وتعريف الحسنة، و(وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) بـ إن وتنكير السيئة ؟
قلت: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه، وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منها
ومنه قول بعضهم: قد عدّدتَ أيام البلاء، فهل عدّدتَ أيام الرخاء
(فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ)
فإن قلت: كيف قيل (فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ) بـ إذا وتعريف الحسنة، و(وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) بـ إن وتنكير السيئة ؟
قلت: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه، وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا شيء منها
ومنه قول بعضهم: قد عدّدتَ أيام البلاء، فهل عدّدتَ أيام الرخاء
وقال الجرجاني في الإشارات: (فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ)
لأن وقوع الحسنة راجح، ووقوع السيئة مرجوح لكونه نادراً
وهذا يطابق قول الحكماء: إن الخير غالب في عالم الكون، والفساد والشر أقل منه.
لأن وقوع الحسنة راجح، ووقوع السيئة مرجوح لكونه نادراً
وهذا يطابق قول الحكماء: إن الخير غالب في عالم الكون، والفساد والشر أقل منه.
وقال بعضهم : ثم ذكر الحسنة بكلمة (إذا) والسيئة بلفظة (إن) حين قال: (فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ)
فقد جعل مجيء الحسنة كالأصل الثابت فذكره بـ إذا والتعريف بلام الجنس، ثم ذكر إصابة السيئة وأتى بها بطريق الشرط ونكر السيئة ليدل على ندرتها وكونها
اتفاقية.
فقد جعل مجيء الحسنة كالأصل الثابت فذكره بـ إذا والتعريف بلام الجنس، ثم ذكر إصابة السيئة وأتى بها بطريق الشرط ونكر السيئة ليدل على ندرتها وكونها
اتفاقية.
وقال غيره: في تعريف الحسنة وتنكير السيئة فن عجيب من فنون علم المعاني، فقد عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحداثها، ونكّر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندرتها، ولعدم القصد إليها إلا بالتبع، وفي الحسنة والسيئة طباق جميل.
وقال الهاشمي في جواهر البلاغة: الأصل عدم جزم وقطع المتكلم بوقوع الشرط في المستقبل مع (إن) ومن ثم كثر أن تستعمل (إن) في الأحوال التي يندر وقوعها ووجب أن يتلوها لفظ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه، بخلاف (إذا) فتستعمل بحسب أصلها في كل ما يقطع المتكلم بوقوعه في المستقبل، ومن أجل هذا لا تستعمل (إذا) إلا في الأحوال الكثيرة الوقوع ويتلوها الماضي لدلالته على الوقوع والحصول قطعاً ، كقوله تعالى: (فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ) فلكون مجيء الحسنة منه تعالى محققاً ذكر هو والماضي مع إذا، وإنما كان محققاً لأن المراد بها مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة من خصب ورخاء وكثرة أولاد، كما يفهم من التعريف بأل الجنسية في لفظة الحسنة، ولكون مجيء السيئة نادراً، ذكر هو والمضارع مع إن، وإنما كان ما ذكر نادراً لأن المراد بها نوع قليل، وهو جدب وبلاء كما يفهم من التنكير في سيئة على التقليل.
وهذا الذي تقدم حول (إذا) و(إن) إنما هو الاستعمال الحقيقي لهما ومقتضى الظاهر
وأحياناً تقتضي البلاغة استعمال أحداهما مقام الأخرى على سبيل المجاز والمعنى الثانوي فتستعمل (إن) في مقام القطع لنكتة بلاغية لطيفة فمن ذلك مما ذكره الجرجاني:
1. إنكار المخاطب القطع : كقولك لمن ينكر عليك ركوب الأمير (إن لم يركب الأمير فأين فرسه وغلامه)
2. عدم جري المخاطب على موجب عمله : كقولك لمن يؤذي أباه (إن كان أباك فلا تؤذه)
ومما ذكره الهاشمي في جواهره:
3. التجاهل: نحو قول المعتذر: (إن كنت فعلت هذا فعن خطأ)
4. تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به؛ كما لو كان السفر قطعي الحصول لسعيد غير قطعي لخليل فتقول: (إن سافرتما أراسلكما)
وأحياناً تقتضي البلاغة استعمال أحداهما مقام الأخرى على سبيل المجاز والمعنى الثانوي فتستعمل (إن) في مقام القطع لنكتة بلاغية لطيفة فمن ذلك مما ذكره الجرجاني:
1. إنكار المخاطب القطع : كقولك لمن ينكر عليك ركوب الأمير (إن لم يركب الأمير فأين فرسه وغلامه)
2. عدم جري المخاطب على موجب عمله : كقولك لمن يؤذي أباه (إن كان أباك فلا تؤذه)
ومما ذكره الهاشمي في جواهره:
3. التجاهل: نحو قول المعتذر: (إن كنت فعلت هذا فعن خطأ)
4. تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به؛ كما لو كان السفر قطعي الحصول لسعيد غير قطعي لخليل فتقول: (إن سافرتما أراسلكما)
وتستعمل (إذا) في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيه لأغراض، منها:
1. الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكاً فيه بل ينبغي القطع به، نحو: (إذا كثر المطر هذا العام أخصب الناس)
2. تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به: كقولك: (إذا لم تسافرا كان كذا)
وهذه أمور لطيفة لا يدركها إلا من تمرس بكلام العرب وعرف سننهم في كلامهم ولا تستعمل جزافاً.
1. الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكاً فيه بل ينبغي القطع به، نحو: (إذا كثر المطر هذا العام أخصب الناس)
2. تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف به: كقولك: (إذا لم تسافرا كان كذا)
وهذه أمور لطيفة لا يدركها إلا من تمرس بكلام العرب وعرف سننهم في كلامهم ولا تستعمل جزافاً.
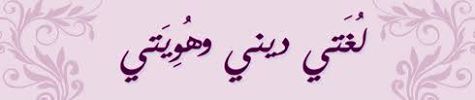
تعليق