السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كل عامٍ وأنتم بألف خير
تم بعون الله على مدى عشرين يومًا
استقبال المشاركات في مسابقة قراءة في كتاب
لشهر آب (أوغسطس ) 2010 م
وقد شارك كل من الأخ الأستاذ المعطاوي المصطفى
وقدّم لنا مشاركة بعنوان:
* تشكل العوالم في قصيدة النثر العربية
نموذج: ديوان " بياض الحروف "
للشاعر عبد الرزاق جبران**
و الأخت الأستاذة نجية يوسف وقدّمت لنا مشاركة بعنوان :
قراءة في كُتيّب جراحة الأفكار بين المدارسة و الممارسة ( مقدمة في التغيير السلمي)
للأستاذ الفاضل حسين ليشوري
أرجو من جميع المارّين على هذا المتصفح ابتداءً من اليوم وحتى نهاية هذا الشهرالتصويت على المشاركة والقراءة الأفضل
حتى نستطيع تقليد صاحبها
وسام القراءة والمطالعة لشهر آب (أوغسطس) 2010
ننتظركم
شكرًا لكم
تقديري ومحبتي
رئيس ملتقى القراءة والمطالعة
ركاد حسن خليل
للأستاذ المعطاوي المصطفى
[frame="7 10"]
* المبحث الأولأولا: قصيدة النثر وسؤال المنهج.
نود في البداية أن نطرح سؤالا، نعتقد أن له ما يبرره تاريخا ومنهجا.
يتفق العديد من الباحثين حول تأكيد المخاض الذي ظهرت فيه قصيدةُ النثر العربيةُ؛ المخاضِ الذي تجسدَ في المناوءة الشديدة، من طرف أنصار " شعر التفعيلة ". غير أنه لا يعني ذلك أن هذا الأخير لم يعش الحالةَ نفسَها مع المحافظين الأُوَّلِ، بل العكس من ذلك تماما، إلا أن ما يثير الانتباه هو أن فكرتَه انبثقت من الدعوة إلى نمط جديد من الكتابة، يتجاوز الظاهرةَ الكلاسيةَ ويتوجه نحو تحديثها، إنه التحديث نفسه الذي رامته قصيدة النثر، وقام أنصار" شعر التفعيلة " في وجهه؛ فكان من الطبيعي أن يتحولوا - في نظر الخصوم – إلى محافظين جددا.
في سنة 1959 أي بعد سنتين من صدور مجلة " شعر"، أصدرت دارُها دواوينَ " حزن في ضوء القمر" و " تموز في المدينة" و " لن"، وهي على التوالي لكل من محمد الماغوط، وجبرا إبراهيم جبرا، وأنسي الحاج. ونشرت لشعراء آخرين انضموا إلى خطاب المجلة، كتوفيق صايغ وشوقي أبي شقرا..واللائحة. وكان من حسن حظ المجلة، أنها ضمت من بين أنصار دعواها صوتا هادئا، ودما باردا، ينفث في حقل الشعرية العربية الحديثة المفاهيمَ الجديدةَ لقصيدة النثر، وللشعر عموما بحنكة وذكاء. ونعني بذلك أدونيس.
وفي هذا الصدد، وجبَت الإشارة إلى الهجوم العنيف الذي شنته نازك الملائكة – وهي أكبر منظرة لشعر التفعيلة – على ديوان خزامى صبري (ظلِّ )خالدة سعيد سنة 1962، وهو الهجوم الذي رد عليه يوسف الخال ووصف صاحبته :" ارتدادية متزمتة خانت حركة الشعر الحر التي تدعي المؤلفة اكتشافه..".(3)
ظهرت قصيدة النثر – إذن - في جو من الصراع بين حركتين تجديديتين في الشعر العربي الحديث، وتركز الخلاف بينهما حول عنصر " الإيقاع": ففيما احتفظ به شعر التفعيلة على شكل وزن عروضي منساب على غير نظام الشطرين، ولكن وفق ضوابطَ معروفة؛ جاءت قصيدة النثر بدعواها إلى " تطوير الإيقاع الشعري العربي وصقلِه على ضوء المضامين الجديدة " وأنه ليس " للأوزان التقليدية أيةُ قداسة " كما عبر عن ذلك يوسف الخال، أكبرُ الدعاة في حركة مجلة شعر. وبلهجة شديدة نقرأ من الصفحة الثانية عشرةَ في مقدمة ديوانه " لن" أن: " موسيقى الوزنِ والقافيةِ موسيقى خارجية ثم إنها مهما أمعنتَ التعمق تبقى متصفة بهذه الصفة: إنها قالب صالح لشاعر كان يصلح لها وكان في عالم يناسبها وتناسبه".
كانت الحركتان " الوليدة" و" اليافعة " على خط تماس كهربي، أفضى إلى تلك الشرارة التي لا زالت لم تنطفئ بعد، - وإن خفَّ ضجيجها - في الحقل النقدي العربي بين المتحفظين والمناصرين.
ورغم أن فترة التسعينيات شهدت ثراء على مستوى هذا النمط من الكتابة( أقصد قصيدة النثر)، إلا أنها - في الوقت نفسه - شهدت سجالا أكبرَ، حول الإشكال الأنواعي، وأضافت شرارةً زائدةً على هذا السجال، المجلاتُ الأدبيةُ التي احتضنتِ العديدَ من أقلام قصيدة النثر إبداعا ونقدا.
لكن هل يكفي أن نتخذ من هذا الصراع بين الحركتين، مبررا لتفسير الأزمة التي عاشتها وتعيشها قصيدة النثر، خاصة على المستوى النقدي؟
أعتقدُ أن المسألة تتعدى ذلك إلى ما هو منهجي، ضاعفَ تحفظ النقاد من قصيدة النثر، ومن تم قلةُ الدراسات التي تناولت النص من داخله، واستكناهه كظاهرة إبداعية، في أفق تجريد مفاهيمه ومصطلحاته وأدوات اشتغاله. فإذا ما نظرنا إلى تاريخ الميلاد، نرى أن المنظرين الأوائلَ وأقصد هنا حركة مجلة " شعر"، استقوا مفاهيم قصيدة النثر من خارج النص. بحيث لم تكن الساحة الشعرية العربية آنذاك تحفل بتراكمات نصيةٍ قادرةٍ على بلورة المفاهيم، ومنحِ المشروعية الثقافية والفنية للوليد الجديد. لم تعتمد الحركة – كما هو معلوم - على استقراء الأثر الأدبي، كما فعل مثلا الخليل بن أحمد في أوزان الشعر العربي، أو كما فعل المرزوقي في عمود الشعر، بل تم استيراد المفاهيم التي كانت نتيجةً لاستقراء الظاهرة في الأدب الغربي، وبالضبط وصفةَ سوزان برنار في كتابها الشهير " قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا". منهجيا فالسابق هو الظاهرة واللاحقُ عليها قاعدتُها، وهو الأمر الذي لم تتفطن إليه الحركة أو تجاهلته، إذ النوع – متفقين مع من سبقونا إلى هذا الرأي - لا يتحدد إلا بما ليس واردا في الأنواع الأخرى، وهذا يقتضي تراكما نصيا على مستوى الإبداع الشعري.
وزاد الطين بلة أن الحركة لم تسلك - أثناء البحث عن موطإ قدم للدعوة الجديدة - مسلكَ حركة شعر التفعيلة، التي ربطت ظهور الكتابة الشعرية الجديدة بالتراث، ولم تسعَ- كما اتجهت إليه حركة التفعيلة- إلى أن تُفْهِمَ الذائقة الشعرية العربية، أن الأمر يتعلق بتجديد وتطوير وليس بتجاوز وإلغاء..وكان من المتاح أن تدعم طرحها بفكرة أنه " ابتداء من القرن الرابع، كان السعي لتقريب الشقة بين النثر والشعر:( بحيث) صار الشكلان يعالجان الأغراض نفسها ويستجيران بالمحسنات نفسها".(4)
حرفيا تم استنساخ مفاهيم قصيدة النثر. ولما تعددتِ الأصواتُ منبهةً إلى هذا الخلل المنهجي، عمد رواد الحركة، ومن والاهم من بعد، إلى البحث عن حلول للخروج من الإشكال، وذلك بالسعي إلى منح تلك المفاهيمِ إقامتَها العربية، إلا أنها كانت في كل مرة تسقط في مآزقَ ومغالطاتٍ، دفعتها إلى المغامرة في اقتراح " البديل"، خاصة حين اصطدمت بالثابت في كتابة الشعر العربي وتلقيه وهو " الإيقاع "، أو الوزن العروضي.
لقد تأزم فعلا وضع قصيدة النثر، حين وضعها منظروها وسطا بين مطرقة المنهج وسندان الثقافة؛ خللٍ في التنظير والقطيعة مع الأصول، هذا رغم محاولات أدونيسَ إفهامَ الذائقة الشعرية العربية الحديثة، أن قصيدةَ النثر تنتمي إلى حداثة عربية، تعود أصولها إلى العصرين الأموي والعباسي.(5)
لقد كانت النتيجةُ الطبيعية لذلك أن تَعَاملَ النقدُ (خاصة المحافظَ منه) بشكل فاتر مع الظاهرة، بل ناوءَها في كثير من الأحيان. تجلى ذلك واضحا في مسار الكتابتين الإبداعية والنقدية؛ ففي الوقت الذي بدأت الأولى تعرف تراكما كميا، بلغَ أوجَه خلالَ التسعينيات، كان النقد مشغولا بصراع القطبين، أعني: تلقيَ الأقوال والردَّ على الأقوال، فبقيت مسألتا هويةِ النص واستقلاليتِه هما الشغلَ الشاغل لنقد الدوريات والمجلات والجرائد، لنقل إنه كان نقدا خارج النص.
وانسجاما مع ما طرحناه، وقبل التدرج في بسط هذا الإشكال النظري بغية مقاربة سؤال المنطلق، لا بد من تسجيل ملاحظات تساعدنا على هذا التدرج المتأني. فإذا بات من المؤكد أن قصيدة النثر تشكل الآن ظاهرة أدبية، فلمَ لا تُحددَ معالمها بشكل واضح، شأنها شأن كل الظواهر بمفهومها العام؟
تجيبنا الساحةُ النقدية عن هذا السؤال، بمعنى يجيبنا عنه غياب تراكم نقدي مواز، قادرٍ على منح النص ذاتيتَه من خلال تجريد ذلك التراكم إلى مفاهيمَ، تضع قصيدة النثر موضعها الجمالي والفني والأدبي الذي يضيق عليها، ولا يتسع لأكثر منها.
ما العمل على ضوء كل هذا؟
هل نكتفي بما تم استيراده من مفاهيمَ للدخول إلى أغوار النص بلغته الجديدة؟
ثمة إشكال يفرض نفسه بقوة، ويتمثل في أن تلك المفاهيم هي وليدة مقروء ينتمي إلى حقل ثقافي آخر، له شروطه وملابساته التاريخيةُ والفلسفيةُ والجمالية. كما أن هذا " المستوردَ " سيتم استنزافُ جوهرِه؛ إذ يتحول من نتيجة إلى فرضية. علما بأن الفرق كبير بين التصورين، مما يرجئ الحديث عن قراءة بمفاهيمَ، لا يمكن اعتبارها إلا قوالب جاهزة تقتل النص أكثر من أنها تحييه. ويرى فيها البعض اغترابَ الناقد " الثقافي والمعرفي بعد أن امتلأ بمعطيات فكر فلسفي ونقدي وصلته ثماره من دون أن يتأمل مكوناتِه وأنساقَ تعبيره عن إبداعاته في بيئاته".(6)
وتجاوزا للسجال الأنواعي الطويل الذي وسم نص قصيدة النثر، والذي تعتبر هذه الورقة غيرَ ملزمَة بالإشارة إليه، ونعني بذلك المفهوم المضاف إلى القصيدة وهو " النثر"؛ نطرح السؤال:
ألا يمكن أن نقرأ القصيدة على ضوء مفاهيم النثر باعتبارها قصيدةً له؟ يَزُجُّ بنا هذا السؤال في خندق السؤال الأنواعي الكلاسي " شعر- نثر"، هذا على الرغم من محاولات تجاوز هذه الثنائية فيما أصبح يسمى بالأجناس العابرة، حيثُ يمكن للظاهرة الأدبية أن تشتغل بحرية وطلاقة، داخل فضاء نص واحد، دونما قلق السؤال حول النوع.
ولنفترض أننا نفكر في مغامرة من هذا النوع فإن أسئلة جمة تعترضنا: فإذا كانت القصيدة العربية الكلاسية وحتى قصيدة التفعيلة - مع فروقات لا تخفى - قد استساغت مفهوم الإيقاع- الوزن لتقييم شعرية النص، وأصبح بذلك هذا المفهوم يشكل البوابة التي عبرها يتم المرور إلى المفاهيم الشعرية الأخرى؛ فما هو مقابل هذا المفهوم/البوابةِ في النثر الذي تَعْبُر عبره المفاهيم الأخرى؟ هل يمكن أن يكون السردَ مثلا ؟ وكيف يمكن أن يشتغل في الشعر؟ بالترويض أو بإلباسه زيا يتخفى فيه، أو بمنحه فهما جديدا مخالفا لما هو عليه في النثر ؟ غير أن المخاوف هي أن تعيد التجربة الشعرية العربية تاريخها في عصر ما بعد السكاكي، حين ظهرتْ " أنواع من تراكيب الكلام لا تحمل أي معنى، ولكنها تُقرأ وتُسمع على أن لها معنى".(7)، بحيث " أصبح جرس الكلام يقوم مقام المعنى".(8). أليست هذه هي المخاوف التي تؤرق النقد بخصوص قصيدة النثر؟ خاصة وأن منظريها الأوائلَ انتبهوا – هم أنفسُهم - إلى الأمر، حين اعتبروا بعض النصوص التي نشرت في مجلة شعر نفسها نصوصا لا تحمل أي معنى.
مغامرة القراءة بناء على هذا الطرح غيرَ آمنة!
نقرأ إذاً قصيدة النثر بناء على تحديدها( متجاوزين الإشكال الذي يطرحه هذا التحديد كما تشكل في الحقل الشعري الفرنسي(poème en prose)، (9). بعبارة أخرى نزوج مفاهيمَ الجنسين لإنجاب مصطلحات قصيدِ- نثرية، ولكن أيةُ هذه المفاهيمِ العريسُ وأيةُ تلكَ الأخرى العروسُ؟
لا غرابة في إدراج هذا النوع من الخطاب، خاصة حين نسمع من أحدهم يصف قصيدة النثر بالخنثى! (10)
ألا تزج بنا هذه الإشكالات في المتاهة التي لم يخرج منها قطبا النقد المناوئ والمناصر؟ المتاهةِ التي أفضت إلى بدائل تلفيقيةٍ تحاول خندقةَ النص وإن بمرجعية جنسية لا أجناسية (خنثى). متاهة ناتجة عن تيه نقدي منبهر بالنظريات الغربية، عاجزٍ عن تطوير نظرية نقدية عربية بديلة منبثقة من مساءلة التراث الثقافي العربي، والعملِ على تطوير الكوني فيه، وتجاوز المشروط بالظرف الثقافي والتاريخي والجمالي؛ نظريةٍ قد تعيد إلى النص سلطته، وتجعله منطلق البحث لا فأر تجارب.(11).
ما هي قصيدة النثر التي نود أن نقرأها؟ وما المفاهيم التي ينبغي أن تقرأ على ضوئها؟
هل نكتفي بخلاصة سوزان بيرنار كما نقلتها حركة " مجلة شعر" ؟ وأعني بذلك مفاهيم الإيجاز والتوهج والمجانية، وما يرتبط بها، هذا مع تحفظنا من كون تلك المفاهيم قادرة الآن على قراءة القصيدة في تمظهراتها الحالية، بالنظر إلى كثرة التجارب، وتطورها، واتساعها..؟
أم هي تلك البديل الناتج عن منح أجنبي إقامةً عربية؟
انسجاما مع زاوية رؤيا هذه الورقة، فلا الوصفة الأولى ولا الثانية قادرتين على قراءة شاملة لنص قصيدة النثر. ولكن ما القول في المحاولات المتعددةِ التي اشتغلت على بنياتِ النص الداخليةِ اللغوية والأسلوبية والدلالية والإيقاعية ؟
نصنف تلك المحاولات إلى:
أولى: باحثة في النص عن المفاهيم، وثانية مجتهدة في فتح الطريق أمام مفاهيم لتعبر من جنس إلى جنس ومن نوع إلى ثانٍ، ومن حقل إلى آخر. ولكن ما علينا إلا أن ننوه بالمنطلق العلمي لتلك المحاولات، والذي نرى فيه خروجا عن السجال النقدي العقيم. ونرى في هذا المنطلق من جهة أخرى، مسعى محمودا لتهيئ الساحة لنقد تجريدي قادر على صياغة مبادئَ عامةٍ حيوية تحدد ماهيتها في حقل الشعرية العربية الحديثة.
ولا ضير إن نحن عرضنا – على سبيل التمثيل فقط – لبعض تلك الدراسات الحديثة جدا، والتي اشتغلت على البنيات النصية في قصيدة النثر. وحتى لا يصبح مركز هذه المداخلة قراءة للمنتج النقدي فقد اخترنا – بناء على دعوانا السابقة – نموذجين من الدراسات:
الأولى: اعتمدت بشكل كبير على المفاهيم التي سبقت إنتاج قصيدة النثر في الحقل الشعري العربي الحديث.
الثانية: سعت إلى أن تدخل عالم النص من خلال تعديلات مفهومية.
غايتنا من ذلك الخروج بملاحظات قد تبرر المنهج الذي نتعامل به مع النص الذي بين أيدينا: «بياض الحروف».
الدراسة الأولى: تحمل عنوان: « قصيدة النثر العربية: الأسس النظرية والبنيات النصية». وهي للدكتور عبد القادر الغزالي، في طبعتها الأولى سنة 2007. صادرة عن مطبعة تريفة بمدينة بركان المغربية.
أما البحث الثاني فهو عبارة عن رسالة الدكتوراه للأستاذ الدكتور عبد الرحمان عبد السلام بعنوان « السرد الشعري وشعرية ما بعد الحداثة. قراءة في «مهمل...تستدلون عليه بظل للشاعر علاء عبد الهادي».
* تتضمن الدراسة الأولى قسمين:
- القسم الأول: خاص بالأسس النظرية في فصلين:
الفصل الأول: " قصيدة النثر ورهانات الحداثة. الفصل الثاني: " الشعريات الحديثة وأوضاع قصيدة النثر"
- القسم الثاني: (الجانب التطبيقي) فيتضمن ثلاثة فصول:
الفصل الأول: " المتن الشعري"، التحدد الإجرائي والمكونات النصية.
الفصل الثاني: " البنيات الإيقاعية ".
الفصل الثالث: عنونه الباحث ب " المتخيل الشعري" عند كل من توفيق صايغ، ومحمد الماغوط، وسركون بولص، وأنسي الحاج.
وقد اختار الدارس ثلاثة نصوص ( دواوين) لكل واحد منهم.
يحدد الباحث في المقدمة( من صفحتين) المنهج الذي ينطلق منه، في " محاولة اكتشاف الأسس النظرية والبنيات النصية في قصيدة النثر العربية، (و) هو شعرية الإيقاع التي يدافع عنها الشاعري هنري ميشونيك، والقائمةُ على وضع التاريخية والذاتية والمجتمعِ موضعَ اعتبار".(12). في بداية الفصل الأول من القسم الأول يحدد الباحث فرضية المنطلق، يقول عنها: " الفرضية الأساس التي ننطلق منها، في هذا المقام، هي أن قصيدة النثر أو الشعرَ الخارجَ عن الوزن التقليدي، قد انبثقت من صلب التجارب الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة بخاصة ".(13).
ولنا أن نسجل ملاحظتين: تتعلق الأولى بالبنية المفهومية والثانية بالفرضية، فالبنية المفهومية مبنية على ما توصل إليه هنري ميشونيك بخصوص شعرية الإيقاع، ومن تم نفهم أن زاوية اشتغال الدراسة محدودة، وأن الرؤية تتم نحو هدف ميكرومتري، في مقابل رحابة فضاء الشعر موضوع الرؤية. وربما سقطت مجموعة " مجلة شعر" في الإشكال نفسه، حين حبست الرؤيةَ الجديدة في مقترحات سوزان برنار.
الملاحظة الثانية هي العقم الذي حل بخاتمة الدراسة المقترحة(ثلاث صفحات)، بحيث جاء محتواها عبارة عن أحكام عامة، وأقوال لا تدخل إلا ضمن تحصيل الحاصل، في حين أن المتوقع من دراسة من هذا الحجم(538 صفحة)، هو الخروج بخاتمة تركيبية تتضمن استنتاجات، ورؤى، وإضاءات، ونحتا لمفاهيم جديدة تضيء للقارئ بعض جوانب هذه الكتابة الجديدة في الشعر. ويمكن أن نقرب المهتم من دعوانا هذه. فنقرأ في بداية الخاتمة: " قصيدة النثر العربية كتابة شعرية لها تاريخها الذي أفرز من خلال التجارب المتنوعة قضايا وإشكالات، لم تكن معهودة ".(14) ورغم هلامية هذا الكلام، فقد كان أفقنا ينتظر تحديد طبيعة هذه الإشكالات، إلا أن الباحث يستطرد بقوله: " فقد أشرعت أبواب الكتابة على مصاريعها، بعد المحاولات الجريئة، التي حولت من خلال المنجز النصي ممارسة تاريخية شعرية عربية، حكمت تطورها الداخلي قوانين ومعايير أصبحت بدهيات لا يمكن تجاوزها، إلى حقل من حقول الصراع بغية التجديد وتأسيس الإبداع المغاير النابع من روح العصر، وجوهر المعاناة الإنسانية". ثم يأتي في مرحلة متقدمة ليصرح بأن قصيدة النثر: " استفادت من جميع مصوغات التجديد الشعري، ولم تقف عند هذا الحد بل دفعت بها جميعها إلى منتهاها ضمن مراجعة جذرية ونقد عميق للأصول ".(15).
لقد عادت بنا الدراسة إلى النقطة الصفر، ونحن بين يدي الصفحة الأخيرة من الكتاب: كيف نفسر أن لقصيدة النثر " معايير أصبحت بدهيات لا يمكن تجاوزها " في الوقت الذي أصبحتْ فيه هذه القصيدة تتجه نحو " التجديد وتأسيس الإبداع المغاير..." ؟
ألا تقف البدهيات ضد التجديد؟
الحقيقة أننا لا نرغب في أن نزج بهذه الورقة في مناقشة من هذا النوع، ولكن نود من هذه الوقفة أن ننبه إلى أن القسم النظري من الدراسة (اثنان وعشرون صفحة لـ" المدخل" ومائة وثمان وخمسونصفحةً للقسم الأول الخاص بالأسس النظرية)، استوفى المقول النقدي ببنيته المفاهيمية التي أُسقطت على المتن الشعري المدروس. ورغم بعض الأقوال من قبيل: " ذلك هو مسار القراءة الشعرية المقترحة في هذه الدراسة، لا ضمن المقولات والمفاهيم الجاهزة، ولكن ضمن انفتاح، ننظر فيه إلى المكونات النصية نظرة تفاعلية" إلا أن المنهج المعتمد في القراءة يخالف هذه الدعوى. إذ جاءت القراءة التطبيقية وصفيةً إحصائية، والخاتمة لم تجمل الخطوط العريضة التي تتقاطع وتلتقي فيها التجارب المدروسة: المنتجُ النصي.
* الدراسة الثانية:
يقسمها صاحبها إلى قسمين: يتضمن الأول المفهومات المؤطرة للاشتغال، يطرح فيه بدايةً الإشكالاتِ المتعلقةَ بسؤال النوع أو الكتابة الأجناسية، ثم يتناول مفهوم الكتابة و" النص الفضاء"، لينتقل بعدها إلى نص المهمل لتحديد مفهوم الشعر من خلاله، وفي الفقرة الرابعة يعالج مفهومَ السرد وأهميتَه، ثم يختم هذا القسم بتناول مفهوم السرد الشعري. أما القسم الثاني فقد خصصه للجانب التطبيقي، متناولا نص المهمل من سبع زوايا هي ( المتن، البنية السردية، الكتابة المشهدية، مدونة الشعر، البنية المُهملية، السرد الشعري وتوظيف الشخصية، السرد الشعري ووجهة النظر).
يبدأ الدارس بتسجيل ملاحظة جعل منها منطلقا يوجه مسار البحث، مفادها أن: " كل نوع أدبي قابلٌ للانفتاح، أو بعبارة أخرى للعبور والانصهار في كتابة ذات أفضية أجناسية طليقة ما دامت تصنعها شروطها التاريخية والثقافية والجمالية في الإبداع والتلقي".(16). ثم يتدرج الباحث في غزل نسيجه النظري وصولا إلى استنتاج، يتفق فيه مع رنيه ويليك، مفاده أن " التمييز بين الأنواع الأدبية لم يعد ذا أهمية في كتابات معظم كتاب عصرنا ".(17)، ويدعم الباحث هذا الطرح - أخذا عن رولان بارت - بأن كل ما نستطيعه أمام النص هو تفجيره، ويرتبط بهذا التصور عنده مفهومُ الفضاء من منظور أنه إذا " كان النص لغة فإن الفضاء هو تفعيلُ هذه اللغة في حيازته حين يتم تشكيلها".(18). وبالطبع كان على الباحث ألا يغفل – في هذا الصدد –دور القارئ فيما سماه تعطيلَ البعد الاستهلاكي وتفعيلَ البعد الإنتاجي. ويرى أنه ما دام أن " قيمة اللاشيء تمنح الشيء قيمته " فإن الفراغ والبياض في النص لهما دلالتاهما، بمعنى أنه بهما يتحدد السواد( المتن).
ينتقل الباحث، بعد ذلك، إلى تحديد دلالة السرد باعتباره أداة للاشتغال. وبالطبع، وقبل أن يتحول إلى أداة، عليه أولا أن يكون موضوعا تستوجب دلالتُه التحديد. يحددها الباحث كما يلي: السرد " إنتاج حكاية، سرد مجموعة من المواقف والأحداث"، ويستدعي بعد هذا التعريف مقولة پروپ في السرد القائمة على الوظائف التي تنهض بها الشخصيات، ثم يدعم هذا التصور باستدعاء بارت مرة أخرى في قولته المشهورة عن السرد: " إنه موجود في كل مكان تماما كالحياة".
بعبارة أخرى كيف يمكن أن يكون السرد في النثر دون أن يكون في الشعر؟ وبعبارة أعمق لمَ لا يلتقي الشعر والنثر في نص أدبي..ليكن هو قصيدة النثر.
بهذه الخلاصة المفترضة، علينا أن نتحدث عن سرد شعري. فما هو؟
بعد معالجة مستفيضة انطلقت من التعالق بين مكونَيِ العنوان، يصل بنا الباحث إلى خلاصة مفادها أن " السرد خطاب ذو فرادة في هويته يتمايز بها عن أغياره من خطابات الأدب، كما أن الشعر خطاب له هويته التي تميزه عن أغياره من الأدب" ، ومن تم يستنتج ما أسماه بلحظة تقاطع بين السرد والشعر، مدعما ذلك بملاحظته حول ما عرفه سرد ما بعد الحداثة من تجاوز التلازم الزمني والمنطقي، وهو – كما يقول الباحث- ما تقوم به الوظيفة الشعرية. ورغم ما يثيره هذا التصور من قلق حول كيفية تقارب الوظيفتين السردية والشعرية؛ إلا أن إضفاء صفة تجريدية أكثر على مفهوم السرد، يدفعنا إلى تتبع الباحث في طرحه النظري، إلى أن يصل بنا إلى مفهوم " الكتلة النصية "، معتبرا إياها(الباحث) إطارا لاشتغال الوظيفتين. وهذه هي وظيفة ما أسماه بالغلالة الشعرية الشفيفة، القادرة على أن تسبغ على السرد وظيفة شعرية، غير أن هذا – حسب رأيه - لا يتأتى في الجمالية اللسانية من تراكيب ونحو ودلالة ومعجم، بل في جمالية الخطاب في كليته وانتشاره في جزئيات العمل الشعري. ولتعزيز هذا الطرح يحيل على كتاب " مدخل لدراسة النص والسلطة لعمر أوكان في مقولة أن: " ..الحدود بين الجملة الشعرية والجملة النثرية غائمة وستظل لعبة في يد الشعراء العظماء القادرين على تحويل ما يسمى بالنثر/اللاشعري إلى الشعر".
وما دام الأمر يتعلق بالسرد، فإن المفاهيمَ المرتبطةَ به، وجب أن تلبس حلة جديدة، تتناسب مع الوظيفة الجديدة، (الشخصيات، الزمكانية، وجهة النظر، التبئير، زاوية الرؤية ونوعها، تدخل المؤلف، العجائبي، المخاطِب والمخاطَب..) الخ.
وبالضبط هذا ما لا ينبغي أن تجهله هذه الدراسة، وهو ما تم بالفعل. فقد اشتغلت هذه المفاهيم داخل النص الشعري بحلتها الجديدة. فالشخصية - على سبيل تقريب الصورة - في السرد ليست كما هي في الشعر، هنا قد تكون عنصرا طبيعيا حيا أو جامدا، وقد تكون مجرد فكرة. وبحسب تعبير الباحث، أخذا عن غريماس: " تصبح الشخصية مجرد دور ما يُؤَدَّى في الحكي بغض النظر عمن يؤديه".(19).
نحن الآن بصدد مفاهيم عابرة، وفي عبورها إلى محجها عليها أن تلبس زي " الإحرام الشعري"..إنه التجريد؛ ليس تجريدَ المفهوم من وظيفته وإلباسَه وظيفةً أخرى، بل تجريدَ الوظيفة إلى الحد الذي يمكن أن تُحْدِثَ تغييرا في تصورنا التقليدي للمفهوم ذاته.
بعد تثبيت الإطار المرجعي، يلج الباحث عالم النص من زاوية واحدة هي: " السرد الشعري"، مستعيرا مفاهيم السرد للاشتغال، ثم ينهي دراسته بخاتمة. فالهوامشِ والإحالات.
كانت غايتنا من هذه الإطلالة أن نكشف عن طريقتين(منهجين) في التعامل مع الأثر الأدبي( قصيدة النثر هنا)، والنتيجةِ التي تفضي إليها كل طريقة على حده.
فدراسة عبد القادر الغزالي أخضعت النص قسرا إلى بنية من المفاهيم- إن كانت تشكل بنية- استدللنا على ذلك بالخاتمة التي جاءت عبارة عن تحصيل حاصل لمقولات الإطار النظري. في حين أن الدراسة الثانية بنتْ مرجعيتها على ما يوفره النص من إمكانات. وقد نفهم من هذا أن كلتا الدراستين انبنتا على مفاهيم مؤطرة، إلا أن الأمر خلافُ ذلك. فالأولى استعارت مفاهيمها من مرجعية شعرية لتشتغل بها في مرجعية شعرية أخرى. في حين أن الثانية استقت مفاهيمها من جنس غير الشعر لتشتغل بها في الشعر. مفاد ذلك – وبالنظر إلى الإشكال الأنواعي- فالدراسة الأولى بحثت عن تجسد المفهوم في النص، وإن اقتضى الأمر منحه جوازَ سفر مزور. أما الثانية فقد اختبرت المفهوم في النص، وقد نجحت – إلى حد ما - في الاختبار لأنها بدأت أولا بتحويل أداة الاشتغال إلى موضوع، يعاد تحديده والكشف فيه عن الجوانب الميتافيزيقية التي تمكنه من الاتساع والامتداد ليكون أعم من مقولتي " الأنواعي " أو " الأجناسي ". لذا جاءت الخاتمة لتقتنص غنم السفر - على حد تعبير صاحبها – أي جاءت لتكثف كيفية انكتاب نص المهمل، ليس كقصيدة نثر، بل كشكل من أشكال قصيدة النثر.
تبلغ هذه المقدمة غايتها، وهي الاختيار المنهجي. فبناء على ما كشفنا أعلاه، لا يمكن أن نقرأ النص إلا من خلال ما يتيحه لنا من إمكانات. نقرؤه عبر السلطة التي تفرضها علينا حدوده، نقرأ ما يقدم لنا لا ما ينبغي أن يكون عليه: فما ينبغي أن يكون إما حلم الإبداع، وإما خلل في نقد الإبداع. وليس مسعى التأطير - بهذا المنظور الذي طرحناه- سجنا أو حدا من الحرية، بل مسعاه خلقُ المبدع القادر على خلخلة وإعادة تركيب ما ينتظم داخل الإطار، لفتح فجوات تتنفس منها اللغة ريحا جديدة، بها تتشكل في حلة جديدة.
ثانيا: بياض الحروف
1- ذلك النص.
" بياض الحروف" ديوان شعر، للشاعر عبد الرزاق جبران، صدر عن منشورات أجراس- دار القرويين سنة 2006. الافتتاحية بإهداء إلى العائلة، والختام بالفهرست. الديوان في أربعة أقسام موزعة على 131 صفحة:
القسم الأول: أناشيد العتمة، من ست عشرة قصيدة.
القسم الثاني:احتفاء بالجسد، من تسع عشرة قصيدة.
القسم الثالث: نشيد الهواجس، من اثنتي عشرة قصيدة.
القسم الرابع: نمنمات: من عشرين قصيدة.
تتوزع القصائدُ بخصوص فضاء النص ما بين جزء صغير من الصفحة (نسميها ومضة) وخمسِ صفحات. عدد الومضات ستَّ عشرةَ موزعة على الشكل التالي:
من القسم الثاني قصيدتا " امرأة "، و" موت " ص: 60 و 70 على التوالي.
من القسم الثالث: قصائد: " موجة ص: 71، رمل ص: 72، حلم ص: 73، فيء الكلام ص: 74، حروف ص: 75، ريبة ص: 76، شعراء ص: 77، علم ص: 78، هاوية، ص: 79
من القسم الثالث: قصائد: تقرير ص: 105( وهي أقصر قصيدة في الديوان- ثلاثة أسطر)، الشاعر ص: 105، فحولة ص: 107، حنين ص: 108 غياب ص: 113.
هذا وأنوه إلى أن هذه العملية الوصفية الإحصائية غايتها تقريب صورة تشكل الديوان، لا توظيفها فيما تتغياه هذه الورقة.
نخصص الفصل الأول – في قراءتنا لنص " بياض الحروف " لمفهوم الشعر، ونتناول في فصل لاحق مفهوم " الحلم"، أما الفصل الثالث فنشتغل فيه على مفهوم " العشق، في حين يتطرق الفصل ما قبل الأخير إلى بنية النص اللغوية والإيقاعية وعلاقاتها بالدلالات المدروسة أعلاه، أما الفصل الأخير فنخصصه لتركيب المعطيات أعلاه، والخروج باستنتاجات بناء على ما وفره لنا النص. وفي كل فصل نحدد طريقة اشتغالنا وفق المنهج الذي تبنيناه أعلاه.
وأما بخصوص مفهوم " الشعر" فنستعين على مقاربته بالتطرق إلى المفاهيم التالية:
*اللغة الشعرية.
* القصيدة.
* الشاعر.
* اللحظة الشعرية.
ج- فيما يتعلق بمفهوم القصيدة، وقفنا على أنها تلك العلاقة القائمة على تداخل البياض والسواد، وهي تجسيد حسي للحظة تتناغم فيها الأفكار والتصورات في ذهن الشاعر وروحه، أو قل هي تجسيد حسي لتلك اللحظة.
د- أما مفهوم الشاعر - مركزين هنا على المقاطع الشعرية التي تحيل عليه كمفهوم لا كذات- فقد وقفنا على صورة النبوة أو الولاية فيه. وأن المشترك بينهما هو الفضيلة من جهة، وتمسك الشاعر بالقضية من جهة ثانية، نضيف إليهما عنصرين آخرين هما بمثابة نتيجة معانقة التجربة، ونعني بذلك: الضياع والألم.
إحالات وهوامش الفصل الأول
الأستاذة نجية يوسف
[frame="6 10"]
قراءة في كتيب الأستاذ حسين ليشوري [ جراحة الأفكار بين المدارسة والممارسة ، غير أني لم أجد للأستاذ سيرة ذاتية هنا في الملتقى لأشفع بها بحثي هذا وكل ما لدي الآن صورته التي تكرّم علينا بوضعها في الملتقى .
هذا والله وليّ التوفيق
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كل عامٍ وأنتم بألف خير
تم بعون الله على مدى عشرين يومًا
استقبال المشاركات في مسابقة قراءة في كتاب
لشهر آب (أوغسطس ) 2010 م
وقد شارك كل من الأخ الأستاذ المعطاوي المصطفى
وقدّم لنا مشاركة بعنوان:
* تشكل العوالم في قصيدة النثر العربية
نموذج: ديوان " بياض الحروف "
للشاعر عبد الرزاق جبران**
و الأخت الأستاذة نجية يوسف وقدّمت لنا مشاركة بعنوان :
قراءة في كُتيّب جراحة الأفكار بين المدارسة و الممارسة ( مقدمة في التغيير السلمي)
للأستاذ الفاضل حسين ليشوري
أرجو من جميع المارّين على هذا المتصفح ابتداءً من اليوم وحتى نهاية هذا الشهرالتصويت على المشاركة والقراءة الأفضل
حتى نستطيع تقليد صاحبها
وسام القراءة والمطالعة لشهر آب (أوغسطس) 2010
ننتظركم
شكرًا لكم
تقديري ومحبتي
رئيس ملتقى القراءة والمطالعة
ركاد حسن خليل
المشاركة الأولى
للأستاذ المعطاوي المصطفى
[frame="7 10"]
* تشكل العوالم في
قصيدة النثر العربية
نموذج: ديوان " بياض الحروف "
للشاعر عبد الرزاق جبران**
قصيدة النثر العربية
نموذج: ديوان " بياض الحروف "
للشاعر عبد الرزاق جبران**
* المبحث الأول
نود في البداية أن نطرح سؤالا، نعتقد أن له ما يبرره تاريخا ومنهجا.
على أية مفاهيمَ شعريةٍ نقرأ قصيدة النثر؟
وطرْحُنا لهذا السؤالِ مبنيٌّ على نقطتين:
الأولى: تتعلق بالقول الشعري عامة، كونِه " يعتمد على نظام إشاري يختلف عن النظام الذي يستخدمه المتكلم عامة أو حتى الشاعر نفسُه في حياته اليومية، ويقوم هذا النظامُ على مصاحبات وتقابلات غيرِ متوقعةٍ تجمعها وحدةٌ متجانسة تختلف عن الوحدة التي تجمع لغة الكتابة النثرية ".(1)
الثانية: أن قصيدة النثر العربيةَ لا زالت منذ إعلان ميلادها على يد حركة " مجلة شعر" التي أسسها يوسفُ الخال سنة 1957 حتى الآن؛ لا زالت لم تعرف الاستقرار، في ظل الصراع بين المؤيدين والمناوئين، حول أصالة انتمائها إلى حقل الشعرية العربية الحديثة.
ونجد أنفسنا في هذه الدعوى مضطرين إلى أن نلقي نظرة - ولو موجزة - عن أشكال التوتر والاضطراب النقدي، التي رافقتْ ظهور هذه القصيدة. ومناقشةُ هذه المسألة ليست غاية في ذاتها، بل أرضيةً، نحدد بناء على الإشكالات التي طرحتها في الساحة النقدية؛ المنهجَ الذي نراه ملائما في قراءة نص " بياض الحروف"، باعتباره ينتمي إلى شكل معين من الكتابة الشعرية من جهة، وباعتباره نصا تحكم إنتاجه التجربة الذاتية، والأصالة الفردية للشاعر، مؤمنين بافتراق المناهج وتعددها وتصارعها في جدل اتسع واحتد حتى أصبح من خصائص عصرنا هذا.(2)وطرْحُنا لهذا السؤالِ مبنيٌّ على نقطتين:
الأولى: تتعلق بالقول الشعري عامة، كونِه " يعتمد على نظام إشاري يختلف عن النظام الذي يستخدمه المتكلم عامة أو حتى الشاعر نفسُه في حياته اليومية، ويقوم هذا النظامُ على مصاحبات وتقابلات غيرِ متوقعةٍ تجمعها وحدةٌ متجانسة تختلف عن الوحدة التي تجمع لغة الكتابة النثرية ".(1)
الثانية: أن قصيدة النثر العربيةَ لا زالت منذ إعلان ميلادها على يد حركة " مجلة شعر" التي أسسها يوسفُ الخال سنة 1957 حتى الآن؛ لا زالت لم تعرف الاستقرار، في ظل الصراع بين المؤيدين والمناوئين، حول أصالة انتمائها إلى حقل الشعرية العربية الحديثة.
يتفق العديد من الباحثين حول تأكيد المخاض الذي ظهرت فيه قصيدةُ النثر العربيةُ؛ المخاضِ الذي تجسدَ في المناوءة الشديدة، من طرف أنصار " شعر التفعيلة ". غير أنه لا يعني ذلك أن هذا الأخير لم يعش الحالةَ نفسَها مع المحافظين الأُوَّلِ، بل العكس من ذلك تماما، إلا أن ما يثير الانتباه هو أن فكرتَه انبثقت من الدعوة إلى نمط جديد من الكتابة، يتجاوز الظاهرةَ الكلاسيةَ ويتوجه نحو تحديثها، إنه التحديث نفسه الذي رامته قصيدة النثر، وقام أنصار" شعر التفعيلة " في وجهه؛ فكان من الطبيعي أن يتحولوا - في نظر الخصوم – إلى محافظين جددا.
في سنة 1959 أي بعد سنتين من صدور مجلة " شعر"، أصدرت دارُها دواوينَ " حزن في ضوء القمر" و " تموز في المدينة" و " لن"، وهي على التوالي لكل من محمد الماغوط، وجبرا إبراهيم جبرا، وأنسي الحاج. ونشرت لشعراء آخرين انضموا إلى خطاب المجلة، كتوفيق صايغ وشوقي أبي شقرا..واللائحة. وكان من حسن حظ المجلة، أنها ضمت من بين أنصار دعواها صوتا هادئا، ودما باردا، ينفث في حقل الشعرية العربية الحديثة المفاهيمَ الجديدةَ لقصيدة النثر، وللشعر عموما بحنكة وذكاء. ونعني بذلك أدونيس.
وفي هذا الصدد، وجبَت الإشارة إلى الهجوم العنيف الذي شنته نازك الملائكة – وهي أكبر منظرة لشعر التفعيلة – على ديوان خزامى صبري (ظلِّ )خالدة سعيد سنة 1962، وهو الهجوم الذي رد عليه يوسف الخال ووصف صاحبته :" ارتدادية متزمتة خانت حركة الشعر الحر التي تدعي المؤلفة اكتشافه..".(3)
ظهرت قصيدة النثر – إذن - في جو من الصراع بين حركتين تجديديتين في الشعر العربي الحديث، وتركز الخلاف بينهما حول عنصر " الإيقاع": ففيما احتفظ به شعر التفعيلة على شكل وزن عروضي منساب على غير نظام الشطرين، ولكن وفق ضوابطَ معروفة؛ جاءت قصيدة النثر بدعواها إلى " تطوير الإيقاع الشعري العربي وصقلِه على ضوء المضامين الجديدة " وأنه ليس " للأوزان التقليدية أيةُ قداسة " كما عبر عن ذلك يوسف الخال، أكبرُ الدعاة في حركة مجلة شعر. وبلهجة شديدة نقرأ من الصفحة الثانية عشرةَ في مقدمة ديوانه " لن" أن: " موسيقى الوزنِ والقافيةِ موسيقى خارجية ثم إنها مهما أمعنتَ التعمق تبقى متصفة بهذه الصفة: إنها قالب صالح لشاعر كان يصلح لها وكان في عالم يناسبها وتناسبه".
كانت الحركتان " الوليدة" و" اليافعة " على خط تماس كهربي، أفضى إلى تلك الشرارة التي لا زالت لم تنطفئ بعد، - وإن خفَّ ضجيجها - في الحقل النقدي العربي بين المتحفظين والمناصرين.
ورغم أن فترة التسعينيات شهدت ثراء على مستوى هذا النمط من الكتابة( أقصد قصيدة النثر)، إلا أنها - في الوقت نفسه - شهدت سجالا أكبرَ، حول الإشكال الأنواعي، وأضافت شرارةً زائدةً على هذا السجال، المجلاتُ الأدبيةُ التي احتضنتِ العديدَ من أقلام قصيدة النثر إبداعا ونقدا.
لكن هل يكفي أن نتخذ من هذا الصراع بين الحركتين، مبررا لتفسير الأزمة التي عاشتها وتعيشها قصيدة النثر، خاصة على المستوى النقدي؟
أعتقدُ أن المسألة تتعدى ذلك إلى ما هو منهجي، ضاعفَ تحفظ النقاد من قصيدة النثر، ومن تم قلةُ الدراسات التي تناولت النص من داخله، واستكناهه كظاهرة إبداعية، في أفق تجريد مفاهيمه ومصطلحاته وأدوات اشتغاله. فإذا ما نظرنا إلى تاريخ الميلاد، نرى أن المنظرين الأوائلَ وأقصد هنا حركة مجلة " شعر"، استقوا مفاهيم قصيدة النثر من خارج النص. بحيث لم تكن الساحة الشعرية العربية آنذاك تحفل بتراكمات نصيةٍ قادرةٍ على بلورة المفاهيم، ومنحِ المشروعية الثقافية والفنية للوليد الجديد. لم تعتمد الحركة – كما هو معلوم - على استقراء الأثر الأدبي، كما فعل مثلا الخليل بن أحمد في أوزان الشعر العربي، أو كما فعل المرزوقي في عمود الشعر، بل تم استيراد المفاهيم التي كانت نتيجةً لاستقراء الظاهرة في الأدب الغربي، وبالضبط وصفةَ سوزان برنار في كتابها الشهير " قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا". منهجيا فالسابق هو الظاهرة واللاحقُ عليها قاعدتُها، وهو الأمر الذي لم تتفطن إليه الحركة أو تجاهلته، إذ النوع – متفقين مع من سبقونا إلى هذا الرأي - لا يتحدد إلا بما ليس واردا في الأنواع الأخرى، وهذا يقتضي تراكما نصيا على مستوى الإبداع الشعري.
وزاد الطين بلة أن الحركة لم تسلك - أثناء البحث عن موطإ قدم للدعوة الجديدة - مسلكَ حركة شعر التفعيلة، التي ربطت ظهور الكتابة الشعرية الجديدة بالتراث، ولم تسعَ- كما اتجهت إليه حركة التفعيلة- إلى أن تُفْهِمَ الذائقة الشعرية العربية، أن الأمر يتعلق بتجديد وتطوير وليس بتجاوز وإلغاء..وكان من المتاح أن تدعم طرحها بفكرة أنه " ابتداء من القرن الرابع، كان السعي لتقريب الشقة بين النثر والشعر:( بحيث) صار الشكلان يعالجان الأغراض نفسها ويستجيران بالمحسنات نفسها".(4)
حرفيا تم استنساخ مفاهيم قصيدة النثر. ولما تعددتِ الأصواتُ منبهةً إلى هذا الخلل المنهجي، عمد رواد الحركة، ومن والاهم من بعد، إلى البحث عن حلول للخروج من الإشكال، وذلك بالسعي إلى منح تلك المفاهيمِ إقامتَها العربية، إلا أنها كانت في كل مرة تسقط في مآزقَ ومغالطاتٍ، دفعتها إلى المغامرة في اقتراح " البديل"، خاصة حين اصطدمت بالثابت في كتابة الشعر العربي وتلقيه وهو " الإيقاع "، أو الوزن العروضي.
لقد تأزم فعلا وضع قصيدة النثر، حين وضعها منظروها وسطا بين مطرقة المنهج وسندان الثقافة؛ خللٍ في التنظير والقطيعة مع الأصول، هذا رغم محاولات أدونيسَ إفهامَ الذائقة الشعرية العربية الحديثة، أن قصيدةَ النثر تنتمي إلى حداثة عربية، تعود أصولها إلى العصرين الأموي والعباسي.(5)
لقد كانت النتيجةُ الطبيعية لذلك أن تَعَاملَ النقدُ (خاصة المحافظَ منه) بشكل فاتر مع الظاهرة، بل ناوءَها في كثير من الأحيان. تجلى ذلك واضحا في مسار الكتابتين الإبداعية والنقدية؛ ففي الوقت الذي بدأت الأولى تعرف تراكما كميا، بلغَ أوجَه خلالَ التسعينيات، كان النقد مشغولا بصراع القطبين، أعني: تلقيَ الأقوال والردَّ على الأقوال، فبقيت مسألتا هويةِ النص واستقلاليتِه هما الشغلَ الشاغل لنقد الدوريات والمجلات والجرائد، لنقل إنه كان نقدا خارج النص.
وانسجاما مع ما طرحناه، وقبل التدرج في بسط هذا الإشكال النظري بغية مقاربة سؤال المنطلق، لا بد من تسجيل ملاحظات تساعدنا على هذا التدرج المتأني. فإذا بات من المؤكد أن قصيدة النثر تشكل الآن ظاهرة أدبية، فلمَ لا تُحددَ معالمها بشكل واضح، شأنها شأن كل الظواهر بمفهومها العام؟
تجيبنا الساحةُ النقدية عن هذا السؤال، بمعنى يجيبنا عنه غياب تراكم نقدي مواز، قادرٍ على منح النص ذاتيتَه من خلال تجريد ذلك التراكم إلى مفاهيمَ، تضع قصيدة النثر موضعها الجمالي والفني والأدبي الذي يضيق عليها، ولا يتسع لأكثر منها.
ما العمل على ضوء كل هذا؟
هل نكتفي بما تم استيراده من مفاهيمَ للدخول إلى أغوار النص بلغته الجديدة؟
ثمة إشكال يفرض نفسه بقوة، ويتمثل في أن تلك المفاهيم هي وليدة مقروء ينتمي إلى حقل ثقافي آخر، له شروطه وملابساته التاريخيةُ والفلسفيةُ والجمالية. كما أن هذا " المستوردَ " سيتم استنزافُ جوهرِه؛ إذ يتحول من نتيجة إلى فرضية. علما بأن الفرق كبير بين التصورين، مما يرجئ الحديث عن قراءة بمفاهيمَ، لا يمكن اعتبارها إلا قوالب جاهزة تقتل النص أكثر من أنها تحييه. ويرى فيها البعض اغترابَ الناقد " الثقافي والمعرفي بعد أن امتلأ بمعطيات فكر فلسفي ونقدي وصلته ثماره من دون أن يتأمل مكوناتِه وأنساقَ تعبيره عن إبداعاته في بيئاته".(6)
وتجاوزا للسجال الأنواعي الطويل الذي وسم نص قصيدة النثر، والذي تعتبر هذه الورقة غيرَ ملزمَة بالإشارة إليه، ونعني بذلك المفهوم المضاف إلى القصيدة وهو " النثر"؛ نطرح السؤال:
ألا يمكن أن نقرأ القصيدة على ضوء مفاهيم النثر باعتبارها قصيدةً له؟ يَزُجُّ بنا هذا السؤال في خندق السؤال الأنواعي الكلاسي " شعر- نثر"، هذا على الرغم من محاولات تجاوز هذه الثنائية فيما أصبح يسمى بالأجناس العابرة، حيثُ يمكن للظاهرة الأدبية أن تشتغل بحرية وطلاقة، داخل فضاء نص واحد، دونما قلق السؤال حول النوع.
ولنفترض أننا نفكر في مغامرة من هذا النوع فإن أسئلة جمة تعترضنا: فإذا كانت القصيدة العربية الكلاسية وحتى قصيدة التفعيلة - مع فروقات لا تخفى - قد استساغت مفهوم الإيقاع- الوزن لتقييم شعرية النص، وأصبح بذلك هذا المفهوم يشكل البوابة التي عبرها يتم المرور إلى المفاهيم الشعرية الأخرى؛ فما هو مقابل هذا المفهوم/البوابةِ في النثر الذي تَعْبُر عبره المفاهيم الأخرى؟ هل يمكن أن يكون السردَ مثلا ؟ وكيف يمكن أن يشتغل في الشعر؟ بالترويض أو بإلباسه زيا يتخفى فيه، أو بمنحه فهما جديدا مخالفا لما هو عليه في النثر ؟ غير أن المخاوف هي أن تعيد التجربة الشعرية العربية تاريخها في عصر ما بعد السكاكي، حين ظهرتْ " أنواع من تراكيب الكلام لا تحمل أي معنى، ولكنها تُقرأ وتُسمع على أن لها معنى".(7)، بحيث " أصبح جرس الكلام يقوم مقام المعنى".(8). أليست هذه هي المخاوف التي تؤرق النقد بخصوص قصيدة النثر؟ خاصة وأن منظريها الأوائلَ انتبهوا – هم أنفسُهم - إلى الأمر، حين اعتبروا بعض النصوص التي نشرت في مجلة شعر نفسها نصوصا لا تحمل أي معنى.
مغامرة القراءة بناء على هذا الطرح غيرَ آمنة!
نقرأ إذاً قصيدة النثر بناء على تحديدها( متجاوزين الإشكال الذي يطرحه هذا التحديد كما تشكل في الحقل الشعري الفرنسي(poème en prose)، (9). بعبارة أخرى نزوج مفاهيمَ الجنسين لإنجاب مصطلحات قصيدِ- نثرية، ولكن أيةُ هذه المفاهيمِ العريسُ وأيةُ تلكَ الأخرى العروسُ؟
لا غرابة في إدراج هذا النوع من الخطاب، خاصة حين نسمع من أحدهم يصف قصيدة النثر بالخنثى! (10)
ألا تزج بنا هذه الإشكالات في المتاهة التي لم يخرج منها قطبا النقد المناوئ والمناصر؟ المتاهةِ التي أفضت إلى بدائل تلفيقيةٍ تحاول خندقةَ النص وإن بمرجعية جنسية لا أجناسية (خنثى). متاهة ناتجة عن تيه نقدي منبهر بالنظريات الغربية، عاجزٍ عن تطوير نظرية نقدية عربية بديلة منبثقة من مساءلة التراث الثقافي العربي، والعملِ على تطوير الكوني فيه، وتجاوز المشروط بالظرف الثقافي والتاريخي والجمالي؛ نظريةٍ قد تعيد إلى النص سلطته، وتجعله منطلق البحث لا فأر تجارب.(11).
ما هي قصيدة النثر التي نود أن نقرأها؟ وما المفاهيم التي ينبغي أن تقرأ على ضوئها؟
هل نكتفي بخلاصة سوزان بيرنار كما نقلتها حركة " مجلة شعر" ؟ وأعني بذلك مفاهيم الإيجاز والتوهج والمجانية، وما يرتبط بها، هذا مع تحفظنا من كون تلك المفاهيم قادرة الآن على قراءة القصيدة في تمظهراتها الحالية، بالنظر إلى كثرة التجارب، وتطورها، واتساعها..؟
أم هي تلك البديل الناتج عن منح أجنبي إقامةً عربية؟
انسجاما مع زاوية رؤيا هذه الورقة، فلا الوصفة الأولى ولا الثانية قادرتين على قراءة شاملة لنص قصيدة النثر. ولكن ما القول في المحاولات المتعددةِ التي اشتغلت على بنياتِ النص الداخليةِ اللغوية والأسلوبية والدلالية والإيقاعية ؟
نصنف تلك المحاولات إلى:
أولى: باحثة في النص عن المفاهيم، وثانية مجتهدة في فتح الطريق أمام مفاهيم لتعبر من جنس إلى جنس ومن نوع إلى ثانٍ، ومن حقل إلى آخر. ولكن ما علينا إلا أن ننوه بالمنطلق العلمي لتلك المحاولات، والذي نرى فيه خروجا عن السجال النقدي العقيم. ونرى في هذا المنطلق من جهة أخرى، مسعى محمودا لتهيئ الساحة لنقد تجريدي قادر على صياغة مبادئَ عامةٍ حيوية تحدد ماهيتها في حقل الشعرية العربية الحديثة.
ولا ضير إن نحن عرضنا – على سبيل التمثيل فقط – لبعض تلك الدراسات الحديثة جدا، والتي اشتغلت على البنيات النصية في قصيدة النثر. وحتى لا يصبح مركز هذه المداخلة قراءة للمنتج النقدي فقد اخترنا – بناء على دعوانا السابقة – نموذجين من الدراسات:
الأولى: اعتمدت بشكل كبير على المفاهيم التي سبقت إنتاج قصيدة النثر في الحقل الشعري العربي الحديث.
الثانية: سعت إلى أن تدخل عالم النص من خلال تعديلات مفهومية.
غايتنا من ذلك الخروج بملاحظات قد تبرر المنهج الذي نتعامل به مع النص الذي بين أيدينا: «بياض الحروف».
الدراسة الأولى: تحمل عنوان: « قصيدة النثر العربية: الأسس النظرية والبنيات النصية». وهي للدكتور عبد القادر الغزالي، في طبعتها الأولى سنة 2007. صادرة عن مطبعة تريفة بمدينة بركان المغربية.
أما البحث الثاني فهو عبارة عن رسالة الدكتوراه للأستاذ الدكتور عبد الرحمان عبد السلام بعنوان « السرد الشعري وشعرية ما بعد الحداثة. قراءة في «مهمل...تستدلون عليه بظل للشاعر علاء عبد الهادي».
* تتضمن الدراسة الأولى قسمين:
- القسم الأول: خاص بالأسس النظرية في فصلين:
الفصل الأول: " قصيدة النثر ورهانات الحداثة. الفصل الثاني: " الشعريات الحديثة وأوضاع قصيدة النثر"
- القسم الثاني: (الجانب التطبيقي) فيتضمن ثلاثة فصول:
الفصل الأول: " المتن الشعري"، التحدد الإجرائي والمكونات النصية.
الفصل الثاني: " البنيات الإيقاعية ".
الفصل الثالث: عنونه الباحث ب " المتخيل الشعري" عند كل من توفيق صايغ، ومحمد الماغوط، وسركون بولص، وأنسي الحاج.
وقد اختار الدارس ثلاثة نصوص ( دواوين) لكل واحد منهم.
يحدد الباحث في المقدمة( من صفحتين) المنهج الذي ينطلق منه، في " محاولة اكتشاف الأسس النظرية والبنيات النصية في قصيدة النثر العربية، (و) هو شعرية الإيقاع التي يدافع عنها الشاعري هنري ميشونيك، والقائمةُ على وضع التاريخية والذاتية والمجتمعِ موضعَ اعتبار".(12). في بداية الفصل الأول من القسم الأول يحدد الباحث فرضية المنطلق، يقول عنها: " الفرضية الأساس التي ننطلق منها، في هذا المقام، هي أن قصيدة النثر أو الشعرَ الخارجَ عن الوزن التقليدي، قد انبثقت من صلب التجارب الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة بخاصة ".(13).
ولنا أن نسجل ملاحظتين: تتعلق الأولى بالبنية المفهومية والثانية بالفرضية، فالبنية المفهومية مبنية على ما توصل إليه هنري ميشونيك بخصوص شعرية الإيقاع، ومن تم نفهم أن زاوية اشتغال الدراسة محدودة، وأن الرؤية تتم نحو هدف ميكرومتري، في مقابل رحابة فضاء الشعر موضوع الرؤية. وربما سقطت مجموعة " مجلة شعر" في الإشكال نفسه، حين حبست الرؤيةَ الجديدة في مقترحات سوزان برنار.
الملاحظة الثانية هي العقم الذي حل بخاتمة الدراسة المقترحة(ثلاث صفحات)، بحيث جاء محتواها عبارة عن أحكام عامة، وأقوال لا تدخل إلا ضمن تحصيل الحاصل، في حين أن المتوقع من دراسة من هذا الحجم(538 صفحة)، هو الخروج بخاتمة تركيبية تتضمن استنتاجات، ورؤى، وإضاءات، ونحتا لمفاهيم جديدة تضيء للقارئ بعض جوانب هذه الكتابة الجديدة في الشعر. ويمكن أن نقرب المهتم من دعوانا هذه. فنقرأ في بداية الخاتمة: " قصيدة النثر العربية كتابة شعرية لها تاريخها الذي أفرز من خلال التجارب المتنوعة قضايا وإشكالات، لم تكن معهودة ".(14) ورغم هلامية هذا الكلام، فقد كان أفقنا ينتظر تحديد طبيعة هذه الإشكالات، إلا أن الباحث يستطرد بقوله: " فقد أشرعت أبواب الكتابة على مصاريعها، بعد المحاولات الجريئة، التي حولت من خلال المنجز النصي ممارسة تاريخية شعرية عربية، حكمت تطورها الداخلي قوانين ومعايير أصبحت بدهيات لا يمكن تجاوزها، إلى حقل من حقول الصراع بغية التجديد وتأسيس الإبداع المغاير النابع من روح العصر، وجوهر المعاناة الإنسانية". ثم يأتي في مرحلة متقدمة ليصرح بأن قصيدة النثر: " استفادت من جميع مصوغات التجديد الشعري، ولم تقف عند هذا الحد بل دفعت بها جميعها إلى منتهاها ضمن مراجعة جذرية ونقد عميق للأصول ".(15).
لقد عادت بنا الدراسة إلى النقطة الصفر، ونحن بين يدي الصفحة الأخيرة من الكتاب: كيف نفسر أن لقصيدة النثر " معايير أصبحت بدهيات لا يمكن تجاوزها " في الوقت الذي أصبحتْ فيه هذه القصيدة تتجه نحو " التجديد وتأسيس الإبداع المغاير..." ؟
ألا تقف البدهيات ضد التجديد؟
الحقيقة أننا لا نرغب في أن نزج بهذه الورقة في مناقشة من هذا النوع، ولكن نود من هذه الوقفة أن ننبه إلى أن القسم النظري من الدراسة (اثنان وعشرون صفحة لـ" المدخل" ومائة وثمان وخمسونصفحةً للقسم الأول الخاص بالأسس النظرية)، استوفى المقول النقدي ببنيته المفاهيمية التي أُسقطت على المتن الشعري المدروس. ورغم بعض الأقوال من قبيل: " ذلك هو مسار القراءة الشعرية المقترحة في هذه الدراسة، لا ضمن المقولات والمفاهيم الجاهزة، ولكن ضمن انفتاح، ننظر فيه إلى المكونات النصية نظرة تفاعلية" إلا أن المنهج المعتمد في القراءة يخالف هذه الدعوى. إذ جاءت القراءة التطبيقية وصفيةً إحصائية، والخاتمة لم تجمل الخطوط العريضة التي تتقاطع وتلتقي فيها التجارب المدروسة: المنتجُ النصي.
* الدراسة الثانية:
يقسمها صاحبها إلى قسمين: يتضمن الأول المفهومات المؤطرة للاشتغال، يطرح فيه بدايةً الإشكالاتِ المتعلقةَ بسؤال النوع أو الكتابة الأجناسية، ثم يتناول مفهوم الكتابة و" النص الفضاء"، لينتقل بعدها إلى نص المهمل لتحديد مفهوم الشعر من خلاله، وفي الفقرة الرابعة يعالج مفهومَ السرد وأهميتَه، ثم يختم هذا القسم بتناول مفهوم السرد الشعري. أما القسم الثاني فقد خصصه للجانب التطبيقي، متناولا نص المهمل من سبع زوايا هي ( المتن، البنية السردية، الكتابة المشهدية، مدونة الشعر، البنية المُهملية، السرد الشعري وتوظيف الشخصية، السرد الشعري ووجهة النظر).
يبدأ الدارس بتسجيل ملاحظة جعل منها منطلقا يوجه مسار البحث، مفادها أن: " كل نوع أدبي قابلٌ للانفتاح، أو بعبارة أخرى للعبور والانصهار في كتابة ذات أفضية أجناسية طليقة ما دامت تصنعها شروطها التاريخية والثقافية والجمالية في الإبداع والتلقي".(16). ثم يتدرج الباحث في غزل نسيجه النظري وصولا إلى استنتاج، يتفق فيه مع رنيه ويليك، مفاده أن " التمييز بين الأنواع الأدبية لم يعد ذا أهمية في كتابات معظم كتاب عصرنا ".(17)، ويدعم الباحث هذا الطرح - أخذا عن رولان بارت - بأن كل ما نستطيعه أمام النص هو تفجيره، ويرتبط بهذا التصور عنده مفهومُ الفضاء من منظور أنه إذا " كان النص لغة فإن الفضاء هو تفعيلُ هذه اللغة في حيازته حين يتم تشكيلها".(18). وبالطبع كان على الباحث ألا يغفل – في هذا الصدد –دور القارئ فيما سماه تعطيلَ البعد الاستهلاكي وتفعيلَ البعد الإنتاجي. ويرى أنه ما دام أن " قيمة اللاشيء تمنح الشيء قيمته " فإن الفراغ والبياض في النص لهما دلالتاهما، بمعنى أنه بهما يتحدد السواد( المتن).
ينتقل الباحث، بعد ذلك، إلى تحديد دلالة السرد باعتباره أداة للاشتغال. وبالطبع، وقبل أن يتحول إلى أداة، عليه أولا أن يكون موضوعا تستوجب دلالتُه التحديد. يحددها الباحث كما يلي: السرد " إنتاج حكاية، سرد مجموعة من المواقف والأحداث"، ويستدعي بعد هذا التعريف مقولة پروپ في السرد القائمة على الوظائف التي تنهض بها الشخصيات، ثم يدعم هذا التصور باستدعاء بارت مرة أخرى في قولته المشهورة عن السرد: " إنه موجود في كل مكان تماما كالحياة".
بعبارة أخرى كيف يمكن أن يكون السرد في النثر دون أن يكون في الشعر؟ وبعبارة أعمق لمَ لا يلتقي الشعر والنثر في نص أدبي..ليكن هو قصيدة النثر.
بهذه الخلاصة المفترضة، علينا أن نتحدث عن سرد شعري. فما هو؟
بعد معالجة مستفيضة انطلقت من التعالق بين مكونَيِ العنوان، يصل بنا الباحث إلى خلاصة مفادها أن " السرد خطاب ذو فرادة في هويته يتمايز بها عن أغياره من خطابات الأدب، كما أن الشعر خطاب له هويته التي تميزه عن أغياره من الأدب" ، ومن تم يستنتج ما أسماه بلحظة تقاطع بين السرد والشعر، مدعما ذلك بملاحظته حول ما عرفه سرد ما بعد الحداثة من تجاوز التلازم الزمني والمنطقي، وهو – كما يقول الباحث- ما تقوم به الوظيفة الشعرية. ورغم ما يثيره هذا التصور من قلق حول كيفية تقارب الوظيفتين السردية والشعرية؛ إلا أن إضفاء صفة تجريدية أكثر على مفهوم السرد، يدفعنا إلى تتبع الباحث في طرحه النظري، إلى أن يصل بنا إلى مفهوم " الكتلة النصية "، معتبرا إياها(الباحث) إطارا لاشتغال الوظيفتين. وهذه هي وظيفة ما أسماه بالغلالة الشعرية الشفيفة، القادرة على أن تسبغ على السرد وظيفة شعرية، غير أن هذا – حسب رأيه - لا يتأتى في الجمالية اللسانية من تراكيب ونحو ودلالة ومعجم، بل في جمالية الخطاب في كليته وانتشاره في جزئيات العمل الشعري. ولتعزيز هذا الطرح يحيل على كتاب " مدخل لدراسة النص والسلطة لعمر أوكان في مقولة أن: " ..الحدود بين الجملة الشعرية والجملة النثرية غائمة وستظل لعبة في يد الشعراء العظماء القادرين على تحويل ما يسمى بالنثر/اللاشعري إلى الشعر".
وما دام الأمر يتعلق بالسرد، فإن المفاهيمَ المرتبطةَ به، وجب أن تلبس حلة جديدة، تتناسب مع الوظيفة الجديدة، (الشخصيات، الزمكانية، وجهة النظر، التبئير، زاوية الرؤية ونوعها، تدخل المؤلف، العجائبي، المخاطِب والمخاطَب..) الخ.
وبالضبط هذا ما لا ينبغي أن تجهله هذه الدراسة، وهو ما تم بالفعل. فقد اشتغلت هذه المفاهيم داخل النص الشعري بحلتها الجديدة. فالشخصية - على سبيل تقريب الصورة - في السرد ليست كما هي في الشعر، هنا قد تكون عنصرا طبيعيا حيا أو جامدا، وقد تكون مجرد فكرة. وبحسب تعبير الباحث، أخذا عن غريماس: " تصبح الشخصية مجرد دور ما يُؤَدَّى في الحكي بغض النظر عمن يؤديه".(19).
نحن الآن بصدد مفاهيم عابرة، وفي عبورها إلى محجها عليها أن تلبس زي " الإحرام الشعري"..إنه التجريد؛ ليس تجريدَ المفهوم من وظيفته وإلباسَه وظيفةً أخرى، بل تجريدَ الوظيفة إلى الحد الذي يمكن أن تُحْدِثَ تغييرا في تصورنا التقليدي للمفهوم ذاته.
بعد تثبيت الإطار المرجعي، يلج الباحث عالم النص من زاوية واحدة هي: " السرد الشعري"، مستعيرا مفاهيم السرد للاشتغال، ثم ينهي دراسته بخاتمة. فالهوامشِ والإحالات.
كانت غايتنا من هذه الإطلالة أن نكشف عن طريقتين(منهجين) في التعامل مع الأثر الأدبي( قصيدة النثر هنا)، والنتيجةِ التي تفضي إليها كل طريقة على حده.
فدراسة عبد القادر الغزالي أخضعت النص قسرا إلى بنية من المفاهيم- إن كانت تشكل بنية- استدللنا على ذلك بالخاتمة التي جاءت عبارة عن تحصيل حاصل لمقولات الإطار النظري. في حين أن الدراسة الثانية بنتْ مرجعيتها على ما يوفره النص من إمكانات. وقد نفهم من هذا أن كلتا الدراستين انبنتا على مفاهيم مؤطرة، إلا أن الأمر خلافُ ذلك. فالأولى استعارت مفاهيمها من مرجعية شعرية لتشتغل بها في مرجعية شعرية أخرى. في حين أن الثانية استقت مفاهيمها من جنس غير الشعر لتشتغل بها في الشعر. مفاد ذلك – وبالنظر إلى الإشكال الأنواعي- فالدراسة الأولى بحثت عن تجسد المفهوم في النص، وإن اقتضى الأمر منحه جوازَ سفر مزور. أما الثانية فقد اختبرت المفهوم في النص، وقد نجحت – إلى حد ما - في الاختبار لأنها بدأت أولا بتحويل أداة الاشتغال إلى موضوع، يعاد تحديده والكشف فيه عن الجوانب الميتافيزيقية التي تمكنه من الاتساع والامتداد ليكون أعم من مقولتي " الأنواعي " أو " الأجناسي ". لذا جاءت الخاتمة لتقتنص غنم السفر - على حد تعبير صاحبها – أي جاءت لتكثف كيفية انكتاب نص المهمل، ليس كقصيدة نثر، بل كشكل من أشكال قصيدة النثر.
تبلغ هذه المقدمة غايتها، وهي الاختيار المنهجي. فبناء على ما كشفنا أعلاه، لا يمكن أن نقرأ النص إلا من خلال ما يتيحه لنا من إمكانات. نقرؤه عبر السلطة التي تفرضها علينا حدوده، نقرأ ما يقدم لنا لا ما ينبغي أن يكون عليه: فما ينبغي أن يكون إما حلم الإبداع، وإما خلل في نقد الإبداع. وليس مسعى التأطير - بهذا المنظور الذي طرحناه- سجنا أو حدا من الحرية، بل مسعاه خلقُ المبدع القادر على خلخلة وإعادة تركيب ما ينتظم داخل الإطار، لفتح فجوات تتنفس منها اللغة ريحا جديدة، بها تتشكل في حلة جديدة.
ثانيا: بياض الحروف
1- ذلك النص.
" بياض الحروف" ديوان شعر، للشاعر عبد الرزاق جبران، صدر عن منشورات أجراس- دار القرويين سنة 2006. الافتتاحية بإهداء إلى العائلة، والختام بالفهرست. الديوان في أربعة أقسام موزعة على 131 صفحة:
القسم الأول: أناشيد العتمة، من ست عشرة قصيدة.
القسم الثاني:احتفاء بالجسد، من تسع عشرة قصيدة.
القسم الثالث: نشيد الهواجس، من اثنتي عشرة قصيدة.
القسم الرابع: نمنمات: من عشرين قصيدة.
تتوزع القصائدُ بخصوص فضاء النص ما بين جزء صغير من الصفحة (نسميها ومضة) وخمسِ صفحات. عدد الومضات ستَّ عشرةَ موزعة على الشكل التالي:
من القسم الثاني قصيدتا " امرأة "، و" موت " ص: 60 و 70 على التوالي.
من القسم الثالث: قصائد: " موجة ص: 71، رمل ص: 72، حلم ص: 73، فيء الكلام ص: 74، حروف ص: 75، ريبة ص: 76، شعراء ص: 77، علم ص: 78، هاوية، ص: 79
من القسم الثالث: قصائد: تقرير ص: 105( وهي أقصر قصيدة في الديوان- ثلاثة أسطر)، الشاعر ص: 105، فحولة ص: 107، حنين ص: 108 غياب ص: 113.
هذا وأنوه إلى أن هذه العملية الوصفية الإحصائية غايتها تقريب صورة تشكل الديوان، لا توظيفها فيما تتغياه هذه الورقة.
نخصص الفصل الأول – في قراءتنا لنص " بياض الحروف " لمفهوم الشعر، ونتناول في فصل لاحق مفهوم " الحلم"، أما الفصل الثالث فنشتغل فيه على مفهوم " العشق، في حين يتطرق الفصل ما قبل الأخير إلى بنية النص اللغوية والإيقاعية وعلاقاتها بالدلالات المدروسة أعلاه، أما الفصل الأخير فنخصصه لتركيب المعطيات أعلاه، والخروج باستنتاجات بناء على ما وفره لنا النص. وفي كل فصل نحدد طريقة اشتغالنا وفق المنهج الذي تبنيناه أعلاه.
وأما بخصوص مفهوم " الشعر" فنستعين على مقاربته بالتطرق إلى المفاهيم التالية:
*اللغة الشعرية.
* القصيدة.
* الشاعر.
* اللحظة الشعرية.
2- مفهوم الشعر في بياض الحروف:
ارتأينا ونحن نعالج مفهوم الشعر كما هو مبثوث في بعض المقاطع الشعرية؛ أن نبدأ أولا بمتعلقات ذلك المفهوم، من لغة وقصيدة وشاعر ولحظة شعرية، غايتنا من ذلك أن تضيء لنا بعضَ مدالجِ ما نقتحم.
أولا- مفهوم اللغة الشعرية:(الاستعارة والمجاز/البناء والإلهام/المعاناة والوحي).
أول ما نود البداية به، هو التنويه إلى كيف تم إبعاد لغة الشعر عن مكونها البياني الذي ارتبطت به في الشعرية العربية الكلاسية، ونعني بذلك مكون البلاغة، كما حدد آلياتِها العقل البياني العربي الوسيط. نصادف في الديوان مقاطع شعرية عديدة نتنسم منها هذا الموقف، مواقف تنطلق من تاريخ البلاغة نفسها، إذ تعتبر أن مسيرتها الطويلة التي لم تصادف فيها مجددين حقيقيين، يحملونها إلى آفاقَ تعبيريةٍ أرحبَ، قد أفضت بها إلى باب شبه مسدود، إلى درجة أن أصبحت مجرد خرق متعفنة تحتاج إلى تنقية وتصفية. وإذا ما استحضرنا المقولة البيانية القديمة من أن أشرف البلاغة هو التشبيه، فإنه وبناء على آليات اشتغاله فإن صورته العقلية المبنية على المقايسة التي تعود في الأصل إلى الاستدلال بالشاهد على الغائب أو العكس.(20)، هذه الصورة لم تعد صالحة للكتابة الشعرية الحديثة التي تجاوزت ما يسمى بمنطق الكتابة نحو كتابة اللامنطق. غير أن التشبيه قادر على إنجاب مفهوم جديد، قد يجعل بنيته المنطقية غيرَ ذاتِ لزوم. أو قل إننا بصدد تنقيته من شوائب المنطق البياني.(21). تقودنا هذه العملية إلى تبني " الاستعارة ". وقبل أن نؤكد دعوانا هذه نجيب عن السؤال التالي: ما الداعي إلى هذا التبني؟ هل فقط لأنها خلصتنا من منطقية التشبيه غير الصالحة للكتابة الشعرية الحديثة؟ نقرر أنه ليس ذلك فحسب، بل - وإضافة إلى ذلك- فالجانب النفسي الذي نتنسم منه رائحة من التراث تفوح، حاضر بشكل مركزي، بمعنى أن الاستعارة لا ترام إلا بعد جهد ومكابدة، إنها نتيجة لعملية بناء متعبة ومضنية، ومن تم فهي سيدة العالم الشعري ما دامت مبنية على الجهد والمكابدة، كحقيقتين ملازمتين للشعر.
أسافر نحوي
مثقلا بالأساطير،
أبني عالما فيه الاستعارة سيدة،
وأغسل أسمال البلاغة
من عرق، أبقاه القدماء..(22)
ونسمع في قصيدة أخرى هذه الصوت يتردد:
فازحفْ نحو نجمة
تسكن الأقاصي
واغسل أيامنا
من سهو البلاغة.(23)
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب الاستعارة، يبقي الشاعر من البلاغة عنصرا ثانيا:
كأن مجازي طريق أبيض
نحو المشيئة،
يسلكه الأنبياء.(24)
والحقيقة أننا نتنسم تصورا جديدا للمجاز، فهو لا يرتبط هنا بقواعد بلاغية تحدد إطار اشتغاله، بل هو شكل من أشكال الوحي، لا نبحث عنه بقدر ما يلقى في الصدر. بهذه الصورة الميتافيزيقية للمجاز – وهي تختلف عما نسميه اليوم بالانزياح- تتشكل لغة الشعر. فهو لا يتحرك وفق منطق اللغة التي تنتجه، بل على اللغة أن تقبل بما يضيفه إليها من جديد.
المجاز والاستعارة يعنيان على التوالي الوحيَ والمعاناة، ولا أحد يجادل في أن هذين المصطلحين مرتبطان بالنبوة، ومن علاماتها الرؤيا:
أرضي بكر
فيها متسع الرؤيا
وحنيني لغة لا تقهرها الأهواء.(25)
عملية التفتيت هذه – التي نلمسها في تصور علاقة الشاعر بالبلاغة- تتوغل داخل اللغة نفسها، وليس فقط داخل نظام البلاغة،(26)، فاللغة لا ترام كقواعد نحوية أو بلاغية، بل ترام كجسد له ظاهر وباطن، ومن تم فالتحدي هو الكشف عن عورتها وإن اقتضى الأمر خرق جدار القوانين:
أمرق في صدر من زجاج
أكشف عورة اللغة
أمزق كل السدوف.(27)
لغة الشعر إذن ينبغي أن تتجاوز البلاغة التقليدية التي تسير وفق منطق اللغة، وتُبقي على الاستعارة والمجاز، لأن الأولى فيها مكابدة ومعاناة تروم حقيقة الشعر، والثاني (المجاز) لم يعد على تلك الصورة المعهودة فيه، إنه هنا أقرب إلى الوحي يلقى في الصدر، لا يشكله الذهن وفق قوانين محددة. كما أن لغة الشعر تتجاوز ظاهر اللغة، إنها الجزء الباطن المتخفي تحت الظاهر، وعلى هذا الأساس يجب تعرية هذه اللغة وكشف عورتها، في محاولة للوصول إلى الشعري فيها، وليس من يمنع إن استعصى الأمر أن نخرق منطقها.ارتأينا ونحن نعالج مفهوم الشعر كما هو مبثوث في بعض المقاطع الشعرية؛ أن نبدأ أولا بمتعلقات ذلك المفهوم، من لغة وقصيدة وشاعر ولحظة شعرية، غايتنا من ذلك أن تضيء لنا بعضَ مدالجِ ما نقتحم.
أولا- مفهوم اللغة الشعرية:(الاستعارة والمجاز/البناء والإلهام/المعاناة والوحي).
أول ما نود البداية به، هو التنويه إلى كيف تم إبعاد لغة الشعر عن مكونها البياني الذي ارتبطت به في الشعرية العربية الكلاسية، ونعني بذلك مكون البلاغة، كما حدد آلياتِها العقل البياني العربي الوسيط. نصادف في الديوان مقاطع شعرية عديدة نتنسم منها هذا الموقف، مواقف تنطلق من تاريخ البلاغة نفسها، إذ تعتبر أن مسيرتها الطويلة التي لم تصادف فيها مجددين حقيقيين، يحملونها إلى آفاقَ تعبيريةٍ أرحبَ، قد أفضت بها إلى باب شبه مسدود، إلى درجة أن أصبحت مجرد خرق متعفنة تحتاج إلى تنقية وتصفية. وإذا ما استحضرنا المقولة البيانية القديمة من أن أشرف البلاغة هو التشبيه، فإنه وبناء على آليات اشتغاله فإن صورته العقلية المبنية على المقايسة التي تعود في الأصل إلى الاستدلال بالشاهد على الغائب أو العكس.(20)، هذه الصورة لم تعد صالحة للكتابة الشعرية الحديثة التي تجاوزت ما يسمى بمنطق الكتابة نحو كتابة اللامنطق. غير أن التشبيه قادر على إنجاب مفهوم جديد، قد يجعل بنيته المنطقية غيرَ ذاتِ لزوم. أو قل إننا بصدد تنقيته من شوائب المنطق البياني.(21). تقودنا هذه العملية إلى تبني " الاستعارة ". وقبل أن نؤكد دعوانا هذه نجيب عن السؤال التالي: ما الداعي إلى هذا التبني؟ هل فقط لأنها خلصتنا من منطقية التشبيه غير الصالحة للكتابة الشعرية الحديثة؟ نقرر أنه ليس ذلك فحسب، بل - وإضافة إلى ذلك- فالجانب النفسي الذي نتنسم منه رائحة من التراث تفوح، حاضر بشكل مركزي، بمعنى أن الاستعارة لا ترام إلا بعد جهد ومكابدة، إنها نتيجة لعملية بناء متعبة ومضنية، ومن تم فهي سيدة العالم الشعري ما دامت مبنية على الجهد والمكابدة، كحقيقتين ملازمتين للشعر.
أسافر نحوي
مثقلا بالأساطير،
أبني عالما فيه الاستعارة سيدة،
وأغسل أسمال البلاغة
من عرق، أبقاه القدماء..(22)
ونسمع في قصيدة أخرى هذه الصوت يتردد:
فازحفْ نحو نجمة
تسكن الأقاصي
واغسل أيامنا
من سهو البلاغة.(23)
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب الاستعارة، يبقي الشاعر من البلاغة عنصرا ثانيا:
كأن مجازي طريق أبيض
نحو المشيئة،
يسلكه الأنبياء.(24)
والحقيقة أننا نتنسم تصورا جديدا للمجاز، فهو لا يرتبط هنا بقواعد بلاغية تحدد إطار اشتغاله، بل هو شكل من أشكال الوحي، لا نبحث عنه بقدر ما يلقى في الصدر. بهذه الصورة الميتافيزيقية للمجاز – وهي تختلف عما نسميه اليوم بالانزياح- تتشكل لغة الشعر. فهو لا يتحرك وفق منطق اللغة التي تنتجه، بل على اللغة أن تقبل بما يضيفه إليها من جديد.
المجاز والاستعارة يعنيان على التوالي الوحيَ والمعاناة، ولا أحد يجادل في أن هذين المصطلحين مرتبطان بالنبوة، ومن علاماتها الرؤيا:
أرضي بكر
فيها متسع الرؤيا
وحنيني لغة لا تقهرها الأهواء.(25)
عملية التفتيت هذه – التي نلمسها في تصور علاقة الشاعر بالبلاغة- تتوغل داخل اللغة نفسها، وليس فقط داخل نظام البلاغة،(26)، فاللغة لا ترام كقواعد نحوية أو بلاغية، بل ترام كجسد له ظاهر وباطن، ومن تم فالتحدي هو الكشف عن عورتها وإن اقتضى الأمر خرق جدار القوانين:
أمرق في صدر من زجاج
أكشف عورة اللغة
أمزق كل السدوف.(27)
ثانيا- مفهوم القصيدة.( البياض والسواد/الأفكار والشطحات الصوفية)
القصيدة في التصور هي خروج الشعر من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، والتحول من وجود إلى آخر، لا بد له من برزخ، إنها اللحظة الإبداعية التي ينتقل فيها الشاعر أيضا من وجود إلى آخر.
نسجل بدايةً أنه بالقدر الذي استعصى على الشاعر تصويرُ هذا المفهوم جماليا؛ بقدر ما استعصتْ علينا نحن أيضا لملمةُ الأجزاء المكونة لهذا المفهوم مبثوثةً في الديوان، من جهة، ومفارقتُها أحيانا لمفهوم الكتابة عبر خيط دقيق شفاف، من جهة ثانية. ولكن أليس هذا الاستعصاء في حد ذاته إيجابيا؟ نعتقد ذلك ما دامت حقيقة الإبداع هي عدم الخضوع للأتمتة.
ونحن إذ نبحث عن مفهوم القصيدة عند صاحب بياض الحروف، لا ندعي الوصول إلى تعريف أو تحديد، بل محاولة منا ملامسةَ المفهوم، بالقدر الذي يفصح عنه الديوان.
تعسفا ننزل بمفهوم " القصيدة " إلى السفح، وأقصد بذلك الشكلَ، ونعني به ما يلي: " الصفحة السوداء التي تضيئها الحروف البيض، بله يضيئها بياض الحروف " :
همستُ:
" البياض يتمايل في المرايا
مكشوف الخاصرة
والسواد صفاء
يسكن اللغة العابرة.(28)
القصيدة - إذاً - هي صفاء السواد الذي يعبر سواد البياض، ومصطلح " يعبر" نعتبره محوريا لأنه من الممكن أن يحيل على تشكيلات هندسية، قد تكون عناصر بنيوية في تصور الشاعر للقصيدة. الحقيقة أنه لم يترك لنا هذا المفهوم شيئا مما كنا نعرفه عن القصيدة، ذلك الكائن الهادئ الأليف، هذه قصيدة من نوع آخر، لنقل إنها قصيدة مراوغة:
قفوت همس الريح
كي أحضن موتي
في قصيدة مائدة.(29)
ولا غرو أن البحث عن هذه المراوغة يكون وراءه جهد مضن ومعاناة تشبه معاناة الموت:
في الساعة الأولى
من الفجر
أبدأ قصيدتي..
تلوكني الحمى
تجلدني الكلمات..
وعند الوتد الأخير،
تغرقني الثواني
المتبقية من النهار
فأرى القبر
يفتح ذراعيه ليلقاني.(30)
قصيدة مضنية متعبة، ولكنها غير مستعصية، ما دام الشاعر قادرا على بلوغ درجة من الاختمار الروحي، تخفف عنه هول تلك المعاناة:
كلما دخلت البياض
تقلبت الحروف
في صدري
من ألم السجود.(31)
وإذا أضفنا إلى هذا كله السطرين الأولين من المقطع أسفله:
من همس الروح
تبدأ القصيدة
فارقصي
يا طيور الصبح
ومدي جناحيك
لشمسنا الجديدة.(32)
إذا أضفنا ذلك نستطيع أن نقول الآن - والآن فقط- إن القصيدة بياض وسواد مائدان، يحيا الشاعر أثناءهما حياة برزخية، فتتناغم في روحه الأفكار والتصورات، وكأنه في لحظة تعبدية أو شطحة صوفية.القصيدة في التصور هي خروج الشعر من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، والتحول من وجود إلى آخر، لا بد له من برزخ، إنها اللحظة الإبداعية التي ينتقل فيها الشاعر أيضا من وجود إلى آخر.
نسجل بدايةً أنه بالقدر الذي استعصى على الشاعر تصويرُ هذا المفهوم جماليا؛ بقدر ما استعصتْ علينا نحن أيضا لملمةُ الأجزاء المكونة لهذا المفهوم مبثوثةً في الديوان، من جهة، ومفارقتُها أحيانا لمفهوم الكتابة عبر خيط دقيق شفاف، من جهة ثانية. ولكن أليس هذا الاستعصاء في حد ذاته إيجابيا؟ نعتقد ذلك ما دامت حقيقة الإبداع هي عدم الخضوع للأتمتة.
ونحن إذ نبحث عن مفهوم القصيدة عند صاحب بياض الحروف، لا ندعي الوصول إلى تعريف أو تحديد، بل محاولة منا ملامسةَ المفهوم، بالقدر الذي يفصح عنه الديوان.
تعسفا ننزل بمفهوم " القصيدة " إلى السفح، وأقصد بذلك الشكلَ، ونعني به ما يلي: " الصفحة السوداء التي تضيئها الحروف البيض، بله يضيئها بياض الحروف " :
همستُ:
" البياض يتمايل في المرايا
مكشوف الخاصرة
والسواد صفاء
يسكن اللغة العابرة.(28)
القصيدة - إذاً - هي صفاء السواد الذي يعبر سواد البياض، ومصطلح " يعبر" نعتبره محوريا لأنه من الممكن أن يحيل على تشكيلات هندسية، قد تكون عناصر بنيوية في تصور الشاعر للقصيدة. الحقيقة أنه لم يترك لنا هذا المفهوم شيئا مما كنا نعرفه عن القصيدة، ذلك الكائن الهادئ الأليف، هذه قصيدة من نوع آخر، لنقل إنها قصيدة مراوغة:
قفوت همس الريح
كي أحضن موتي
في قصيدة مائدة.(29)
ولا غرو أن البحث عن هذه المراوغة يكون وراءه جهد مضن ومعاناة تشبه معاناة الموت:
في الساعة الأولى
من الفجر
أبدأ قصيدتي..
تلوكني الحمى
تجلدني الكلمات..
وعند الوتد الأخير،
تغرقني الثواني
المتبقية من النهار
فأرى القبر
يفتح ذراعيه ليلقاني.(30)
قصيدة مضنية متعبة، ولكنها غير مستعصية، ما دام الشاعر قادرا على بلوغ درجة من الاختمار الروحي، تخفف عنه هول تلك المعاناة:
كلما دخلت البياض
تقلبت الحروف
في صدري
من ألم السجود.(31)
وإذا أضفنا إلى هذا كله السطرين الأولين من المقطع أسفله:
من همس الروح
تبدأ القصيدة
فارقصي
يا طيور الصبح
ومدي جناحيك
لشمسنا الجديدة.(32)
ليكن هذا ادعاء خاطئا، ولنتركه يحضر معنا في نهاية هذا القسم لمساءلته، ونتوجه الآن بنظرتنا إلى الشاعر.
ثالثا: مفهوم الشاعر: ( النبوة والولاية/القضية ونقد الواقع)
وكما تعودنا أن نبدأ بالملاحظات، نسجل هنا أن هذا المفهوم يحضر مرة كذات، ومرة أخرى من خلال ذوات الشعراء، وكأننا بصدد شاعرين لا شاعر واحد. غير أن معالجة هذه الملاحظة في ذاتها لا تدخل البتة ضمن هذه القراءة. وإنما نسجلها لأننا ننبه إلى الاختلاف الذي قد يحسه المتلقي في عملية استكناه مفهوم الشاعر، من مقطع شعري يتجسد فيه كذات، ومقطع آخر يتجسد فيه من خلال ذوات الشعراء. أما المعطى الذي نفتح به هذه المناقشة، فنقرؤه في المقطع التالي:
مني تبدأ الشفاعة
وأتباعي الجدد شعراء
أصفياء.(33)
لا أحد يتأمل هذا المقطع ويجادل في خصوبته، أعني نه يفتح لنا آفاق عدة للقراءة، غير أننا لم نورده في هذه اللحظة بالذات لتأكيد ذلك، بل مسعانا هو أن نؤمِّن لهذه القراءة مسارها الذي خططته. نسجل بدايةً أن لفظتي " الشفاعة " و"أصفياء" لهما ما يحيل عليهما فيما أوردناه أعلاه، الفرق أن هذه المرة يكشفان عن هويتهما، بل ويحيلان دونما تخفٍّ عن مفهومي النبوة أو الولاية. لنقل بوضوح إن الشاعر إما نبي أو ولي، والجامع بينهما التميز عن الآخرين، والفرق في الدرجة فقط. وإن كنا نفهم من هذا الكلام أن هناك شاعرين، الثاني يقتفي أثر الأول لبلوغ مرتبته، فالذي يهمنا هنا هو دلالة اللفظتين، خاصة وأن حضورهما يتأكد أكثر من مرة في الديوان، وهذا واحد من ذلك الحضور، يقلب الصورة كصيغة من صيغ التأكيد:
في كل نبي شاعر
ينشر ضوء الفضيلة
في ليل المقابر.
يروي صحراء القبيلة
من قلبه الطاهر
يلم بين كفيه
شتاتنا القاهر
فتزهر في فيافينا حكمتُه الجليلة.(34)
الفضيلة إذن هي القاسم المشترك بين النبي والولي والشاعر، فضيلة تجمع الشتات الإنساني ليصغي إلى جلال الحكمة التي بها تغدو الحياة زهرة تتفتق في الأرض اليباب. نسلم مبدئيا أن هذه الفكرة ليست جديدة، في الشعرية العربية، إذ أن المتنبي دعا فنيا الأمة العربية إلى أن تجتمع على شعره، مثلما اجتمعت من قبل على قرآن محمد (ص)، وهي حقيقة أكدتها أكثر من دراسة لشعر المتنبي وملابساته السياسية، واستحضار هذه الواقعة من خلال دلالة المقطع الذي ندرسه، تفيدنا في فهم أشياء أصيلة في مفهوم الشاعر، إنه بهذا المعنى ليس من يعبّر جماليا عما يخالجه، بل صاحب الموقف والقضية، يعيش في خوف دائم من أن تضيع منه فيضيع هو الآخر:
فكيف أبارك زمني
وقد أضاعتني القبيلة؟
أفتش عني في المرايا
في قواميس الكلام
لا أجد غير بقايا عليلة
ضرجت بدم الكلام.(35)
يضيع الشاعر – إذاً - حين تكون الآذان صماء، لا تصغي إلى القضية التي يحملها، حينذاك ترتد الذات لتعيش عزلتها ومأساتها:
وحدك تغالب الريح
تشق السماء نصفين.
أنت..
أيها الشاعر
ترقب الوقت القاحل
تجمع الطرق
في عروة واحدة
لتقرأ الأرض مرتين.(36)
إن الخوف الدائم للشاعر من أن تضيع منه قضيته – كيفما كانت تلك القضية – هو ما يفسر التعبير الدائم عن المعاناة، تتجسد نفسيا في الحرقة والألم:
ها الينابيع في هذه البلاد
قد جفت
وها أنت تغرق
في حوض البلاهة
ليس لك من زاد
غير حرقة النشيد.(37)
غياب الصدى تضيع معه القضية التي يحملها الشاعر، بمعنى آخر، نحن الآن لسنا بصدد معاناة داخلية فحسب، بل أمام نقد لواقع إبداعي، ثقافي بشكل عام، وهذا جانب وظيفي لا يخفى:
داخل خزانة الكتب
صراخ وعويل نساء
شعراء وفلاسفة
يتحاورون في الغيب
أما نحن المعلقون
على أبواب الحياة
فنبتسم لهذا الضجيج.(38)
هل نحن أمام أزمة شعر؟ إن كان الأمر كذلك، فليس وراءها إلا أهله، أولئك الذين لم يعودوا يحملون قضايا مرتبطة بالحياة بل بالغيب..وبلغت الأزمة حالها السيئة، حين غدا الفن عامة - والشعر من الفن - إما اجترارا للمطروق، أو غموضا يتم التحايل به على المتلقي وخداعُه، أو خارجا عن أخلاق الفن. حري إذن أن:
نحكي عن الشاعر
الذي مات
- من الرجفة –
على المنصة..
" شقيت بي العبارة "
..مات وفي نفسه
غصة. (39)
مات لأنه سمع:
المسرحي
الذي يتسول السجائر
يتبول
- ليلا -
على جدران المسرح البلدي،
يسرق النصَّ.(40)
وسمع كذلك:
عن الروائي التائه
على أبواب النقد
يستجدي السادة الكرام
بصة.(41)
دعونا الآن نسجل مشهد المعاناة في صورته المكتملة؛ إنها معاناة مزدوجة: شقها ناتج عما آل إليه المشهد الشعري المتهاوي، والشق الثاني مع القصيدة. كشفنا من الأولى ما أسَرَّه لنا النص من إحالات وإشارات، أما الثانية ( المعاناة مع القصيدة) فهي موضوع الفقرة الموالية. وقبل ذلك دعونا نركب الأجزاء السابقة ونقول: إن تصور بياض الحروف لمفهوم الشاعر قائم على العناصر التالية:
أ- النبوة والولاية، وعبرهما يتحدد البعد الأخلاقي في الشعر من خلال الشاعر الفاضل.
ب- القضية ونقد الواقع، وبهما يتعدد البعد النفسي، إذ تعيش الذات في معاناة جراء الخوف الدائم وما يحدثه من حرقة وألم. سيقربنا منها أكثر الحديث عن لحظة الشعر.
رابعا- لحظة الشعر أو (اللحظة الجمالية):
لعل البحث في مفهوم " اللحظة الجمالية " يعتبر من أكثر البحوث ثراء وتعقيدا في الوقت نفسه، نظرا لتعدد الحقول المعرفية التي نما فيها، وأهمها على وجه الخصوص الفلسفة وعلم الجمال والنقد الفني والنقد الأدبي. ولتقريب تصورنا لمفهوم لحظة الشعر الذي نقترحه هنا، ننطلق من الفكرة البسيطة التالية: " أنا أمام أثر فني أريد أن أقرأه "، إن ذلك الأثر أُنتج في لحظة إبداعية، نسميها اللحظة الجمالية لدى المبدع. والقارئ حين يقدم على النص لقراءته فهو يدخل أيضا في لحظته الشعرية متلقيا ومنتجا من مبدإ إحساس بالجمال. نقول " إن انخطاف الفنان واندماجَه الوجودي في التجربة الفنية هو جوهر اللحظة الجمالية التي تسبق الإبداع".(42) المبدع والمتلقي كلاهما إذن يعيش لحظة لا زمنية، مثلهما مثل المستمع إلى الموسيقى والمشاهد لفيلم. غير أنه إذا كانت تلك اللحظة قد لقيت عناية كبيرة حين يتعلق الأمر بالمتلقي، إلا أنها – وحسب بعض الباحثين - لم تحظ بالاهتمام نفسه عند المبدع، وهذا يعود – كما يرى الباحث نفسه - إلى صعوبة الدخول واستكناه تجربة غير ذاتية.(43)
وعيا منا بهذا الإشكال فإن اشتغالنا على مفهوم لحظة الشعر في الأثر الشعري " بياض الحروف " لا يمكن أن يخلو من نقائص، قد تكون حافزا على المزيد من البحث. غير أننا سنسعى جاهدين إلى أن نبقى أوفياء للمنهج الذي تبنيناه سابقا من ألا ندفع بالنص إلى قول ما لم يقله.
نعود إلى بياض الحروف، وبالضبط إلى المقاطع الشعرية التي أفصحت، أو أومأت لنا بأنها تحيل على لحظة الشاعر الجمالية، وذلك بإنصاتنا إلى المناجاة – واعية أو غير واعية - مع تلك اللحظة.
وبداية العودة نسجل ملاحظة تبدو لنا في غاية من الأهمية، وهي أنه منذ مناقشتنا لمتعلقات مفهوم " الشعر " في الديوان، نعثر للمرة الأولى على مفهومين نعتبرهما صادمين:
* المفهوم الأول:
" خذي الليل كله "
وهبيني قصيدة واحدة..
تكون سماء بلون الطيف،
لطيور – من صحارى الحلم –
عائدة.(44)
بعد نظرة فاحصة في المقاطع الشعرية التي نشتغل عليها، ومقارنة بعضها ببعض، والبحث عمن يفسر بعضه البعض، استنتجنا الصورة التالية:
" أناجيك يا لحظة الشعر، خذي ليلي كله، مقابل قصيدة واحدة، تغدو مرتعا للشعراء الراغبين في العودة إلى سماء الشعر الحقيقي".
ذاك هو الحلم الذي يمكن أن يفسره، ما درجنا عليه من تأكيد حضور دلالات النبوة والولاية والفضيلة والوحي. وحتى لا أمر دون تذكير، أشير إلى أن تحليق مفهوم " الحلم " في سماء لحظة الشعر، قد يقود به إلى أن يصبح نواة تتحرك تحت جاذبيتها التيمات الشعرية في الديوان. ومن تم علينا الإجابة عن السؤال التالي:
هل يأخذ مفهوم " الحلم " بعدا رمزيا كما عرفنا ذلك عند الرمزيين؟ ونعني بذلك الحلم الذي له جانبان: " فهو من ناحية ضرب من الدربة الصوفية، وهو من ناحية أخرى منبع للخيال الشعري، والفصل بين الجانبين غير مشروع".(45)
بعض استنتاجنا لدلالة المقطع أعلاه، وإضاءتنا لحلول الحلم في لحظة الشعر، نرجئ الحديث عن رمزيته – إن وجدت- إلى حيث مقامه في فقرة لاحقة. ونستمر في أخذ ما تجود به علينا لحظة الشعر في " بياض الحروف " من مفاهيم جديدة، ربما تكون إضاءة تساعدنا على مقاربة مفهوم الشعر، كما يتصوره الشاعر:
" خذي الصباح كله"
وهبيني بنفسج الأسئلة
فأنت أرضي البكر
وقصيدتي المقبلة.(46)
هنا نجد أنفسنا أمام حوار مباشر طرفاه الشاعر والأرض البكر. ويحق لنا السؤال:
- ما تكون هذه الأرض البكر التي تم استدعاؤها هنا؟
بعد معالجة المقاطع المنتخبة، بلغ فهمنا إلى أن تلك الأرض البكر لا يمكن أن تكون إلا المعرفة؛ معرفة قادرة - بقدرة الشاعر طبعا- على أن تتخمر في لحظة الشعر، لتخرج وليدا اسمه: " القصيدة".
نخطو خطوة أخرى، نصادف فيها مقطعا شارحا ومؤكدا:
الأرض في يدي تفاحة
والعشق كتاب اكتمل
فلتسجد لمشيئتي الحروف.(47)
الزاد الثقافي شرط أساس في الشعر، وهو ما عبرنا عنه أعلاه بالمعرفة، وينسجم هذا أيضا مع ما بلغناه من استنتاجات في الفقرة التي تناولنا فيها مفهوم " الشاعر".( أدرجنا أعلاه مقطعا شعريا يصور موت الشاعر من « الغصة ».)
خلاصة القول إن التوجه نحو الشعر لا يمكن أن يتم دونما زاد معرفي يتجلى في الأثر الشعري (القصيدة).
* الثاني:
لا تقل – في اعتقادنا – أهمية المفهوم الثاني الذي كشفت عنه لحظة الشعر، عن سابقه. ولنا في اختبار أهميته سؤال:
- ما الذي تعنيه عبارة " العشق" في المقطع 47 أعلاه ؟
نبدأ بتقديم ملاحظة شكلية، نسجل فيها أن كلمة "العشق" تصدرت السطر الثاني الذي يربط دلالة السطر الأول بدلالة السطر الثالث، وإذا ما افترضنا أنها (كلمة العشق) تقع وسطا بين الأرض التفاحة( المعرفة الخصبة) وقوة الشعر الذي تم تصويره في مشهد يشبه علاقة الخالق بالخلق، أي الخضوع للمشيئة؛
أمكننا القول – بناء على الملاحظة الشكلية - إن المعادلة التي كنا نسعى إلى فك رموزها ربما أصبحت قادرة على أن تتجسد في صورة عامة، لا تحتاج إلا إلى إضاءة بسيطة لتقديمها بشكل واضح. المعادلة هي أن: " عبْر العرفان تعبُر المعرفة نحو البيان ". ما معنى هذا ؟(48).
معناه " أنه في لحظة الإبداع تعبر المعرفة روحَ الشاعر المختمرة بالإشراق فتلبس حلة الشعر". نقوم بإعادة تركيب هذا الافتراض، ونقرر أن الشعر بهذا المعنى:
"هو أن تسبغ على المعرفة إشراقا صوفيا، تعبر به من حيث هي إلى جنس الشعر".
ندرك تماما أننا هنا بصدد تجميع مؤشرات، تقربنا من مفهوم الشعر لدى الشاعر، وعلى هذا الأساس فكل تقرير نورده لا يشكل تحديدا بقدر ما هو محاولة للاقتراب منه. كما نود أن نشير إلى أن الاستنتاج الأخير المتعلق بفمهوم الشعر لدى الشاعر يواجه تحديين: الأول تمحيص مفهوم " العشق " إن كان يحمل تلك الدلالة الصوفية التي أشرنا إليها. والثاني اختباره (الاستنتاج) أمام مقاطع شعرية أخرى، لا زلنا لم نقرأها بعد، وربما تستبطن المزيد.
بخصوص مفهوم العشق يمكن أن نؤكد حضوره الصوفي مستندين على أربعة مبررات:
* الأول: ما بلغناه من حضور النبوة والولاية ممثلتين في الفضيلة.
* الثاني: علاقة الشاعر مع اللغة والقصيدة؛ العلاقة التي تحكمها المعاناة والمكابدة من جهة، والإلهام من جهة ثانية.
* الثالث: أن إحدى دلالات مفهوم " الحلم" ترتبط كما أشرنا سابقا بـ" الدربة الصوفية ".
* الرابع: أن هناك عبارات عديدة تنتمي إلى الحقل الصوفي يحفل بها الديوان.
التحدي الآن هو البحث في شكل ذلك الحضور. ويحيل على " من". ورغم أننا نسجل حضور النفري بالاسم، إلا أنه من غير الجدة أن نقرر أو نثبت نسبة مفهوم العشق إليه وحده دون تمحيص.
نحن بصدد مبحث آخر نرجئه إلى حينه. أما الآن فنواصل رحلتنا عبر الديوان، وبالضبط في لحظة الشاعر.
في برزخ الكلام
أغتسل من قروح التوحد
أدخل المخاض، فأرى بعضي
يتمرغ في صهريج،
وبعضي يقرأ صحراء الملام.(49)
يحمل إلينا هذا المقطع صورة الناسك، فالذي يُقبل على لحظة الشعر كمن يقف أمام المحراب. إن القروح النفسية الناتجة عن ازدواجية المعاناة التي أشرنا إليها سابقا، والتي تأكدت هنا بشكل صريح؛ هي التي تعجل به إلى الغرق في لحظة لا زمنية يتساوى فيها الموت بالحياة،( يمكن مقارنة هذه الصورة بصورة الفناء عند الصوفية. راجع مبحث العشق من هذه القراءة) إنها لحظة الإشراق الصوفي:
حملت جسدي المتهالك
ورميت به في نهر الحكمة
بحثا عن حمى الاحتمال
كان الماء باردا
صافيا كحلم
ترنح فيه النفري. (50)
أذكر هنا أننا سجلنا في المقطع 44 حضور مفهوم الحلم في لحظة الشعر، وسجلنا في المقطع 74 حضور مفهوم العشق في تلك اللحظة، والمقطع الذي نعالجه الآن يربط الحلم بأحد أعلام الصوفية وهو النفري. وكون النفري يترنح فيه، فإن هذا الإسناد يطرح لنا إشكال العلاقة بين الحلم والتصوف، وهو الإشكال الذي ألمحنا إليه من قبل.
تتضمن هذه الورقة مبحثا يناقش الموضوع، أما الآن فنستمر في رحلة التقصي ونقف أمام هذا المقطع القصير:
حنانيك
هذي جنان الشعر
ارتعي فيها
وفوحي.(51)
الجنان والأنثى مفهومان محوريان في الصوفية، فالأنثى ترتبط عندهم بالوجود، والطبيعة وهي أنثى موضوع التأمل بما تحويه من جمال خلاق.(52). إنها الجنان التي لا يمكن أن يصيبها الذبول، والشعر جنان فلن يموت لأنه موضوع التأمل القادر على إشباع النفس والروح:
الشعر ماء.(53)
إنه بهذا المعنى ينطلق من الذات ويعود إليها، يشفيها من قروحها..وينقيها:
..ماء يطهر البياض
يحرس الرؤيا
من خطوة عاثرة.(54)
بلملمة هذه العناصر المتناثرة هنا وهناك، تستوقفنا نظرة إلى الشعر وهي أنه تطهير وتنقية: تطهير المعرفة من منطقها الفكري لتلبس حلة الشعر من جهة، وتنقية الروح وتخليص النفس من معاناتها، من جهة أخرى. قل إننا الآن بين وظيفتين مزدوجتين للشعر: نفسية وجمالية، والمقطع التالي يجمعهما معا:
في دم الريبة..
أقيم صلاتي
خطوة الشعر الغريبة
تفلي حياتي
من ظلي تتفتق كل عجيبة
كي أنام في مماتي
وقد أدفأتني
الكِلْمة الخصيبة.(55)
نعود إلى الوراء جدا ونستحضر ما قلناه من أن الشعر "هو أن تسبغ على المعرفة إشراقا صوفيا، تعبر بها إلى جنس الشعر". نسجل تقيصة هذه الإضاءة في كوننا حصرنا العرفان في إعادة أنتاج المعرفة شعريا، في حين أكد لنا المقطع أعلاه أنه ( العرفان) يتجاوز هذه الوظيفة إلى ما يتعلق بذات الشاعر، أي إلى وظيفة تنفيسية.
أعتقد أننا الآن أمام صورة غير مضببة لمفهوم الشعر، كما يتصوره صاحب بياض الحروف. وإن كانت لحظة الشعر قد كشفت لنا عما يمكن أن نعتبره جوهريا في تصور الشاعر، إلا أن البحث في مسائل اللغة ( وضمنها البلاغة)، والقصيدة، والشاعر، لا يمكن أن نغفل ما جادت به علينا من إضاءات تساعدنا على تمثل واضح للمسألة. وأرى في هذه النقطة بالذات أن ألخص أهم ما توصلنا إليه، لنعود في كلمة أخيرة إلى تركيب الأجزاء وطرح السؤال الذي نراه قمينا بتوجيه البحث نحو مساره الذي تبناه.
أ- كشفت لنا المقاطع الشعرية التي اعتبرناها إشارات على لحظة الشعر؛ عن أمور هامة نلخصها فيما يلي:
* المعرفة أو الزاد الثقافي الخصب شرط من شروط الشعر.
* الشعر معرفة خضعت لتنقية أثناء اللحظة الشعرية.
* الإشراق العرفاني الصوفي المرتبط حضوره باللحظة الشعرية هو من تناط به مهمة تنقية المعرفة.
* لهذا الإشراق دور آخر وهو تطهير روح الشاعر من المعاناة المزدوجة، معاناة نتيجة اختلاف نظرته لمفهوم الشعر عن بني فنه، ومعاناة ثانية ناتجة عن مخاض القصيدة.
ب- بخصوص اللغة، وقفنا على كيف تجاوزَ الشعر البلاغة، واحتفظ منها فقط بالاستعارة والمجاز لقربهما من حقيقة الشعر- حسب تصور الشاعر - حقيقة الوحي المرتبط بالمعاناة. ورأينا كيف أن لغة كهذه لا يمكن أن تكون ظاهرة، بل هي لغة باطنة يجب الكشف عن عورتها، وإن اقتضى الأمر تجاوز منطقها.ثالثا: مفهوم الشاعر: ( النبوة والولاية/القضية ونقد الواقع)
وكما تعودنا أن نبدأ بالملاحظات، نسجل هنا أن هذا المفهوم يحضر مرة كذات، ومرة أخرى من خلال ذوات الشعراء، وكأننا بصدد شاعرين لا شاعر واحد. غير أن معالجة هذه الملاحظة في ذاتها لا تدخل البتة ضمن هذه القراءة. وإنما نسجلها لأننا ننبه إلى الاختلاف الذي قد يحسه المتلقي في عملية استكناه مفهوم الشاعر، من مقطع شعري يتجسد فيه كذات، ومقطع آخر يتجسد فيه من خلال ذوات الشعراء. أما المعطى الذي نفتح به هذه المناقشة، فنقرؤه في المقطع التالي:
مني تبدأ الشفاعة
وأتباعي الجدد شعراء
أصفياء.(33)
لا أحد يتأمل هذا المقطع ويجادل في خصوبته، أعني نه يفتح لنا آفاق عدة للقراءة، غير أننا لم نورده في هذه اللحظة بالذات لتأكيد ذلك، بل مسعانا هو أن نؤمِّن لهذه القراءة مسارها الذي خططته. نسجل بدايةً أن لفظتي " الشفاعة " و"أصفياء" لهما ما يحيل عليهما فيما أوردناه أعلاه، الفرق أن هذه المرة يكشفان عن هويتهما، بل ويحيلان دونما تخفٍّ عن مفهومي النبوة أو الولاية. لنقل بوضوح إن الشاعر إما نبي أو ولي، والجامع بينهما التميز عن الآخرين، والفرق في الدرجة فقط. وإن كنا نفهم من هذا الكلام أن هناك شاعرين، الثاني يقتفي أثر الأول لبلوغ مرتبته، فالذي يهمنا هنا هو دلالة اللفظتين، خاصة وأن حضورهما يتأكد أكثر من مرة في الديوان، وهذا واحد من ذلك الحضور، يقلب الصورة كصيغة من صيغ التأكيد:
في كل نبي شاعر
ينشر ضوء الفضيلة
في ليل المقابر.
يروي صحراء القبيلة
من قلبه الطاهر
يلم بين كفيه
شتاتنا القاهر
فتزهر في فيافينا حكمتُه الجليلة.(34)
الفضيلة إذن هي القاسم المشترك بين النبي والولي والشاعر، فضيلة تجمع الشتات الإنساني ليصغي إلى جلال الحكمة التي بها تغدو الحياة زهرة تتفتق في الأرض اليباب. نسلم مبدئيا أن هذه الفكرة ليست جديدة، في الشعرية العربية، إذ أن المتنبي دعا فنيا الأمة العربية إلى أن تجتمع على شعره، مثلما اجتمعت من قبل على قرآن محمد (ص)، وهي حقيقة أكدتها أكثر من دراسة لشعر المتنبي وملابساته السياسية، واستحضار هذه الواقعة من خلال دلالة المقطع الذي ندرسه، تفيدنا في فهم أشياء أصيلة في مفهوم الشاعر، إنه بهذا المعنى ليس من يعبّر جماليا عما يخالجه، بل صاحب الموقف والقضية، يعيش في خوف دائم من أن تضيع منه فيضيع هو الآخر:
فكيف أبارك زمني
وقد أضاعتني القبيلة؟
أفتش عني في المرايا
في قواميس الكلام
لا أجد غير بقايا عليلة
ضرجت بدم الكلام.(35)
يضيع الشاعر – إذاً - حين تكون الآذان صماء، لا تصغي إلى القضية التي يحملها، حينذاك ترتد الذات لتعيش عزلتها ومأساتها:
وحدك تغالب الريح
تشق السماء نصفين.
أنت..
أيها الشاعر
ترقب الوقت القاحل
تجمع الطرق
في عروة واحدة
لتقرأ الأرض مرتين.(36)
إن الخوف الدائم للشاعر من أن تضيع منه قضيته – كيفما كانت تلك القضية – هو ما يفسر التعبير الدائم عن المعاناة، تتجسد نفسيا في الحرقة والألم:
ها الينابيع في هذه البلاد
قد جفت
وها أنت تغرق
في حوض البلاهة
ليس لك من زاد
غير حرقة النشيد.(37)
غياب الصدى تضيع معه القضية التي يحملها الشاعر، بمعنى آخر، نحن الآن لسنا بصدد معاناة داخلية فحسب، بل أمام نقد لواقع إبداعي، ثقافي بشكل عام، وهذا جانب وظيفي لا يخفى:
داخل خزانة الكتب
صراخ وعويل نساء
شعراء وفلاسفة
يتحاورون في الغيب
أما نحن المعلقون
على أبواب الحياة
فنبتسم لهذا الضجيج.(38)
هل نحن أمام أزمة شعر؟ إن كان الأمر كذلك، فليس وراءها إلا أهله، أولئك الذين لم يعودوا يحملون قضايا مرتبطة بالحياة بل بالغيب..وبلغت الأزمة حالها السيئة، حين غدا الفن عامة - والشعر من الفن - إما اجترارا للمطروق، أو غموضا يتم التحايل به على المتلقي وخداعُه، أو خارجا عن أخلاق الفن. حري إذن أن:
نحكي عن الشاعر
الذي مات
- من الرجفة –
على المنصة..
" شقيت بي العبارة "
..مات وفي نفسه
غصة. (39)
مات لأنه سمع:
المسرحي
الذي يتسول السجائر
يتبول
- ليلا -
على جدران المسرح البلدي،
يسرق النصَّ.(40)
وسمع كذلك:
عن الروائي التائه
على أبواب النقد
يستجدي السادة الكرام
بصة.(41)
دعونا الآن نسجل مشهد المعاناة في صورته المكتملة؛ إنها معاناة مزدوجة: شقها ناتج عما آل إليه المشهد الشعري المتهاوي، والشق الثاني مع القصيدة. كشفنا من الأولى ما أسَرَّه لنا النص من إحالات وإشارات، أما الثانية ( المعاناة مع القصيدة) فهي موضوع الفقرة الموالية. وقبل ذلك دعونا نركب الأجزاء السابقة ونقول: إن تصور بياض الحروف لمفهوم الشاعر قائم على العناصر التالية:
أ- النبوة والولاية، وعبرهما يتحدد البعد الأخلاقي في الشعر من خلال الشاعر الفاضل.
ب- القضية ونقد الواقع، وبهما يتعدد البعد النفسي، إذ تعيش الذات في معاناة جراء الخوف الدائم وما يحدثه من حرقة وألم. سيقربنا منها أكثر الحديث عن لحظة الشعر.
رابعا- لحظة الشعر أو (اللحظة الجمالية):
لعل البحث في مفهوم " اللحظة الجمالية " يعتبر من أكثر البحوث ثراء وتعقيدا في الوقت نفسه، نظرا لتعدد الحقول المعرفية التي نما فيها، وأهمها على وجه الخصوص الفلسفة وعلم الجمال والنقد الفني والنقد الأدبي. ولتقريب تصورنا لمفهوم لحظة الشعر الذي نقترحه هنا، ننطلق من الفكرة البسيطة التالية: " أنا أمام أثر فني أريد أن أقرأه "، إن ذلك الأثر أُنتج في لحظة إبداعية، نسميها اللحظة الجمالية لدى المبدع. والقارئ حين يقدم على النص لقراءته فهو يدخل أيضا في لحظته الشعرية متلقيا ومنتجا من مبدإ إحساس بالجمال. نقول " إن انخطاف الفنان واندماجَه الوجودي في التجربة الفنية هو جوهر اللحظة الجمالية التي تسبق الإبداع".(42) المبدع والمتلقي كلاهما إذن يعيش لحظة لا زمنية، مثلهما مثل المستمع إلى الموسيقى والمشاهد لفيلم. غير أنه إذا كانت تلك اللحظة قد لقيت عناية كبيرة حين يتعلق الأمر بالمتلقي، إلا أنها – وحسب بعض الباحثين - لم تحظ بالاهتمام نفسه عند المبدع، وهذا يعود – كما يرى الباحث نفسه - إلى صعوبة الدخول واستكناه تجربة غير ذاتية.(43)
وعيا منا بهذا الإشكال فإن اشتغالنا على مفهوم لحظة الشعر في الأثر الشعري " بياض الحروف " لا يمكن أن يخلو من نقائص، قد تكون حافزا على المزيد من البحث. غير أننا سنسعى جاهدين إلى أن نبقى أوفياء للمنهج الذي تبنيناه سابقا من ألا ندفع بالنص إلى قول ما لم يقله.
نعود إلى بياض الحروف، وبالضبط إلى المقاطع الشعرية التي أفصحت، أو أومأت لنا بأنها تحيل على لحظة الشاعر الجمالية، وذلك بإنصاتنا إلى المناجاة – واعية أو غير واعية - مع تلك اللحظة.
وبداية العودة نسجل ملاحظة تبدو لنا في غاية من الأهمية، وهي أنه منذ مناقشتنا لمتعلقات مفهوم " الشعر " في الديوان، نعثر للمرة الأولى على مفهومين نعتبرهما صادمين:
* المفهوم الأول:
" خذي الليل كله "
وهبيني قصيدة واحدة..
تكون سماء بلون الطيف،
لطيور – من صحارى الحلم –
عائدة.(44)
بعد نظرة فاحصة في المقاطع الشعرية التي نشتغل عليها، ومقارنة بعضها ببعض، والبحث عمن يفسر بعضه البعض، استنتجنا الصورة التالية:
" أناجيك يا لحظة الشعر، خذي ليلي كله، مقابل قصيدة واحدة، تغدو مرتعا للشعراء الراغبين في العودة إلى سماء الشعر الحقيقي".
ذاك هو الحلم الذي يمكن أن يفسره، ما درجنا عليه من تأكيد حضور دلالات النبوة والولاية والفضيلة والوحي. وحتى لا أمر دون تذكير، أشير إلى أن تحليق مفهوم " الحلم " في سماء لحظة الشعر، قد يقود به إلى أن يصبح نواة تتحرك تحت جاذبيتها التيمات الشعرية في الديوان. ومن تم علينا الإجابة عن السؤال التالي:
هل يأخذ مفهوم " الحلم " بعدا رمزيا كما عرفنا ذلك عند الرمزيين؟ ونعني بذلك الحلم الذي له جانبان: " فهو من ناحية ضرب من الدربة الصوفية، وهو من ناحية أخرى منبع للخيال الشعري، والفصل بين الجانبين غير مشروع".(45)
بعض استنتاجنا لدلالة المقطع أعلاه، وإضاءتنا لحلول الحلم في لحظة الشعر، نرجئ الحديث عن رمزيته – إن وجدت- إلى حيث مقامه في فقرة لاحقة. ونستمر في أخذ ما تجود به علينا لحظة الشعر في " بياض الحروف " من مفاهيم جديدة، ربما تكون إضاءة تساعدنا على مقاربة مفهوم الشعر، كما يتصوره الشاعر:
" خذي الصباح كله"
وهبيني بنفسج الأسئلة
فأنت أرضي البكر
وقصيدتي المقبلة.(46)
هنا نجد أنفسنا أمام حوار مباشر طرفاه الشاعر والأرض البكر. ويحق لنا السؤال:
- ما تكون هذه الأرض البكر التي تم استدعاؤها هنا؟
بعد معالجة المقاطع المنتخبة، بلغ فهمنا إلى أن تلك الأرض البكر لا يمكن أن تكون إلا المعرفة؛ معرفة قادرة - بقدرة الشاعر طبعا- على أن تتخمر في لحظة الشعر، لتخرج وليدا اسمه: " القصيدة".
نخطو خطوة أخرى، نصادف فيها مقطعا شارحا ومؤكدا:
الأرض في يدي تفاحة
والعشق كتاب اكتمل
فلتسجد لمشيئتي الحروف.(47)
الزاد الثقافي شرط أساس في الشعر، وهو ما عبرنا عنه أعلاه بالمعرفة، وينسجم هذا أيضا مع ما بلغناه من استنتاجات في الفقرة التي تناولنا فيها مفهوم " الشاعر".( أدرجنا أعلاه مقطعا شعريا يصور موت الشاعر من « الغصة ».)
خلاصة القول إن التوجه نحو الشعر لا يمكن أن يتم دونما زاد معرفي يتجلى في الأثر الشعري (القصيدة).
* الثاني:
لا تقل – في اعتقادنا – أهمية المفهوم الثاني الذي كشفت عنه لحظة الشعر، عن سابقه. ولنا في اختبار أهميته سؤال:
- ما الذي تعنيه عبارة " العشق" في المقطع 47 أعلاه ؟
نبدأ بتقديم ملاحظة شكلية، نسجل فيها أن كلمة "العشق" تصدرت السطر الثاني الذي يربط دلالة السطر الأول بدلالة السطر الثالث، وإذا ما افترضنا أنها (كلمة العشق) تقع وسطا بين الأرض التفاحة( المعرفة الخصبة) وقوة الشعر الذي تم تصويره في مشهد يشبه علاقة الخالق بالخلق، أي الخضوع للمشيئة؛
أمكننا القول – بناء على الملاحظة الشكلية - إن المعادلة التي كنا نسعى إلى فك رموزها ربما أصبحت قادرة على أن تتجسد في صورة عامة، لا تحتاج إلا إلى إضاءة بسيطة لتقديمها بشكل واضح. المعادلة هي أن: " عبْر العرفان تعبُر المعرفة نحو البيان ". ما معنى هذا ؟(48).
معناه " أنه في لحظة الإبداع تعبر المعرفة روحَ الشاعر المختمرة بالإشراق فتلبس حلة الشعر". نقوم بإعادة تركيب هذا الافتراض، ونقرر أن الشعر بهذا المعنى:
"هو أن تسبغ على المعرفة إشراقا صوفيا، تعبر به من حيث هي إلى جنس الشعر".
ندرك تماما أننا هنا بصدد تجميع مؤشرات، تقربنا من مفهوم الشعر لدى الشاعر، وعلى هذا الأساس فكل تقرير نورده لا يشكل تحديدا بقدر ما هو محاولة للاقتراب منه. كما نود أن نشير إلى أن الاستنتاج الأخير المتعلق بفمهوم الشعر لدى الشاعر يواجه تحديين: الأول تمحيص مفهوم " العشق " إن كان يحمل تلك الدلالة الصوفية التي أشرنا إليها. والثاني اختباره (الاستنتاج) أمام مقاطع شعرية أخرى، لا زلنا لم نقرأها بعد، وربما تستبطن المزيد.
بخصوص مفهوم العشق يمكن أن نؤكد حضوره الصوفي مستندين على أربعة مبررات:
* الأول: ما بلغناه من حضور النبوة والولاية ممثلتين في الفضيلة.
* الثاني: علاقة الشاعر مع اللغة والقصيدة؛ العلاقة التي تحكمها المعاناة والمكابدة من جهة، والإلهام من جهة ثانية.
* الثالث: أن إحدى دلالات مفهوم " الحلم" ترتبط كما أشرنا سابقا بـ" الدربة الصوفية ".
* الرابع: أن هناك عبارات عديدة تنتمي إلى الحقل الصوفي يحفل بها الديوان.
التحدي الآن هو البحث في شكل ذلك الحضور. ويحيل على " من". ورغم أننا نسجل حضور النفري بالاسم، إلا أنه من غير الجدة أن نقرر أو نثبت نسبة مفهوم العشق إليه وحده دون تمحيص.
نحن بصدد مبحث آخر نرجئه إلى حينه. أما الآن فنواصل رحلتنا عبر الديوان، وبالضبط في لحظة الشاعر.
في برزخ الكلام
أغتسل من قروح التوحد
أدخل المخاض، فأرى بعضي
يتمرغ في صهريج،
وبعضي يقرأ صحراء الملام.(49)
يحمل إلينا هذا المقطع صورة الناسك، فالذي يُقبل على لحظة الشعر كمن يقف أمام المحراب. إن القروح النفسية الناتجة عن ازدواجية المعاناة التي أشرنا إليها سابقا، والتي تأكدت هنا بشكل صريح؛ هي التي تعجل به إلى الغرق في لحظة لا زمنية يتساوى فيها الموت بالحياة،( يمكن مقارنة هذه الصورة بصورة الفناء عند الصوفية. راجع مبحث العشق من هذه القراءة) إنها لحظة الإشراق الصوفي:
حملت جسدي المتهالك
ورميت به في نهر الحكمة
بحثا عن حمى الاحتمال
كان الماء باردا
صافيا كحلم
ترنح فيه النفري. (50)
أذكر هنا أننا سجلنا في المقطع 44 حضور مفهوم الحلم في لحظة الشعر، وسجلنا في المقطع 74 حضور مفهوم العشق في تلك اللحظة، والمقطع الذي نعالجه الآن يربط الحلم بأحد أعلام الصوفية وهو النفري. وكون النفري يترنح فيه، فإن هذا الإسناد يطرح لنا إشكال العلاقة بين الحلم والتصوف، وهو الإشكال الذي ألمحنا إليه من قبل.
تتضمن هذه الورقة مبحثا يناقش الموضوع، أما الآن فنستمر في رحلة التقصي ونقف أمام هذا المقطع القصير:
حنانيك
هذي جنان الشعر
ارتعي فيها
وفوحي.(51)
الجنان والأنثى مفهومان محوريان في الصوفية، فالأنثى ترتبط عندهم بالوجود، والطبيعة وهي أنثى موضوع التأمل بما تحويه من جمال خلاق.(52). إنها الجنان التي لا يمكن أن يصيبها الذبول، والشعر جنان فلن يموت لأنه موضوع التأمل القادر على إشباع النفس والروح:
الشعر ماء.(53)
إنه بهذا المعنى ينطلق من الذات ويعود إليها، يشفيها من قروحها..وينقيها:
..ماء يطهر البياض
يحرس الرؤيا
من خطوة عاثرة.(54)
بلملمة هذه العناصر المتناثرة هنا وهناك، تستوقفنا نظرة إلى الشعر وهي أنه تطهير وتنقية: تطهير المعرفة من منطقها الفكري لتلبس حلة الشعر من جهة، وتنقية الروح وتخليص النفس من معاناتها، من جهة أخرى. قل إننا الآن بين وظيفتين مزدوجتين للشعر: نفسية وجمالية، والمقطع التالي يجمعهما معا:
في دم الريبة..
أقيم صلاتي
خطوة الشعر الغريبة
تفلي حياتي
من ظلي تتفتق كل عجيبة
كي أنام في مماتي
وقد أدفأتني
الكِلْمة الخصيبة.(55)
نعود إلى الوراء جدا ونستحضر ما قلناه من أن الشعر "هو أن تسبغ على المعرفة إشراقا صوفيا، تعبر بها إلى جنس الشعر". نسجل تقيصة هذه الإضاءة في كوننا حصرنا العرفان في إعادة أنتاج المعرفة شعريا، في حين أكد لنا المقطع أعلاه أنه ( العرفان) يتجاوز هذه الوظيفة إلى ما يتعلق بذات الشاعر، أي إلى وظيفة تنفيسية.
أعتقد أننا الآن أمام صورة غير مضببة لمفهوم الشعر، كما يتصوره صاحب بياض الحروف. وإن كانت لحظة الشعر قد كشفت لنا عما يمكن أن نعتبره جوهريا في تصور الشاعر، إلا أن البحث في مسائل اللغة ( وضمنها البلاغة)، والقصيدة، والشاعر، لا يمكن أن نغفل ما جادت به علينا من إضاءات تساعدنا على تمثل واضح للمسألة. وأرى في هذه النقطة بالذات أن ألخص أهم ما توصلنا إليه، لنعود في كلمة أخيرة إلى تركيب الأجزاء وطرح السؤال الذي نراه قمينا بتوجيه البحث نحو مساره الذي تبناه.
أ- كشفت لنا المقاطع الشعرية التي اعتبرناها إشارات على لحظة الشعر؛ عن أمور هامة نلخصها فيما يلي:
* المعرفة أو الزاد الثقافي الخصب شرط من شروط الشعر.
* الشعر معرفة خضعت لتنقية أثناء اللحظة الشعرية.
* الإشراق العرفاني الصوفي المرتبط حضوره باللحظة الشعرية هو من تناط به مهمة تنقية المعرفة.
* لهذا الإشراق دور آخر وهو تطهير روح الشاعر من المعاناة المزدوجة، معاناة نتيجة اختلاف نظرته لمفهوم الشعر عن بني فنه، ومعاناة ثانية ناتجة عن مخاض القصيدة.
ج- فيما يتعلق بمفهوم القصيدة، وقفنا على أنها تلك العلاقة القائمة على تداخل البياض والسواد، وهي تجسيد حسي للحظة تتناغم فيها الأفكار والتصورات في ذهن الشاعر وروحه، أو قل هي تجسيد حسي لتلك اللحظة.
د- أما مفهوم الشاعر - مركزين هنا على المقاطع الشعرية التي تحيل عليه كمفهوم لا كذات- فقد وقفنا على صورة النبوة أو الولاية فيه. وأن المشترك بينهما هو الفضيلة من جهة، وتمسك الشاعر بالقضية من جهة ثانية، نضيف إليهما عنصرين آخرين هما بمثابة نتيجة معانقة التجربة، ونعني بذلك: الضياع والألم.
خاتمة القول:
نعتقد أنه يمكننا الآن أن نغامر في لملمة تلك الأجزاء، لتشكيل صورة تلامس مفهوم الشعر في ديوان بياض الحروف، نلامس المفهوم لا كما تجسد إبداعيا في الديوان،( فهذا مبحث آخر) بل كما صرح به الديوان نفسه. قل إننا بصدد تشريح تصريحات صيغتْ شعرا. على أننا نعي أن ثمة منطقة محظورة لا يمكن دخولها، إنها منطقة التحديد..لذا نعود ونؤكد أننا نلامس..لا نلمس.
الشعر في تصور بياض الحروف – بناء على ما سبق- هو " أن يسبغ الشاعر - في معاناة ومكابدة- جمالا على المعرفة التي يحملها، ويتأتى له ذلك في لحظة توحد غامرة بالإشراق والفضيلة، تناط بها مهمة تنقية تلك المعرفة، وتطهير لغتها من شوائب منطقها ".
والسؤال الذي يتطلب جهدا كبيرا في معالجته هو: كيف تجسد هذا المفهوم حسيا في الديوان؟ بعبارة أخرى ما مدى انسجام التصور مع بناء النص الشعري؟ مبحث خصصنا له القسم الأخير من هذه الورقة.
نعتقد أنه يمكننا الآن أن نغامر في لملمة تلك الأجزاء، لتشكيل صورة تلامس مفهوم الشعر في ديوان بياض الحروف، نلامس المفهوم لا كما تجسد إبداعيا في الديوان،( فهذا مبحث آخر) بل كما صرح به الديوان نفسه. قل إننا بصدد تشريح تصريحات صيغتْ شعرا. على أننا نعي أن ثمة منطقة محظورة لا يمكن دخولها، إنها منطقة التحديد..لذا نعود ونؤكد أننا نلامس..لا نلمس.
الشعر في تصور بياض الحروف – بناء على ما سبق- هو " أن يسبغ الشاعر - في معاناة ومكابدة- جمالا على المعرفة التي يحملها، ويتأتى له ذلك في لحظة توحد غامرة بالإشراق والفضيلة، تناط بها مهمة تنقية تلك المعرفة، وتطهير لغتها من شوائب منطقها ".
والسؤال الذي يتطلب جهدا كبيرا في معالجته هو: كيف تجسد هذا المفهوم حسيا في الديوان؟ بعبارة أخرى ما مدى انسجام التصور مع بناء النص الشعري؟ مبحث خصصنا له القسم الأخير من هذه الورقة.
إحالات وهوامش الفصل الأول
*عبد الرزاق جبران. عضو اتحاد كتاب المغرب. شاعر وقاص وناقد مغربي. من مؤلفاته: بياض الحروف(شعر) ديوان أسماء(شعر). قبور في مظلة( مجموعة قصصية قيد الطبع). شارك في عدة ملتقيات وطنية وعربية حول الشعر والرواية. نشر مقالات في عدة جرائد ومجلات وطنية وعربية.
** نساهم في الملتقى بهذا المقال الذي هو جزء من دراسة شاملة للديوان، تشمل مواضيع أخرى كالحلم الرمزي وعلاقته بالعشق الصوفي، وأشكال التناص. ولم ندرج الدراسة كاملة ليس ضنا منا بها بل – فقط - لأنها لا زالت تخضع للمراجعة العلمية والأدبية.
1- اعتدال عثمان. إضاءة النص.دار الحداثة.ط:1. 1988)
2- حسين الواد.في مناهج الدراسات الأدبية.منشورات الجامعة.مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر" بنميد"1989. ص: 27
3- رشيد يحياوي.قصيدة النثر العربية أو خطاب الأرض المحروقة.إفريقيا الشرق 2008 ص:14
4- عبد الفتاح كيليطو. الأدب والغرابة. دار توبقال للنشر. ط 3 . 2006. ص: 28.
5- عبد الرحمان محمد العقود. الإبهام في شعر الحداثة.عالم المعرفة.ع:279. ص:121
6- الشعر العربي الحديث. أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقافي الثاني عشر.10-12 ديسمبر 2005. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.ص:124** نساهم في الملتقى بهذا المقال الذي هو جزء من دراسة شاملة للديوان، تشمل مواضيع أخرى كالحلم الرمزي وعلاقته بالعشق الصوفي، وأشكال التناص. ولم ندرج الدراسة كاملة ليس ضنا منا بها بل – فقط - لأنها لا زالت تخضع للمراجعة العلمية والأدبية.
1- اعتدال عثمان. إضاءة النص.دار الحداثة.ط:1. 1988)
2- حسين الواد.في مناهج الدراسات الأدبية.منشورات الجامعة.مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر" بنميد"1989. ص: 27
3- رشيد يحياوي.قصيدة النثر العربية أو خطاب الأرض المحروقة.إفريقيا الشرق 2008 ص:14
4- عبد الفتاح كيليطو. الأدب والغرابة. دار توبقال للنشر. ط 3 . 2006. ص: 28.
5- عبد الرحمان محمد العقود. الإبهام في شعر الحداثة.عالم المعرفة.ع:279. ص:121
7- محمد عابد الجابري. نقد العقل العربي2. بنية العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. ط 8 بيروت 2008
8- المرجع نفسه والصفحة نفسها.
9- للمزيد من المعلومات: -RORERT :dictionnaire de la langue française.les dictionnaires le Robert .2eme édition. Paris 1989.tom 5 p :4390
10- رشيد يحياوي. مرجع سابق. ص: 152
11- حول النظرية النقدية البديلة عن النظرية الغربية. يراجع كتاب: الخروج من التيه. عبد العزيز حمودة. عالم المعرفة. عدد: 298. نونبر 2003
12- عبد القادر الغزالي. قصيدة النثر العربية. الأسس النظرية والبنيات النصية. مطبعة تريفة بركان. المغرب. ط:1. 2007
13- المرجع نفسه. ص: 31
14- المرجع نفسه. ونحيل هنا إلى محتوى الخاتمة.
15- الإحالة نفسها.
16- السرد الشعري وشعرية ما بعد الحداثة. قراءة في " مهمل.." علاء عبد الهادي. أ.د. عبد الرحمان عبد السلام. بحث دكتوراه.
17- المرجع نفسه. ص:4
18- المرجع نفسه.ص:10
19- المرجع نفسه. ص: 125
20- أنظر الصور العقلية للتشبيه عند محمد عابد الجابري.( مرجع مذكور)
21- لا نقصد هنا المنطق الصوري الأرسطي، بل نقصد السمة العقلية التي يخضع لها التشبيه في البلاغة ومثاله القياس في الفقه.
22- ديوان بياض الحروف. ص: 11
23- الديوان. ص:88
24- المرجع نفسه. ص:10
25- المرجع والصفحة.
26- يتحدث الشاعر أيضا عن لغة الإيديولوجي، غير أن هذه القراءة لا تعنى بهذا المنظور للغة. نقرأ مثلا في.ص:30-31
كل لغة كهنة وساسة
واحد يطمس وجه الله
والثاني نخاس
يعتلي عرش الخساسة
27- ص: 22
28- ص: 37
29- ص:41
30.ص:82
31- ص: 92
32- ص: 125
33- ص: 10
34- ص: 32
35- ص: 16
36- ص:86
37- ص: 88
38- ص: 93
39- ص: 103
40- ص: 104
41- ص: 104
42- عالم الفكر. المجلد 35. يوليو- سبتمبر. 2006. ص: 16.
43المرجع نفسه ص: 18.
44- ص: 15
45- للمزيد: د. محمد فتوح أحمد. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر.دار المعارف. ط:3. 1984.ص: 115.
46-الديوان. ص: 17
47- ص: 22
48- لا نعالج مفهومي العرفان والبيان كما عالجهما محمد عابد الجابري( مرجع سابق) - إلى جانب مفهوم البرهان – كمفاهيم مؤطرة لثلاثة علوم: علوم البيان وعلوم البرهان وعلوم العرفان.
49- الديوان. ص: 21
50. ص: 65
51- ص: 85
52- راجع مثلا الأنوثي الخلاق عند ابن عربي في: الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي. هنري كوريان. ترجمة فريد الزاهي.منشورات مرسم.2006" حسب رقم الإيداع". ص:142 وما بعدها).
53- الديوان ص: 11
54- الصفحة نفسها.
55- ص: 76
[/frame]8- المرجع نفسه والصفحة نفسها.
9- للمزيد من المعلومات: -RORERT :dictionnaire de la langue française.les dictionnaires le Robert .2eme édition. Paris 1989.tom 5 p :4390
10- رشيد يحياوي. مرجع سابق. ص: 152
11- حول النظرية النقدية البديلة عن النظرية الغربية. يراجع كتاب: الخروج من التيه. عبد العزيز حمودة. عالم المعرفة. عدد: 298. نونبر 2003
12- عبد القادر الغزالي. قصيدة النثر العربية. الأسس النظرية والبنيات النصية. مطبعة تريفة بركان. المغرب. ط:1. 2007
13- المرجع نفسه. ص: 31
14- المرجع نفسه. ونحيل هنا إلى محتوى الخاتمة.
15- الإحالة نفسها.
16- السرد الشعري وشعرية ما بعد الحداثة. قراءة في " مهمل.." علاء عبد الهادي. أ.د. عبد الرحمان عبد السلام. بحث دكتوراه.
17- المرجع نفسه. ص:4
18- المرجع نفسه.ص:10
19- المرجع نفسه. ص: 125
20- أنظر الصور العقلية للتشبيه عند محمد عابد الجابري.( مرجع مذكور)
21- لا نقصد هنا المنطق الصوري الأرسطي، بل نقصد السمة العقلية التي يخضع لها التشبيه في البلاغة ومثاله القياس في الفقه.
22- ديوان بياض الحروف. ص: 11
23- الديوان. ص:88
24- المرجع نفسه. ص:10
25- المرجع والصفحة.
26- يتحدث الشاعر أيضا عن لغة الإيديولوجي، غير أن هذه القراءة لا تعنى بهذا المنظور للغة. نقرأ مثلا في.ص:30-31
كل لغة كهنة وساسة
واحد يطمس وجه الله
والثاني نخاس
يعتلي عرش الخساسة
27- ص: 22
28- ص: 37
29- ص:41
30.ص:82
31- ص: 92
32- ص: 125
33- ص: 10
34- ص: 32
35- ص: 16
36- ص:86
37- ص: 88
38- ص: 93
39- ص: 103
40- ص: 104
41- ص: 104
42- عالم الفكر. المجلد 35. يوليو- سبتمبر. 2006. ص: 16.
43المرجع نفسه ص: 18.
44- ص: 15
45- للمزيد: د. محمد فتوح أحمد. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر.دار المعارف. ط:3. 1984.ص: 115.
46-الديوان. ص: 17
47- ص: 22
48- لا نعالج مفهومي العرفان والبيان كما عالجهما محمد عابد الجابري( مرجع سابق) - إلى جانب مفهوم البرهان – كمفاهيم مؤطرة لثلاثة علوم: علوم البيان وعلوم البرهان وعلوم العرفان.
49- الديوان. ص: 21
50. ص: 65
51- ص: 85
52- راجع مثلا الأنوثي الخلاق عند ابن عربي في: الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي. هنري كوريان. ترجمة فريد الزاهي.منشورات مرسم.2006" حسب رقم الإيداع". ص:142 وما بعدها).
53- الديوان ص: 11
54- الصفحة نفسها.
55- ص: 76
المشاركة الثانية
الأستاذة نجية يوسف
[frame="6 10"]
قراءة في كتيب الأستاذ حسين ليشوري [ جراحة الأفكار بين المدارسة والممارسة ، غير أني لم أجد للأستاذ سيرة ذاتية هنا في الملتقى لأشفع بها بحثي هذا وكل ما لدي الآن صورته التي تكرّم علينا بوضعها في الملتقى .
****************
وإنني لأبدأ قائلة ما أنا في هذه القراءة إلا طويلبة علم تتلمذ على أيدي أساتذة لهم الحق كل الحق في النقد والتوجيه . وعذرا إن جاء في قراءتي هذه خلل أو قصور .
************************
القراءة :
إن أول ما لفت انتباهي في دراسته هذه مقدمتها والسبب فيها ، وهو ما يراه القارئ نتاجا لحالة التزام فكري وأدبي يربط بين الكاتب ووطنه ، وقد لا أقصد مفهوم الوطن الخاص بقدر ما أقصد من مفهوم وطن يجمع بين المرء ومحيطه ومعتقده في بوتقة واحدة ، وطن الجسد ووطن العقيدة والفكر . لنرى أنفسنا وقد ولجنا إلى عالم المسؤولية نحو ما نعيش من أحداث وتأثيرها الفكري والاجتماعي بل وفي صبغ الحراك السياسي لمن وقعت عليهم وهذا الحراك الذي يُنظر إليه بعين الريبة من المتنفذين وأرباب السلطان ليقفوا من بعد في وجه ذلك الحراك إذا كان غير منضوٍ تحت راياتهم .
من هنا وجدناه يبدأ بحثه قائلا :
من هنا وجدناه يبدأ بحثه قائلا :
ولا بد لفهم مقاصد هذه المقدمة من استحضار ظروف سنوات الجمر التي عشناها - نحن الجزائريين - في التسعينيات و التي لا نزال نعاني مخلفاتها حتى اليوم ولا تزال عقابيلها بادية للعيان، و من ثم ندرك أهمية البحث في مثل هذا الموضوع و نفهم ملابساته في تلك الفترة العصيبة من حاضر الجزائر!
***********
يظل الوطن هو ما يستوطننا فكرا وعاطفة ونظل باحثين عن هوية له قادرة على أن تنافس هؤلاء الذين بسطوا علينا عباءة وجودهم ،هوية تجعلنا قادرين على التأثير الفاعل بذات القدر على التأثر الملغي ، ويستحضرني هنا مقولة الكاتب نفسه التي يرددها في كثير من مداخلاته وردوده :
[ دمت على التواصل الذي يُغني و لا يُلغي. ]
[ دمت على التواصل الذي يُغني و لا يُلغي. ]
وإذا ما تجاوزنا هذه المقدمة التي بنى عليها بحثه إلى متابعة عناصر البحث وجدناه يقوم على :
استعارة الفكرة ـ جراحة الأفكار ـ من المحسوس وتطبيقها على المعنوي حين جعل من الأفكار جسوما يمكن إخضاعها للرؤية و اللمس و الجس و من ثم إجراء العمليات الجراحية التصحيحية عليها ـ كما قال ـ
وقد فصل لنا فكرة بحثه القائمة على :
الموضوع : الإنسان،
المادة : الأفكار
الكيفية والوسيلة : الإقناع بقوة الحجة و ليس بحجة القوة، و السلوك الحسن و النصيحة بالحسنى و غيرها من وسائل التأثير الهادئ الهادف الهادي .
متى وأين : يقدران حسب ملابساتهما و يحددان وفق الوسائل المتوفرة
المنفذون : الأشخاص الذين يستشعرون في أنفسهم واجب النصح لإخوانهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الأفكار التي هي مجال بحثه فهو يرى :
وقد فصل لنا فكرة بحثه القائمة على :
الموضوع : الإنسان،
المادة : الأفكار
الكيفية والوسيلة : الإقناع بقوة الحجة و ليس بحجة القوة، و السلوك الحسن و النصيحة بالحسنى و غيرها من وسائل التأثير الهادئ الهادف الهادي .
متى وأين : يقدران حسب ملابساتهما و يحددان وفق الوسائل المتوفرة
المنفذون : الأشخاص الذين يستشعرون في أنفسهم واجب النصح لإخوانهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الأفكار التي هي مجال بحثه فهو يرى :
ضرورة معالجة الأفكار السقيمةبالخطوات التي تقتضيها الحالات المرضية كلها مستفيدين في ذلك بالتقنيات و الممارسات و حتى لغة الاختصاص التي يستعملها الأطباء والصيادلة و الجراحون في معالجة الأسقام و الأورام و الخلال
ولم لا والحروب الدولية و الأهلية و النزاعات الطائفية و الخلافات المذهبية من أصل فكرة أو أفكار مريضة سقيمة عليلة يحملها شخص أو مجموعة أشخاص ثم يفرضونها على الباقين من قومهم أو على العالمين بالقوة .
ولم لا والحروب الدولية و الأهلية و النزاعات الطائفية و الخلافات المذهبية من أصل فكرة أو أفكار مريضة سقيمة عليلة يحملها شخص أو مجموعة أشخاص ثم يفرضونها على الباقين من قومهم أو على العالمين بالقوة .
وهو يرجع عدم اللجوء إلى معالجة هذه الأفكار إلى أسباب ثلاث :
1. إننا لا نستشعر في أنفسنا الآلام الفكرية كما نشعر بآلامنا الجسمية.
2. الحياء من إظهار جهلنا معتبرا إياه مرضا آخر
3. الجهل بطرائق العلاج الفعالة .
2. الحياء من إظهار جهلنا معتبرا إياه مرضا آخر
3. الجهل بطرائق العلاج الفعالة .
وقد أضافت إليها الأخت رزان محمد سببا أراه وجيها ألا وهو [ الكِبْر ] الذي يدعو إلى مجانبة الصواب والتعصب إلى الذات مُذكِّرا إياي هذا الرأي بموقف كبار كفار قريش من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم برغم اقتناعهم بصدق نبوته .
وأضيف إلى ذلك سببا يكمن في أولئك ممن يعلمون فداحة المعضلة وعظم أمرها ألا وهو :
استطابتهم بقاء هذه الأفكار بل ودفعهم لتفاقم خطرها وذلك لأجل منفعة تجلبها لهم ، سواء كانت مادية أو اجتماعية . وذلك كما رأيت من خلال تجاربي أطباء خَلوا من كل صفة المروءة والنزاهة حين يعطون المريض مسكنا لا يشفي ولا يغني ، ليظل البقرة التي يحلبون كلما تردد عليهم وعاد شاكيا إليهم .
وأضيف إلى ذلك سببا يكمن في أولئك ممن يعلمون فداحة المعضلة وعظم أمرها ألا وهو :
استطابتهم بقاء هذه الأفكار بل ودفعهم لتفاقم خطرها وذلك لأجل منفعة تجلبها لهم ، سواء كانت مادية أو اجتماعية . وذلك كما رأيت من خلال تجاربي أطباء خَلوا من كل صفة المروءة والنزاهة حين يعطون المريض مسكنا لا يشفي ولا يغني ، ليظل البقرة التي يحلبون كلما تردد عليهم وعاد شاكيا إليهم .
العلاج :
أولا :
الاستشعار بآلام الجهل أولا و إلا لما أجدى العلاج
ثانيا :
الجلوس إلى العلماء في المساجد – لتسترجع هذه المساجد دورها و مهامها و مكانتها في المجتمع كما كانت قبلا في العصور الذهبية : عصر النبوة و عصر الخلافة الراشدة... فتكون بمثابة المصحات
إذاً ، هو يرى أن الطب هو الدين والطبيب هو العالم فيه بحق . ولكنه يحذر من الحكم بالإعدام الفعلي أو المعنوي على مخالف لنا في الرأي أو مناقض لنا في الاتجاه .
الاستشعار بآلام الجهل أولا و إلا لما أجدى العلاج
ثانيا :
الجلوس إلى العلماء في المساجد – لتسترجع هذه المساجد دورها و مهامها و مكانتها في المجتمع كما كانت قبلا في العصور الذهبية : عصر النبوة و عصر الخلافة الراشدة... فتكون بمثابة المصحات
إذاً ، هو يرى أن الطب هو الدين والطبيب هو العالم فيه بحق . ولكنه يحذر من الحكم بالإعدام الفعلي أو المعنوي على مخالف لنا في الرأي أو مناقض لنا في الاتجاه .
أي أنه يشترط فيه التعامل حسب القاعدة التي وضعها الدين نفسه للخطاب مع الآخر حين قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )
لأن سوى ذلك من النفي للآخر كفيل بتنفير غير المسلم فضلا عن تنفير المسلمين أنفسهم عن إسلامهم . بسبب العنف وقسوة التعامل ممن يلبسون مسوح الدين وتصرفون باسمه .
ثالثا :
استعمال (الجراحة التجميلية) لتجميل الأفكار الشوهاء و تحسين الآراء البلهاء و تصحيح التصورات الحمقاء.
أي حسن التعامل مع الفكرة وتشذيبها لتتلاءم مع فكرنا الصحيح القويم ، بدلا من محاربتها ونفيها .
أي حسن التعامل مع الفكرة وتشذيبها لتتلاءم مع فكرنا الصحيح القويم ، بدلا من محاربتها ونفيها .
رابعا :
معرفة الظروف و الملابسات التي أحاطت بالمريض – وهو هنا صاحب الفكر السقيم – حتى صار في حالته تلك ولابد من معرفة ما مدى الإصابة من علاماتها (Symptômes) حتى نصف العلاج الملائم لا أقل ولا أكثر، لا أقل حتى لا نسهم في إطالة الحالة المرضية فتتدهور، ولا أكثر حتى لا نهلك المريض بالدواء (؟!) فنزيده سقما على سقم
خامسا :
التشخيص الصحيح الصائب .
[ و كذلك بعض الدعاة يضلون في تشخيص الداء فيهلكون المدعوين من حيث لا يشعرون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وكم ضيع "حسن النية " من الناس و كم علق عليه من أخطاء كأنه مشجب (علاقة ملابس) بحق و بباطل ]
**************
الخاتمة :
زينها بعنوان الأمل
مقررا أن [ لا فرق بين "الإسلام الفقهي" أو "الإسلام التعبدي" و "الإسلام السياسي" فالإسلام كتلة واحدة لا تتجزأ و لا تُحلل حسب الأهواء و الرغبات ]
مرجعا سبب فشل المشروع السياسي الإسلامي إلى قصور العاملين في حقل الدعوة الإسلامية من جهة ومكر الأعداء ودهائهم الذي أرهب الساسة المسلمين ونفرهم منه من جهة ثانية .
مرجعا سبب فشل المشروع السياسي الإسلامي إلى قصور العاملين في حقل الدعوة الإسلامية من جهة ومكر الأعداء ودهائهم الذي أرهب الساسة المسلمين ونفرهم منه من جهة ثانية .
وأختم قراءتي بعبارته هو حين قال :
نعم، إننا نحتاج في ممارسة الدعوة إلى الإسلام لدعاة تتوفر فيهم صفات ثلاث: حكمة الطبيب العالم و دقة الصيدلاني الحاذق وثبات الجراح الماهر ولو نقصت صفة من هذه الصفات في الداعية لكان ناقصا بقدر ما نقص منها فيه!
****************
[/frame]هذا والله وليّ التوفيق


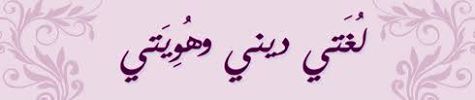



تعليق