[frame="1 10"]
مسابقة " قراءة في كتاب الشهريّة "
إعلان لمن يهمّه الأمر
مع استمرار النجاح الذي حققته المسابقة في شهري تموز(يوليو) وآب (أوغسطس)
وفوز كل من الأستاذ محمد يوب والأستاذة نجية يوسف بوسام القراءة والمطالعة
يعلن ملتقى "القراءة والمشاهدة" عن مسابقته الشهرية لأفضل قراءة في كتاب
لشهر سبتمبر (أيلول) 2010
يقوم المشترك باختيار كتاب أعجبه من مكتبته
يلخّص لنا ما قرأ.. ويسجّل لنا انطباعه الشخصي ورأيه..
دون أن يغفل تقديم نبذة تُعرّف بالكاتب..
تبدأ المسابقة وتقديم القراءات ابتداءً من اليوم وينتهي التقديم في اليوم العشرين من الشهر الجاري.. لنفتح باب التصويت الذي يستمر إلى آخر الشّهر..
يحصل الفائز الأوّل على وسام ملتقى "القراءة والمطالعة"

شروط المسابقة:
1- أن تكون القراءة خاصّة المتسابق ومكتوبة بلغة عربية سليمة
2- أن لا تكون منقولة
3- أن تكون غير منشورة من قبل في أيٍّ من وسائل النّشر وأن تقدّم خصّيصًا لملتقى الأدباء والمبدعين العرب.. وأن لا يتم نشرها في أي وسيلة إعلاميّة أخرى إلاّ بعد مرور أسبوع من نشرها في الملتقى
4- تقدّم القراءات هنا في هذا المتصفّح.. ننقلها بعد ذلك عند التّصويت لمتصفّحٍ خاص
هدا والله وليّ التوفيق
رئيس ملتقى القراءة والمطالعة
ركاد أبو الحسن
[/frame]
إعلان لمن يهمّه الأمر
مع استمرار النجاح الذي حققته المسابقة في شهري تموز(يوليو) وآب (أوغسطس)
وفوز كل من الأستاذ محمد يوب والأستاذة نجية يوسف بوسام القراءة والمطالعة
يعلن ملتقى "القراءة والمشاهدة" عن مسابقته الشهرية لأفضل قراءة في كتاب
لشهر سبتمبر (أيلول) 2010
يقوم المشترك باختيار كتاب أعجبه من مكتبته
يلخّص لنا ما قرأ.. ويسجّل لنا انطباعه الشخصي ورأيه..
دون أن يغفل تقديم نبذة تُعرّف بالكاتب..
تبدأ المسابقة وتقديم القراءات ابتداءً من اليوم وينتهي التقديم في اليوم العشرين من الشهر الجاري.. لنفتح باب التصويت الذي يستمر إلى آخر الشّهر..
يحصل الفائز الأوّل على وسام ملتقى "القراءة والمطالعة"

شروط المسابقة:
1- أن تكون القراءة خاصّة المتسابق ومكتوبة بلغة عربية سليمة
2- أن لا تكون منقولة
3- أن تكون غير منشورة من قبل في أيٍّ من وسائل النّشر وأن تقدّم خصّيصًا لملتقى الأدباء والمبدعين العرب.. وأن لا يتم نشرها في أي وسيلة إعلاميّة أخرى إلاّ بعد مرور أسبوع من نشرها في الملتقى
4- تقدّم القراءات هنا في هذا المتصفّح.. ننقلها بعد ذلك عند التّصويت لمتصفّحٍ خاص
هدا والله وليّ التوفيق
رئيس ملتقى القراءة والمطالعة
ركاد أبو الحسن

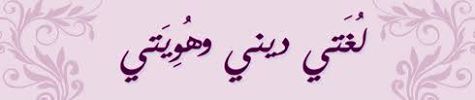
تعليق