أبو العلاء المعري وكتابه (الفصول والغايات )
أبو العلاءِ المَعَرِّي هو أحمدُ بنُ عبد الله بنُ سُلَيْمانَ بنُ مُحَمَّدِ بنُ سُلَيْمانَ بنُ أحمدَ بنُ سُلَيْمانَ التَّنوخي وينتهي نسبُهُ إلى إلحاف بنِ قضاعة 0
وُلِدَ أبو العلاء في معرَّةِ النُّعْمان مِنْ أعمالِ حَلَبَ في غروب شمس يومِ الجُمُعَةِ لثلاثٍ بقيتْ من شهرِ ربيعٍ الأول سنةَ 363هـ ،وأصابه الجُدَرِي في أول السنة الرابعةِ مِنْ عُمُرِهِ فذهبَ ببصرهِ ، ويُرْوَى عنه أنه كان يقول: ( لا أعْرِفُ مِنَ الألوانِ إلا الأحمر لأني كنتُ أُلْبِستُ في الجُدَرِي ثوباً صُبِغَ بالعُصْفُرِ ولستُ أعْقِلُ غيرَ ذلك)
وكان يَحْمَدُ اللهَ على العمى، كما يَحْمَدُهُ غيرُهُ على البصر لأنه أعفاه مِنْ رؤيةِ الثُّقَلاء 0
وأبو العلاء مِنْ بيتٍ عُرِفَ بالعلم والفضلِ وولاية القضاء ،وأما أهلُ أمه فآلُ سبيكة وكانوا أهلَ سماحةٍ ونجدةٍ ومروءةٍ وفتوَّة 0
وأما علمهُ فقد أخذه في البداية عن أبيه حيثُ قرأ عليه علمي النحو واللغة ،وأخذَ الحديثَ عن أبيه وجدِّه ثم قرأ على غير أبيه من فضلاء عصره ولكنه لم يكتفِ بما حصلَ عليهِ من علمٍ فراحَ يجوبُ البلاد طلباً للعلمِ ،فيممَ شطرَ حلبَ وزارَ مكتباتها وتحدثَ إلى علمائها ،وأخذَ عن محمد بن عبد الله بن سعد النَّحْوي تلميذ ابن خالويه ، ثمَّ قصد أنطاكيةَ وهي بعدُ بأيدي الروم فزارَ مكتَبَتَهَا واختلفَ إلى دور العلم فيها فسَمِعً وَسَألَ ،ومرَّ باللاذقية فنزل بدير وأخذَ منه آراءَ كثيرةً عن راهبٍ فيه كان له يدٌ في الفلسفةِ والعلوم الدينية ثمَّ انتقلَ إلى طرابلس الشام0
ولكنَّ طموحَ أبي العلاء لم يقفْ عندَ حدّ بل دفعه لمتابعةِ الرحلة بقصد التزوُّد من زاد العلم والمعرفة ،فقصدَ مدينة بغداد ،وبغداد كما قيل فيها : (( هي وسط الدنيا وسرَّةُ الأرض ،والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبْراً وعِمارةً )) وأهلها (( ليس أعلمُ من عالمهم ، ولا أروى من راويتهم، ولا أجدلُ من متكلمهم ، ولا أعربُ من نحويهم،ولا أصحُّ من قارئهم )) فلم يدعْ أبو العلاء بيتَ علمٍ إلا دخله ’ ولا مجلس أدب إلا حضره ،ولا بيئةً من بيئات الفلسفة إلا اشترك فيها ، فشاع ذكره وقابله الناس بالتجلة والاحترام لسعة معارفه فأوغرَ صدورَ البعضِ عليه حسداً مما جعله يجدُ بعض المعاناة من معاصريه هناك 0
كان أبو العلاء من محبي المتنبي وهذا مما انعكس عليه سلباً لأن المتنبي كما هو معروف كان يعاني من الحاسدين في عصره وبعد عصره ، فيُذكَرُ مرة أن ذُكِرَ المتنبي بالسوء في مجلس كان يحضره أبو العلاء فلم يستطع التغاضي عن ذلك فقال يكفي المتنبي فخراً أنه القائل قصيدته ( لك يا منازلُ في القلوب منازل ) فقال كبير المجلس جرّوا هذا الأعمى خارجاً فقال الجلساء لم يقل شيئاً يُغْضِب قال : ( إنه يقصد بيت المتنبي الذي يقول فيه :( وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ = فهي الشهادة لي بأني كاملُ )0 هذا جزءٌ من معاناة أبي العلاء ولولا خوف الإطالة لذكرتُ أمثلةً أخرى0 وبينما هو في بغداد يتزوّدُ من العلوم فيها حملَ إليه البريدُ نبأَ مرضِ والدته فشدَّ الرحال عائداً إلى المعرَّة بعد أن مكث في بغداد سنةً وسبعةَ أشهر وكانت أمنيته أن يرى والدته التي اشتاق إليها كثيراً ولكنَّ الأجلَ لم يمهلها فتوفاها الله تعالى وكان أبو العلاء ما يزال في طريق العودة فحزنَ عليها حزناً شديداً وقرر بعد ذلك أن يعتزلَ الناس حيثُ يقولُ : ( ولما فاتني المقام حيثُ اخترتُ، أجمعتُ على انفرادٍ يجعلني كالظبي في الكناس ) واختار العزلةَ حتى سمّى نفسه رهين المحبسين ويعني حبس نفسه في المنزل ،وحبسه عن النظر إلى الدنيا بالعمى ،بل سمى نفسه رهينَ المحابس الثلاث حيث يقول:
( تراني في الثلاثة من سجوني = فلا تسألْ عن الخبر النبيثِ )
( لفقدي ناظري، ولزوم بيتي = وكون النفسِ في الجسم الخبيث )
وبعد أن اعتزل الناس بدأ بتأليف الكتب فنظم اللزوميات وألف رسالة الغفران وكتباً أخرى فملأت شهرته الآفاق ، فتوجهت إليه الأنظار ،وقصده الطلاب من كلِّ مكان ، وكاتبه مَنْ لم يستطعِ الوصول إليه من علماء ووزراء وذوي الرتب 0 لبث أبو العلاء في عزلته ما يقربُ من خمسين سنة ثم عراه المرض ولم يمهله أكثر من ثلاثة أيام حتى وافته المنية في مساء يوم الجمعة في الثالث من شهر ربيع الأول سنة 449 هـ وعمره ست وثمانون سنة فضجت البلاد بفاجعة فقده ووقف على قبره أكثر من ثمانين شاعراً يرثونَه ويودعون فيه فيلسوف الشعراء 0شخصيةُ أبي العلاء : كان أبو العلاء يحوي نفساً كبيرةً حيث كان متوقدَ الذكاء بشكل منقطع النظير وتُرْوى عنه الأحاديثُ الكثيرةُ تذكر قوة حافظته 0 كان له باعٌ طويل في الحديث والفقه والمذاهب وكذلك في اللغة والنحو والأدب حتى قال التبريزي : ( ما أعرفُ أن العربَ نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري ) وكان أبو العلاء ملماً بعلم الملل والأديان وفرق المسلمين ،واسع الاطلاع على التاريخ والأخبار ،ولم يفته علم النجوم مع عدم إيمانه بأحكامها ، وكان في علم العروض والقوافي حجةً وأستاذاً ، هذا من جهة علمه وأما من جهة مشاعره فقد كان رقيق القلبِ دقيقَ الشعورِ محباً للعزلة ،وكان طعامه العدس والتين حيث حرَّم على نفسه اللحمَ وكلَّ ما ينتجه الحيوان وهو القائل :
( غدوتَ مريضَ العقلِ والدِّين فالقني = لأعطيكَ أنباءَ الأمور الصحائحِ )
( فلا تأكلنْ ما أخــــرج المـاء ظالـماً = ولا تبغِ قوتاً من غريض الذبائح )
وأما آثاره فهي كثيرةٌ لأنَّ المواهب الفطرية التي تحلّى بها أبو العلاء ،والعلومَ التي حصَّلها بجدِّه واجتهاده وكذلك عزلته ،كلًُّ ذلك مكَّنه من التفرُّغ للتأليف ،فألَّف ما ينوف عن مائتي كتاب ما بين منثور ومنظوم في مواضيعَ مختلفةٍ من أدبٍ ولغةٍ وفلسفةٍ ودين واجتماع، لكنَّ أكثرَ مؤلفاته قد ضاعت أثناء الحملة الحملة الصليبية الأولى على الشام وسقوط المعرة في أيديهم سنة 492 هـ وقد تعرض أهلها للقتل والتشريد، وأباد الصليبيون كلَّ ما وصلت إليه أيديهم من الكتب، وما وصل إلينا من كتب المعري كان قد خرج من المعرة قبل ذلك0
ومن غرائب كتبه ونوادرها كتاب ( الفصول والغايات ) وهذا الكتاب كتابٌ موسوعيٌ تعليمي بكلِّ ما تحملُ هذه الكلمة من معاني، فقد احتوى على كل علوم العربية من نحو وصرف وأدب وعروض، وكذلك أدخل فيه علم التاريخ والفقه وعلم النجوم وغير ذلك مما لم يُسْبق لغيره جمعه بالطريقة التي سلكها، ذلك أنه كان يُملي الفقرة على تلاميذه ثم يختمها بالغاية وهي عنده بمثابة القافية من بيت الشعر وقد تطول أو تقصُر ثم يملي التفسير وإذا انتهى من التفسير وأراد العودة إلى الإملاء قال : ( رجع ) كأنه يريد القول : رجع الإملاء ،والكتابُ على هذا النسق وهو مبنيٌّ على حروف المعجم ولكن فُقِدتْ أجزاؤه الأخرى ولم يبقَ إلا جزؤه الأول من الهمزة وحتى حرف الخاء0 وقد أراد بهذا الكتاب أن يحفظَ مفردات اللغة العربية الأصيلة في عصر بدأ فيه الانحدار في اللغة ،والميل إلى العُجْمَةِ وسَبكَ ذلك بطريقة الوعظِ والإرشاد، وذلك ليَشُدَّ السامعَ والقارئَ ،وضمّنَ الكتابَ أيضاً كلَّ ما أراد من علوم عصره بشكلٍ يجعلُ القارئ لا يملُّ حيث يعرض شيئاً من اللغة والنحو وينتقلُ إلى الفقه والحديث ثم يعرضُ طرفةً من التاريخ ،ثم يُدخلُ شيئاً من الاجتماع حيث يذكرُ تناقضات المجتمع وما فيه من فساد وانعدام العدالة فيه فمما قاله في ذلك : ( للهِ الغَـلَبُ ، وإليه المُنْقَلب، لا يعجزه الطلب،بيده السالبُ والسَلب، سلْ قمراً كالمِحْلَب،وهلالاً مثلَ المِخْلب ، وليلاً لجمعٍ من المَخْشَلب،يُخْبِرْنَكَ بالعجب، عن حقٍّ مُرَجَّب،علم ما وراء النَجب، الفاضلُ موجَّب، والفاجرُ مُنْتَخَب ،وإلى السكوت صار اللجب، ونجوم الشمألِ والجنوب ،في علم الله كمقاعد الضرباء ( غاية) 0
التفسير : النجب: قشر الحور- موجَّب: يأكل الوجبة الواحدة في اليوم كله - مُنْتَخَب:من الانتخاب والاختيار حيث يختار ما يريد من الأطعمة والمعنى على المجاز حيث يبين أن الرجل الموجَّب لا يُكْترث له على الرغم من فضله وأما الفاجر فله التقديم والتقريب والتعظيم-الضرباء: الذين يضربون القداح- المُخْشلب:ما يُتخّذ من الليف والخرز كالحلي – المرجَّب: المعظَّم 0
ومما قاله في العروض بأسلوب جمع فيه تعظيم الله عزَّ وجل بمصطلحات العروض : ( سبَّح لك تأسيسُ بحال وتُفخَّم ،والردف بخمس جهات تُفْهَم، والروي بحروف المعجم، والوصل بأربعة مذاهب يترنم، والخروج بثلاثة تُعْلم ، إنَّ رسَّ التأسيسِ كرسِّ الأنيس، دائم العبادة دائم التقديس، ودأبَ في التعظيم ، الإشباع من كلِّ نظيم ،وشهد بك التوجيه شهادة الوجيه،والحذو بآلائك منبته وكذلك المجرى،أين تصرُّّف وجرى ،والنفاذ تحذِّر نوافذ القضاء 0 التفسير: التأسيس :الألف التي بينها وبين حرف الروي حرف واحد وهو الدخيل كقول الشاعر:
( أتعرفُ رسماً كاطِّراد المذاهبِ ) الألف في مذاهب والروي يكون آخر حرف في البيت الشعري ويكون أيَّ حرف من حروف المعجم ،والوصل هو الحرف الذي يلي حرف الروي مثل الألف والواو والياء والهاء فالألف في قول سحيم ( عميرةَ ودِّع إن تجهزتَ غازيا ) والواو في مثل قول زهير:
( إذا أنت لم تُعْرِضْ عن الجهل والخنا = أصبتَ عليماً أو أصابك جاهلُ )
والياء في قول النابغة: ( كليني لهمٍّّ يا أميمة ناصبِ )
والهاء في مثل قول زهير: ( صحا القلبُ عن سلمى وأقصر باطلهْ )
والمثال طويلٌ يدخلُ فيه كلُّ ما في علم العروض 0 وأما ما تحدث فيه بخصوص علم النحو فهو يقول:
( ربِّي أبلغني هواي،وارزقني منزلاً لا يلجه سواي ،من دخله أمِنَ فهو كعند،وأنا كَمِنْ ،ولا تجعلني في الصالحين كواو الخزم ،والثابتة من الجزم،واثبت اسمي في ديوان الأبرار مع الأسماء المتمكنات ( غاية )
عند: لايدخل عليها من الحروف شيء غيرُ ( مِنْ) وقول العامة ذهبنا إلى عنده خطأ وزعم النحويون أن (عند)
غير محدودة لأنها تقع على الجهات الست و (إلى) للغاية فامتنعت عند من دخول إلى لأن في (إلى) بعض التخصيص 0 واو الخزم: هي الواو التي تزاد في أول بيت الشعر ويكون الوزن مستغنياً عنها وأكثر ما يزيدون (الواو، والفاء،وألف الاستفهام،للحاجة إليهن وزعم الأخفش أنهم يزيدون الحرف (بل) وما جرى مجراها ومثال زيادة الواو في قول امرئ القيس:
( وكأنَّ دماء الهاديات بنحره = عصارة حنَّاءٍ بشيبٍ مرجَّل)
وتُزادُ الواو للخزم على معنى الضرورة لتصلَ كلاماً بكلام0 والواو الثابتة في الجزم: في قولك للواحد لم يغزو وإنما تُثبتُ للضرورة الشعرية لقوله:
( هجوتَ زبَّانَ ثمَّ جئتَ معتذرا = من هجو زبَّان لم تهجو ولم تدعُ )
فالمتقدمون من البصريين يجعلون الفعل في هذا مما بُلغ به الأصل في الضرورة لأن أصلَ ( يهجو) أن يكون مضموم الواو لأنه في وزن يفعُلُ فيصوِّر الشاعر الواو مضمومة في حال الرفع ويسكنها في حال الجزم ويثبتها0 وكان أبو علي الفارسي يرى في مثل هذه الواو التي في قوله (( لم يهجو )) أنها غير الواو التي في قولك ((هو يهجو )) وأنها زيدت للضرورة كما زيدت الياء في قول الشاعر: (( وسواعيدَ يختلينَ اختلاءً = كالمغاني يطرن كلَّ مطير ))
وكذلك الياء في قراءة ابن كثيرفي قوله تعالى : (( إنه مَنْ يتقي ويصبرْ ))وإنما هي ياء مجتابة لتمكين الحركة ،وكذلك يرى الياء في قول الشاعر : (( ألم يأتيك والأنباء تنمي = بما لاقت لبون بني زياد ))
والمذهب القديم أنه بلغ بها الأصل فقال في الرفع(( يأتيك)) وأسكن الياء في الجزم0والأسماء المتمكنات هي التي لا يلحقها علة0
يتبع إن شاء الله تعالى0
خضر أبو إسماعيل – سلمية -
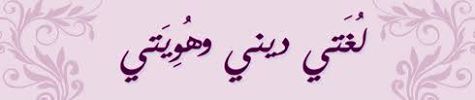
تعليق