«نانوبيديا» -الحلقة(24)
لبرالي.. ليدي.. لوناتيك
بقلم :محمد الخولي
لبرالي: بدون فِصال كما يقول التعبير الدارج، الكلمة مشتقة مباشرة من المصطلح اللاتيني «ليبرا» وكان يصف الشخص، أي شخص بأنه «حر.. غير مقيد.. أو مستقل». وذلك في مقابل كلمة مضادة أو معاكسة هي «سير؟وس» وكانت من ناحيتها تنصرف إلى معنى التابع.. المسترق.. مصيره مرهون بسواه..
وفي لغتنا الشريفة يوجد تعبير في غاية الدقة والفصاحة هو «إمّعة» وهو مصطلح منحوت كما يقول اللغويون من عبارة «أنا معك أو أنا معكم.. حيث لا استقلال في الرأي ولا إبداع في فكر أو سلوك الفرد بل هو تبعية بعقلية القطيع إن شئت التعبير.
هكذا يعمد أمير الشعراء أحمد شوقي إلى عبارة شعرية يجريها في مسرحية «مجنون ليلى» على لسان واحد من المنافقين ينصح رفيقا له لكي يبعد عن الشر.. ويغني له.. كما يذهب إلى ذلك المثل السائر فيقول شوقي:
إذا الفتنة أضطرمت في البلا
د، ورمْتَ النجاة، فكنْ إمّعة!
وتشاء ظروف التواؤم بين معاني اللغات أن ترتبط فكرة اللبرالي ـ الحر.. ومؤداها في الثقافة اللاتينية يفيد الاستقلالية.. بأفكار إيجابية أخرى منها مثلا الشهامة.. الكرم.. السخاء وربما الوفرة والحال الميسور.. وهنا تتفق اللاتينية مع ثقافة العرب التي تضفي على تركيب الكاف.. الراء.. الميم معاني نبيلة شتى. فالكريم هو عكس اللئيم عند المتنبي.
والكريم عكس الخسيس عند الجواهرجية والكريم عكس البخيل في العلاقات الاجتماعية، والكريم هو النبيل المحتد المعروف النسب والطيب الأرومة عكس الهجين الذي لا يعرف له أصل ولا فصل، والكريم يرتبط بالكرم الذي لا يقتصر ماديا على حسن الضيافة بل يتعدى معنويا إلى كرم الأخلاق.. ويرتبط اشتقاقيا بالكرامة.. وهي الأنفة والعّزة والترفع عما يشين الفرد على مستوى التصرف والسلوك.
وقد بلغ من أمر الثقافات الإنسانية العريقة إن كانت تميز لا بين اللبرالي الكريم من الناس وبين السيرفيسوس التابع.. الإمعة من البشر.. بل تعدى التمييز، منذ أيام الثقافة اليونانية، ليتم في مجال العلم والتربية والتعليم.. بين علوم وفنون لبرالية بمعنى علوم يشتغل بها الفلاسفة والمناطقة ومبدعو الموسيقى والفنون الجميلة الرفيعة، أهل الجباه العالية.
كما يقول المصطلح الانجليزي وبين علوم رأوها أدنى مرتبة وأقل شأنا ومعظمها يرتبط بالنشاط الجسماني وليس الاشتغال العقلي أو الروحي.. وهي من ثم علوم الصناعات اليدوية والأعمال البدنية وما إليها.
وعندما دخلت هذه المعاني إلى الثقافة الانجليزية كتب جون دي تري؟يسا في أواخر القرن الرابع عشر يصف أحد أبطال مجتمعه قائلا:
ـ كان قويا في الحرب.. بقدر ما كان لبراليا في العطاء.
من ناحيتهم، آباء الاستقلال في أميركا سحبوا كلمة لبرالي لكي تؤدي دورها في ميدان السياسة وكان في مقدمتهم الكسندر هاملتون (1755 - 4081( مطالبا «بإقرار توزيع لبرالي للسلطة التي تتمتع بها الحكومة القومية».
وبعدها تركز استعمال كلمة «لبرالي» لتصف حالة التحرر من الأعراف العتيقة الموروثة والانعتاق من التقاليد القديمة التي تجاوزها زمن التطور: هي حالة التحرر من الدوجما أي من الأفكار الجامدة.. والطروحات النظرية بالذات التي يصل بها التحجر إلى حد أن تُخالف واقع الحياة.
في النصف الأخير من القرن العشرين «اندلعت» الحرب الباردة بين المعسكرين الكبيرين آن ذاك: السوفييتي، الاشتراكي والغربي، الرأسمالي، الأميركي بالذات، وكانت حربا أيديولوجية بالدرجة الأولى اشتعلت بين العقيدة الاشتراكية في الشرق والعقيدة الرأسمالية في الغرب. هنالك عمد الساسة الأميركيون إلى استخدام سلبي (!) أضفوه على كلمة لبرالي لتفيد عندهم معنى التعاطف مع الفكر الاشتراكي وربما المذهب الشيوعي..
في إيحاء خبيث أو جاهل أو كليهما معا بأن اللبرالي الأميركي يكاد يعتنق مذهب العدو في المعسكر الشرقي! ورغم ان كلمة لبرالي أصبحت مع سنوات القرن الحادي والعشرين تفيد فكرة التحرر.. الاستنارة.. الديمقراطية .
ورفض شمولية الاستبداد ـ إلا أنها في أميركا ـ وعلى ألسنة قيادات الحزب الجمهوري الحاكم بالذات، مازالت تفيد معاني سلبية توحي بنوع من الترخص الأخلاقي، ومن تجاهل منظومات القيم الاجتماعية والسلوكية ولدرجة عمدت معها ماكينات الدعاية في الحزب الجمهوري إلى الكف عن استخدام وصف لبرالي والاستعاضة عنها باستخدام أول حروفها فقط..
وكأنها كلمة نابية لا يجوز التلفظ بها كما في قولهم إنها «لفظة اللام» وهم يفعلون ذلك، لا لوجه الفكر أو السياسة.. ولا حتى الاخلاق بل يفعلونها نكاية، مجرد نكاية في خصومهم الديمقراطيين.
ليدي: الكلمة عند الإنجليز تدل اجتماعيا على تكريم المرأة.. أي امرأة في أي سياق اجتماعي، وهو ما يرادف في العربية لفظة السيدة فلانة ومن قبلها استخدموا في المجتمعات العربية تعبير «الست فلانة» الذي استخدمه الشاعر أحمد شوقي في مسرحيته الخفيفة بعنوان «الست هدى» واستخدم نجيب الريحاني اسم «لعبة الست» في فيلمه الشهير. ومن عجب أن تجد في قواميس العربية أن لفظة ست تفيد معنى العيب أو الشيء الذي لا يجوز التصريح به علنا..
وربما تقصد الإشارة هنا إلى أن المقصود هو الكناية دون الإفادة.. التلميح دون التصريح بالنسبة إلى المرأة.. في مثل كنايتهم عن نساء الأسرة في قولهم الجماعة.. الحُرمة.. البيت. وعبر أجيال سبقت في المجتمع العربي استخدموا لفظة ستِّي.. ستّنا للدلالة على الجدّة بقدر ما كان سيدي آية على الجدّ الكبير..
وكان تعبير ستّي فلانة مرادفا أو يكاد لتعبير «محبوبتي» الجميل عند عرب السودان.. ويكاد يرادف أيضا تعبير «لالا فلانة» عند عرب المغرب وكله من باب الإجلال لجداتنا وذلك قبل أن تداهم الثقافة اليعربية الراهنة ـ والمهيضة أيضا ـ تعبيرات من قبيل «غراندما» أو «نونّا» أو «أبويلا» من أصولها سواء الفرنسية، الأميركية أو الإيطالية او الإسبانية (لاحظ أن الاسبانية في كلمة أبويلا وهي الجدة.. أو أبويلو بمعنى الجد.. مازالت تحتفظ بمقطع الأب العربي كما لا يخفى عليك).
وللعلم أيضا فقد استخدم صاحب كتاب «الأغاني» كلمة الست تكريما للمرأة عالية المقام.. قال الأصبهاني على نحو ما يذكر باحث مدقق من مصر هو الدكتور عبدالمنعم عبدالعال (في معجم الألفاظ العامية):
ـ قال الرشيد: لمن الشعر.. ولمن اللحن؟ قالت الجارية (المطربة) إنه لستي.. سأل الرشيد: ومن ستّك؟ قالت: إنها عُلية أخت أمير المؤمنين : أنعم وأكرم! ومن علماء التأصيل اللغوي ـ الايتومولوي ـ من يعود بكلمة «ليدي» إلى جذور استخدمت فيها في عام 1000 للميلاد بمعنى الملكة ومنهم من يرجع إلى الوراء نحوا من 3 قرون ليؤكد أنها استخدمت بمعنى سيدة خدمة الأسرة أو ببساطة ربة البيت.
والدال في ليدي يعودون بها إلى لفظة ديري وهي منتجات الألبان. ومن ثم كانت الليدي توجد حينما توجد ماشية الأسرة ـ القديمة طبعا وحيث يتم حلب الأبقار وتجهيز منتوجاتها.
وهناك من يختلفون في التأصيل فيربطون بين لفظة ليدي وبين جذور تعود بها إلى لفظة لاي ديج ومعناها في الانجليزية القروسطية صانعة الخبز ومنها اشتقوا «ليدي» لتفيد ست البيت المختصة دون نظيراتها بالإشراف على خبز الأسرة في فرنها أو تنّورها المخصوص وكانت تلك مكانة فريدة في إطار العائلة والمجتمع.
وربما لا يعرف الكثيرون، من الانجليز أنفسهم أن الليدي وهي الآن لقب رسمي تمنحه الملكة من قصر بكنغهام مرادفا للقب اللورد ـ هذه الليدي ترجع في أصولها إلى جدة عليا لهم كانت في العصور الوسطى تتيه على لداتها بأنها.. خبازة شاطرة.. وتلك مهمة كانت حيوية في كل حال.
لوناتيك: لونا هي معبودة القمر في أساطير الرومان وقد استعاروها في إطار عادة الاستعارة الثقافية بل والتراثية التي أدمنوها عن ثقافة اليونان السابقين عليهم. وكانت الاستعارة عن معبودة القمر الإغريقية واسمها سيلين (واضح أن الاسمين «لونا» و«سيلين» مازالا متداولين في أسماء بنات زماننا وإن كاد اسم «قمر» ينكمش في تسميات الفتاة العربية).
سيلين الاغريقية استولدتها أوهام الأساطير من معبودين قديمين أنجبا، حسب الأسطورة أخا لها اسمه هيليوس وهو الاسم الذي خلعه اليونان على الشمس أخت القمر في تصورهم..
ومن ثم جاء مقطع «هليو» دلالة على الشمس والضوء بشكل عام ومنه طبعا مدينة الشمس - هليوبوليس وهي ضاحية مصر الجديدة في شرقي القاهرة التي اختطها وشيدها الرائد البلجيكي البارون إمبان في مفتتح القرن العشرين.
بعيدا عن الأساطير.. يعلمنا الكتاب الأكرم (في سورة ياسين ـ الآيات 38-40) «أن الشمس تجري لمستقر لها».. بين دورة الشروق ودورة الغروب.. في حين أن القمر «قدرناه منازل»..
وأن عبقرية الخلق الكوني قضت أن «لا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر ولا الليل سابق النهار.. وكل في فلك يسبحون».. ومن أذكياء المفسرين من لمح عدم استخدام القرآن فعل «تسبح» للدلالة على حركة هذه الأجرام السماوية بل استخدم فعل «يسبحون» .
وهو للعاقل، وكأن الإشارة هنا إلى أن هذه الأجرام السماوية تتحرك وفق نواميس وقواعد وآليات عاقلة.. واعية وفاهمة لما قضى به خالقها عز وجل. عرف الأقدمون دورة الشمس بين الضوء والظلام.. بين الحركة في النهار والسبات في الليل.. بل بين انتفاضة الشروق بدينامية الحياة وهدأة الغرب بسكون الليل.. ومنهم من ارتفع بالشمس إلى علياء المعبود مثل أخناتون المصري القديم.
لكن الأقدمين عرفوا أيضا تغيرات وجه القمر ومنازله المختلفة من هلال إلى تربيع.. إلى بدر مكتمل إلى محاق يغيب في أجواز الأفلاك.. ربطوا بين تغيرات وجه القمر وبين ما يعتري الفرد البشري من تغيرات في العقل والنوازع والتصرفات..
وحين كان هذا الفرد يصاب بعارض من ارتباك ذهني أو خلل عقلي كانوا يُرجعون ذلك إلى تغيرات وجه القمر في كبد السماء فإذا بهذا الفرد وقد خلعوا عليه صفة مَنْ صعقه ضوء القمر، والصفة هي «لوناتيك»..
وقد اصطنعوا الصفة لتجمع بين غرابة الأطوار وبين الإصابة بمرض الجنون العقلي. ورغم أنهم ميزوا مع سنوات القرن التاسع عشر بين الحالتين.. فمازالت سلوكيات الغرابة والحماقة والرعونة والاندفاع المتسرع بغير أناة أو روية توصف بأنها لوناتيك في الانجليزية، وهي نفسها في الفرنسية، وهي ايضا لوناتيكو في الإيطالية وهي ألونادو في الإسبانية.
أما في الألمانية فهي «موندسك» ويرادفها في الانجليزية ايضا لفظة «مونسترك» ومعناها حرفيا الشخص الذي أصابته ضربات القمر وتترجمها المعاجم العربية الثقات في زماننا (قاموس أطلس مثلا ـ عمّان، 2003) على انها:
الشخص الممسوس، المختلط العقل وأحيانا المذهول، أو المبهور بسبب عاطفة أو شعور رومانسي (راجع مشهد قيس العاشق الخالد الذي صوره الشاعر في مسرحية مجنون ليلى وقد وضع يده في أناء النار ذاهلا من فرط العشق وشدة الانبهار.. هنالك عمدت إلى تحذيره ليلى العاقلة الراسية.. الرزينة فقالت على نحو ما أطربت أسمهان في أوبريت عبدالوهاب ـ مجنون ليلى:
ويح قيس تحّرقت راحتاه.. وما شَعَر.
لبرالي.. ليدي.. لوناتيك
بقلم :محمد الخولي
لبرالي: بدون فِصال كما يقول التعبير الدارج، الكلمة مشتقة مباشرة من المصطلح اللاتيني «ليبرا» وكان يصف الشخص، أي شخص بأنه «حر.. غير مقيد.. أو مستقل». وذلك في مقابل كلمة مضادة أو معاكسة هي «سير؟وس» وكانت من ناحيتها تنصرف إلى معنى التابع.. المسترق.. مصيره مرهون بسواه..
وفي لغتنا الشريفة يوجد تعبير في غاية الدقة والفصاحة هو «إمّعة» وهو مصطلح منحوت كما يقول اللغويون من عبارة «أنا معك أو أنا معكم.. حيث لا استقلال في الرأي ولا إبداع في فكر أو سلوك الفرد بل هو تبعية بعقلية القطيع إن شئت التعبير.
هكذا يعمد أمير الشعراء أحمد شوقي إلى عبارة شعرية يجريها في مسرحية «مجنون ليلى» على لسان واحد من المنافقين ينصح رفيقا له لكي يبعد عن الشر.. ويغني له.. كما يذهب إلى ذلك المثل السائر فيقول شوقي:
إذا الفتنة أضطرمت في البلا
د، ورمْتَ النجاة، فكنْ إمّعة!
وتشاء ظروف التواؤم بين معاني اللغات أن ترتبط فكرة اللبرالي ـ الحر.. ومؤداها في الثقافة اللاتينية يفيد الاستقلالية.. بأفكار إيجابية أخرى منها مثلا الشهامة.. الكرم.. السخاء وربما الوفرة والحال الميسور.. وهنا تتفق اللاتينية مع ثقافة العرب التي تضفي على تركيب الكاف.. الراء.. الميم معاني نبيلة شتى. فالكريم هو عكس اللئيم عند المتنبي.
والكريم عكس الخسيس عند الجواهرجية والكريم عكس البخيل في العلاقات الاجتماعية، والكريم هو النبيل المحتد المعروف النسب والطيب الأرومة عكس الهجين الذي لا يعرف له أصل ولا فصل، والكريم يرتبط بالكرم الذي لا يقتصر ماديا على حسن الضيافة بل يتعدى معنويا إلى كرم الأخلاق.. ويرتبط اشتقاقيا بالكرامة.. وهي الأنفة والعّزة والترفع عما يشين الفرد على مستوى التصرف والسلوك.
وقد بلغ من أمر الثقافات الإنسانية العريقة إن كانت تميز لا بين اللبرالي الكريم من الناس وبين السيرفيسوس التابع.. الإمعة من البشر.. بل تعدى التمييز، منذ أيام الثقافة اليونانية، ليتم في مجال العلم والتربية والتعليم.. بين علوم وفنون لبرالية بمعنى علوم يشتغل بها الفلاسفة والمناطقة ومبدعو الموسيقى والفنون الجميلة الرفيعة، أهل الجباه العالية.
كما يقول المصطلح الانجليزي وبين علوم رأوها أدنى مرتبة وأقل شأنا ومعظمها يرتبط بالنشاط الجسماني وليس الاشتغال العقلي أو الروحي.. وهي من ثم علوم الصناعات اليدوية والأعمال البدنية وما إليها.
وعندما دخلت هذه المعاني إلى الثقافة الانجليزية كتب جون دي تري؟يسا في أواخر القرن الرابع عشر يصف أحد أبطال مجتمعه قائلا:
ـ كان قويا في الحرب.. بقدر ما كان لبراليا في العطاء.
من ناحيتهم، آباء الاستقلال في أميركا سحبوا كلمة لبرالي لكي تؤدي دورها في ميدان السياسة وكان في مقدمتهم الكسندر هاملتون (1755 - 4081( مطالبا «بإقرار توزيع لبرالي للسلطة التي تتمتع بها الحكومة القومية».
وبعدها تركز استعمال كلمة «لبرالي» لتصف حالة التحرر من الأعراف العتيقة الموروثة والانعتاق من التقاليد القديمة التي تجاوزها زمن التطور: هي حالة التحرر من الدوجما أي من الأفكار الجامدة.. والطروحات النظرية بالذات التي يصل بها التحجر إلى حد أن تُخالف واقع الحياة.
في النصف الأخير من القرن العشرين «اندلعت» الحرب الباردة بين المعسكرين الكبيرين آن ذاك: السوفييتي، الاشتراكي والغربي، الرأسمالي، الأميركي بالذات، وكانت حربا أيديولوجية بالدرجة الأولى اشتعلت بين العقيدة الاشتراكية في الشرق والعقيدة الرأسمالية في الغرب. هنالك عمد الساسة الأميركيون إلى استخدام سلبي (!) أضفوه على كلمة لبرالي لتفيد عندهم معنى التعاطف مع الفكر الاشتراكي وربما المذهب الشيوعي..
في إيحاء خبيث أو جاهل أو كليهما معا بأن اللبرالي الأميركي يكاد يعتنق مذهب العدو في المعسكر الشرقي! ورغم ان كلمة لبرالي أصبحت مع سنوات القرن الحادي والعشرين تفيد فكرة التحرر.. الاستنارة.. الديمقراطية .
ورفض شمولية الاستبداد ـ إلا أنها في أميركا ـ وعلى ألسنة قيادات الحزب الجمهوري الحاكم بالذات، مازالت تفيد معاني سلبية توحي بنوع من الترخص الأخلاقي، ومن تجاهل منظومات القيم الاجتماعية والسلوكية ولدرجة عمدت معها ماكينات الدعاية في الحزب الجمهوري إلى الكف عن استخدام وصف لبرالي والاستعاضة عنها باستخدام أول حروفها فقط..
وكأنها كلمة نابية لا يجوز التلفظ بها كما في قولهم إنها «لفظة اللام» وهم يفعلون ذلك، لا لوجه الفكر أو السياسة.. ولا حتى الاخلاق بل يفعلونها نكاية، مجرد نكاية في خصومهم الديمقراطيين.
ليدي: الكلمة عند الإنجليز تدل اجتماعيا على تكريم المرأة.. أي امرأة في أي سياق اجتماعي، وهو ما يرادف في العربية لفظة السيدة فلانة ومن قبلها استخدموا في المجتمعات العربية تعبير «الست فلانة» الذي استخدمه الشاعر أحمد شوقي في مسرحيته الخفيفة بعنوان «الست هدى» واستخدم نجيب الريحاني اسم «لعبة الست» في فيلمه الشهير. ومن عجب أن تجد في قواميس العربية أن لفظة ست تفيد معنى العيب أو الشيء الذي لا يجوز التصريح به علنا..
وربما تقصد الإشارة هنا إلى أن المقصود هو الكناية دون الإفادة.. التلميح دون التصريح بالنسبة إلى المرأة.. في مثل كنايتهم عن نساء الأسرة في قولهم الجماعة.. الحُرمة.. البيت. وعبر أجيال سبقت في المجتمع العربي استخدموا لفظة ستِّي.. ستّنا للدلالة على الجدّة بقدر ما كان سيدي آية على الجدّ الكبير..
وكان تعبير ستّي فلانة مرادفا أو يكاد لتعبير «محبوبتي» الجميل عند عرب السودان.. ويكاد يرادف أيضا تعبير «لالا فلانة» عند عرب المغرب وكله من باب الإجلال لجداتنا وذلك قبل أن تداهم الثقافة اليعربية الراهنة ـ والمهيضة أيضا ـ تعبيرات من قبيل «غراندما» أو «نونّا» أو «أبويلا» من أصولها سواء الفرنسية، الأميركية أو الإيطالية او الإسبانية (لاحظ أن الاسبانية في كلمة أبويلا وهي الجدة.. أو أبويلو بمعنى الجد.. مازالت تحتفظ بمقطع الأب العربي كما لا يخفى عليك).
وللعلم أيضا فقد استخدم صاحب كتاب «الأغاني» كلمة الست تكريما للمرأة عالية المقام.. قال الأصبهاني على نحو ما يذكر باحث مدقق من مصر هو الدكتور عبدالمنعم عبدالعال (في معجم الألفاظ العامية):
ـ قال الرشيد: لمن الشعر.. ولمن اللحن؟ قالت الجارية (المطربة) إنه لستي.. سأل الرشيد: ومن ستّك؟ قالت: إنها عُلية أخت أمير المؤمنين : أنعم وأكرم! ومن علماء التأصيل اللغوي ـ الايتومولوي ـ من يعود بكلمة «ليدي» إلى جذور استخدمت فيها في عام 1000 للميلاد بمعنى الملكة ومنهم من يرجع إلى الوراء نحوا من 3 قرون ليؤكد أنها استخدمت بمعنى سيدة خدمة الأسرة أو ببساطة ربة البيت.
والدال في ليدي يعودون بها إلى لفظة ديري وهي منتجات الألبان. ومن ثم كانت الليدي توجد حينما توجد ماشية الأسرة ـ القديمة طبعا وحيث يتم حلب الأبقار وتجهيز منتوجاتها.
وهناك من يختلفون في التأصيل فيربطون بين لفظة ليدي وبين جذور تعود بها إلى لفظة لاي ديج ومعناها في الانجليزية القروسطية صانعة الخبز ومنها اشتقوا «ليدي» لتفيد ست البيت المختصة دون نظيراتها بالإشراف على خبز الأسرة في فرنها أو تنّورها المخصوص وكانت تلك مكانة فريدة في إطار العائلة والمجتمع.
وربما لا يعرف الكثيرون، من الانجليز أنفسهم أن الليدي وهي الآن لقب رسمي تمنحه الملكة من قصر بكنغهام مرادفا للقب اللورد ـ هذه الليدي ترجع في أصولها إلى جدة عليا لهم كانت في العصور الوسطى تتيه على لداتها بأنها.. خبازة شاطرة.. وتلك مهمة كانت حيوية في كل حال.
لوناتيك: لونا هي معبودة القمر في أساطير الرومان وقد استعاروها في إطار عادة الاستعارة الثقافية بل والتراثية التي أدمنوها عن ثقافة اليونان السابقين عليهم. وكانت الاستعارة عن معبودة القمر الإغريقية واسمها سيلين (واضح أن الاسمين «لونا» و«سيلين» مازالا متداولين في أسماء بنات زماننا وإن كاد اسم «قمر» ينكمش في تسميات الفتاة العربية).
سيلين الاغريقية استولدتها أوهام الأساطير من معبودين قديمين أنجبا، حسب الأسطورة أخا لها اسمه هيليوس وهو الاسم الذي خلعه اليونان على الشمس أخت القمر في تصورهم..
ومن ثم جاء مقطع «هليو» دلالة على الشمس والضوء بشكل عام ومنه طبعا مدينة الشمس - هليوبوليس وهي ضاحية مصر الجديدة في شرقي القاهرة التي اختطها وشيدها الرائد البلجيكي البارون إمبان في مفتتح القرن العشرين.
بعيدا عن الأساطير.. يعلمنا الكتاب الأكرم (في سورة ياسين ـ الآيات 38-40) «أن الشمس تجري لمستقر لها».. بين دورة الشروق ودورة الغروب.. في حين أن القمر «قدرناه منازل»..
وأن عبقرية الخلق الكوني قضت أن «لا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر ولا الليل سابق النهار.. وكل في فلك يسبحون».. ومن أذكياء المفسرين من لمح عدم استخدام القرآن فعل «تسبح» للدلالة على حركة هذه الأجرام السماوية بل استخدم فعل «يسبحون» .
وهو للعاقل، وكأن الإشارة هنا إلى أن هذه الأجرام السماوية تتحرك وفق نواميس وقواعد وآليات عاقلة.. واعية وفاهمة لما قضى به خالقها عز وجل. عرف الأقدمون دورة الشمس بين الضوء والظلام.. بين الحركة في النهار والسبات في الليل.. بل بين انتفاضة الشروق بدينامية الحياة وهدأة الغرب بسكون الليل.. ومنهم من ارتفع بالشمس إلى علياء المعبود مثل أخناتون المصري القديم.
لكن الأقدمين عرفوا أيضا تغيرات وجه القمر ومنازله المختلفة من هلال إلى تربيع.. إلى بدر مكتمل إلى محاق يغيب في أجواز الأفلاك.. ربطوا بين تغيرات وجه القمر وبين ما يعتري الفرد البشري من تغيرات في العقل والنوازع والتصرفات..
وحين كان هذا الفرد يصاب بعارض من ارتباك ذهني أو خلل عقلي كانوا يُرجعون ذلك إلى تغيرات وجه القمر في كبد السماء فإذا بهذا الفرد وقد خلعوا عليه صفة مَنْ صعقه ضوء القمر، والصفة هي «لوناتيك»..
وقد اصطنعوا الصفة لتجمع بين غرابة الأطوار وبين الإصابة بمرض الجنون العقلي. ورغم أنهم ميزوا مع سنوات القرن التاسع عشر بين الحالتين.. فمازالت سلوكيات الغرابة والحماقة والرعونة والاندفاع المتسرع بغير أناة أو روية توصف بأنها لوناتيك في الانجليزية، وهي نفسها في الفرنسية، وهي ايضا لوناتيكو في الإيطالية وهي ألونادو في الإسبانية.
أما في الألمانية فهي «موندسك» ويرادفها في الانجليزية ايضا لفظة «مونسترك» ومعناها حرفيا الشخص الذي أصابته ضربات القمر وتترجمها المعاجم العربية الثقات في زماننا (قاموس أطلس مثلا ـ عمّان، 2003) على انها:
الشخص الممسوس، المختلط العقل وأحيانا المذهول، أو المبهور بسبب عاطفة أو شعور رومانسي (راجع مشهد قيس العاشق الخالد الذي صوره الشاعر في مسرحية مجنون ليلى وقد وضع يده في أناء النار ذاهلا من فرط العشق وشدة الانبهار.. هنالك عمدت إلى تحذيره ليلى العاقلة الراسية.. الرزينة فقالت على نحو ما أطربت أسمهان في أوبريت عبدالوهاب ـ مجنون ليلى:
ويح قيس تحّرقت راحتاه.. وما شَعَر.
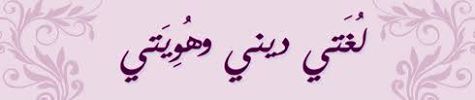
تعليق