«نانوبيديا» -الحلقة السابع عشر
طابور .. طروادة .. طرابلس
طابور: في عالم البناء والتشييد تصدق الكلمة على العمود في تصاميم المعمار التي اشتهر منها معماريات قدماء المصريين وفي صدارتها صرح الكرنك (في صعيد مصر الأعلى) ويزينه بهو الأعمدة الذي تعلوه تشكيلات نبات البردي المرتبط أبدا بمياه النيل.
وهناك كذلك صرح الاكروبول الذي يقوم على هضبة تطل على أثينا عاصمة اليونان وقد بدأ قدماء الإغريق تشييده وجرت عليه عوادي الزمان إلى أن أمر المصلح بركليس الإغريقي (ت429ق.م) بإعادة بنائه فاسترجع بهاءه الغابر وخاصة عند بوابته الرائعة التي عرفت باسم البروبولايا.
أما الطابور في عالم تعبئة الجيوش وحشد القوات للزحف إلى ساحات القتال فهو بداهة الصف من المحاربين ينتظم أفراده في أنساق رأسية أي في متوالية من البشر كل فرد في أثر زميله..
وما كان لأحد أن يماري أو يناقش مثل هذه الأنساق سواء كانت في تصميم المعمار أو في ساحات القتال.. لولا ما حدث خلال السنوات الأخيرة من عقد ثلاثينات القرن العشرين.. وفي أقاليم أسبانيا على وجه الخصوص.
في ذلك الزمان والمكان اشتعلت نيران الحرب الأهلية الأسبانية. دامت الحرب ثلاث سنوات بين عامي 1936 و1939 (العام الأخير شهد اندلاع حرب أخرى أشد خطرا وأوسع نطاقا وهي الحرب العالمية الثانية).
وكان طرفا الحرب الاسبانية هما: الوطنيون أو القوميون وهم اليمين الوطني والديني والارستقراطية القديمة وقد انضم إليهم الجنرال فرانكو قائدا لقوات الكتائب الفاشية.
أما الطرف الآخر فكان يتألف من العناصر اللبرالية وقوى اليسار والاشتراكيين والشيوعيين. وعلى المستوى الخارجي نالت قوى اليمين دعما من إيطاليا الفاشية (موسوليني) والمانيا النازية (هتلر) وخاصة بالنسبة لتجريب الأسلحة الجديدة وتكنولوجيا القتال المتقدمة وهو ما تم استخدامه في الحرب العالمية بعد ذلك بفترة وجيزة.
فيما توافدت على اسبانيا للمشاركة مع قوى اليسار ومؤازرتها عناصر من المثقفين والمبدعين والفنانين من بلاد شتى فكان أن جاءهم من أميركا الروائي ارنست همنغواي (1899 - 1691( وجاءهم من انجلترا الروائي جورج أورويل فضلا عن مشاركة شاعر اسبانيا الشهير فدريكو جارسيا لوركا (1898 - 6391(..
والحق أن مشاركة مثل هؤلاء الأدباء وأهل الانتلجنسيا كانت مفيدة معنويا وربما كان فيها ما أشعل في نفوسهم روح الإيثار والإبداع أو حتى المغامرة إلا أنهم كانوا بداهة أقل خبرة بفنون الحرب وأدنى تجربة بشظف القتال.. ومن ثم فقد كان النصر لقوات الفاشست التي دخل قائدها فرانكو ليسيطر على العاصمة مدريد ويفرض على اسبانيا حكمه الديكتاتوري حتى يوم وفاته في عام 1975.
مع ذلك بقي كثير من الإبداع الأدبي كمحصلة للحرب الأهلية الأسبانية وبقيت معها حكاية الطابور.. الخامس التي مازالت قائمة ومتواترة حتى أيامنا.
أصل الحكاية يرجع إلى الجنرال «مولا» الذي كان يزحف على مدريد على رأس أربعة طوابير مسلحة من الجنود والضباط.. ربما راجعه أركان حربه في قلة عدد الطوابير الزاحفة والهادفة بغرض الاستيلاء على عاصمة البلاد.. وكان جوابه الذي مازال مسجلا في دفاتر التاريخ:
ـ لا تخشوا شيئا.. لدينا طابور «خامس» مستعد لانتظارنا والتعاون معنا داخل المدينة ذاتها.
كان الجنرال الاسباني يشير إلى جموع المؤيدين والمتعاطفين ولاسيما العيون والأرصاد والجواسيس الموالون لقواته ممن لا يعرفهم أحد وممن حرصوا على ستر ولائهم بانتظار لحظة الانقضاض المناسبة.
بعدها شاع استعمال هذا التعبير وخاصة حين سعى المحللون إلى تفسير السهولة الغريبة التي استطاعت بها جيوش هتلر أن تغزو أقطارا مجاورة في غرب وشمال أوروبا مثل هولندا أو النرويج.. يومها قال قائلهم:
ـ لم يكن الفضل فقط للقوات الزاحفة، بل كان لديهم المعلومات الموثوقة والاستخبارات الدقيقة والمتعاطفون المتسترون.. كان لديهم الطابور الخامس..
ولأن كل شئ يتغير حتى المصطلحات الراسخة المستقرة، فقد فضل دهاقنة الإعلام الأميركي، وخاصة بعد 11 سبتمبر ألا يستخدموا تعبير الطابور الخامس.. وبدلا منه استقروا على مصطلح «الخلايا النائمة» بمعنى المخططات الكامنة تحت السطح ولكنها لا تلبث أن تنشط للعمل في أي لحظة.. وهو مصطلح سلبي مازال ساريا ومتواترا في مفردات السياسة والميديا الأميركية لزوم الاستمرار في ترويع الجماهير وإدامة استنفارها.
طروادة: بها يحتفل تراث الإغريق وإبداعهم الثقافي الذي لايزال جزءا عزيزا من ذاكرة الإنسانية حتى الآن.. دارت على ساحاتها حرب طروادة الشهيرة التي خلدتها أبيات ملحمة «الإلياذة» المرتبطة باسم هوميروس شاعر الإغريق القديم الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد وإن تنافست على إدعاء مولده ونشأته كثير من حواضر العالم القديم ومنها اثينا وأزمير..
وكم افتتن أدباء الدنيا على مر العصور بإلياذة هوميروس.. وقد ترجمها إلى العربية سليمان البستاني (1856 - 5291( وكان من رجال الأدب وأعلام السياسة:
ولد في لبنان وعاش في كل من القاهرة وبغداد والبصرة وبيروت والآستانة وتولى الوزارة والنيابة في البرلمان واحتشد لترجمة ملحمة هوميروس وأتقن من أجل الترجمة عدة لغات ثم عمد إلى تصديرها بمقدمة ضافية تعد بدورها من عيون الكتابات الأدبية حيث أجمل فيها تاريخ الأدب عند العرب.
وترتبط طروادة بأمور شتى منها طبعا حربها الشهيرة مع اليونان من أجل استرداد هيلين اليونانية الجميلة التي اختطفها أمير طروادة الشاب وكان اسمه باريس..
وعندما أبحرت الأساطيل من أثينا واتجهت شرقا إلى ساحة القتال في طروادة بأرض الأناضول، البلاد التي تغني هوميروس بثرائها وازدهارها على يد مليكها الأشيب الوقور بريام وابنه الفارس الشجاع هكتور فضلا عن ثراء طروادة غنية بمواردها المعدنية والزراعية..
وبهذا كله ربما كانت مؤهلة لكي تهزم غزاة اليونان أو على الأقل تصمد أمامهم، لولا.. أن اصطنع الغزاة حيلة أدخلوا بها حصانا من خشب إلى داخل المدينة وكأنه لعبة أو ملهاة..
لكن كان يختبئ في جوف اللعبة الخشبية عدد من الفرسان الأغارقة الذين ساعدوا على فتح أبواب المدينة واستباحة مرافقها أمام الغزاة القادمين.. ومن هنا أصبح تعبير «حصان طروادة» عَلَما على كل حيلة أو مؤامرة تقصد إلى التضليل والخداع..
ولأن طروادة كانت غنية بمناجم الذهب - على نحو ما تقول أساطير الميثولوجيا - فقد اصطنعوا مصطلح «الوزن الطروادي» أو «نظام طروادة» الذي يتم بمقتضاه وزن وتقدير قيمة المعادن النفيسة وأحيانا المواد الخطيرة (العقاقير الثمينة). والحق أن تلك نسبة غير صحيحة، وأن طروادة لا علاقة لها بالمسألة لا من قريب ولا من بعيد..
والمشكلة هي الخلط بين طروادة (طُروى في الانجليزية) وبين مدينة طروى الفرنسية التي كانت مركزا تجاريا مزدهرا أيام العصور الوسطى وكانت موئلا لأكثر من سوق وأكثر من معرض للتجارة وعرض السلع المهمة في تلك الأيام ابتداء من الذهب والفضة وليس انتهاء بالسكر والمشروبات والحبوب.
. وفي تلك المدينة اعتمدوا تقسيم الرطل (باوند) إلى 12 أوقية وخلعوا على الأجزاء الصغرى تسمية «أونصة طروى» فكان أن خَلَط الناس بينها وبين ملحمة الإلياذة وأسموها «أوقية طروادة» ربما من باب الإعجاب بما أبدعته عبقرية شاعر الإغريق الأكبر هوميروس.
طرابلس: عند شطري الوطن العربي توجد مدينتان باسم واحد: الأولى طرابلس - المشرق في لبنان.. والثانية طرابلس الغرب في ليبيا.. وهذه المشاركة.. هل نقول التآخي في الاسم، تعكس عراقة التاريخ الممتد الذي تصدر عنه المدينتان.. حيث قد يرجع الاسم الموحد إلى لغة اليونان فيفيد المقطع الأول من الاسم بمعنى الثلاثة أو الثلاثي..
فيما يفيد المقطع الثاني «بولِس» بمعنى المدينة أو الحاضرة على نحو ما كانت أثينا أو اسبرطة في دنيا الإغريق. هذا النمط من الحواضر المثلثة كان سائدا منذ أيام النشأة الأولى لكل من المدينتين:
طرابلس - لبنان التي يرجع تشييدها إلى الفينيقيين نحو 800 سنة قبل الميلاد لتكون عاصمة اتحاد لممالك فينقية كانت زاهرة في تلك الفترة الباكرة وظلت على ازدهارها حتى أيام الرومان إلى أن فتحها المسلمون عام 638 للميلاد لتبقى ميناء وحاضرة متوسطية وموئلا للثقافة العربية القومية فضلا عن آثارها التي تجمع بين المسجد الكبير وقلعة دو سان جيل من أيام الحروب الصليبية إضافة إلى حمامات أثرية ومكتبات إسلامية.
طرابلس الإفريقية - التوأم مدينة متوسطية بدورها يعود تاريخها أيضا إلى أيام الرومان (القرن السابع قبل الميلاد) إلى أن فتحتها قوات عمرو بن العاص بعد فتح مصر.. وكان ذلك تحديدا في عام 643 للميلاد ومازالت عاصمة الجماهيرية الليبية.
وشأن كل الحواضر والثغور الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، كان طبيعيا أن تتعرض كل من المدينتين إلى غزوات وحروب، وأن تخضع في هذه المرحلة أو تلك لقوات الغزو الامبريالية على اختلاف العصور والجنسيات: طرابلس لبنان استولى عليها (الصليبيون) بل حّولوها إلى إمارة لاتينية في الفترة 1109 - 9821 للميلاد .
ولكنها استردت طابعها الوطني والقومي وهويتها العربية - الإسلامية بعد أن زحفت قوات السلطان المملوكي قلاوون (1279 - 1290) من القاهرة والشام إلى حيث استعادت طرابلس وطردت منها قوات الاحتلال الأوروبي الذي كان يرفع شعار الصليب.
من ناحيتها أيضا تعرضت طرابلس الغرب - الأفريقية إلى غزوات جحافل قرطاجنة والرومان ثم استولت عليها قوات قبائل الواندال البربرية الأوروبية وبعدها قوات بيزنطة (الدولة الرومانية الشرقية) عام 534 للميلاد إلى أن أضاءت بنور الإسلام واكتسبت هويتها العربية بعد أن وصلتها قوات عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي سرح فاتح منطقة أفريقية إلى حيث أقطار المغرب العربي.
طابور .. طروادة .. طرابلس
طابور: في عالم البناء والتشييد تصدق الكلمة على العمود في تصاميم المعمار التي اشتهر منها معماريات قدماء المصريين وفي صدارتها صرح الكرنك (في صعيد مصر الأعلى) ويزينه بهو الأعمدة الذي تعلوه تشكيلات نبات البردي المرتبط أبدا بمياه النيل.
وهناك كذلك صرح الاكروبول الذي يقوم على هضبة تطل على أثينا عاصمة اليونان وقد بدأ قدماء الإغريق تشييده وجرت عليه عوادي الزمان إلى أن أمر المصلح بركليس الإغريقي (ت429ق.م) بإعادة بنائه فاسترجع بهاءه الغابر وخاصة عند بوابته الرائعة التي عرفت باسم البروبولايا.
أما الطابور في عالم تعبئة الجيوش وحشد القوات للزحف إلى ساحات القتال فهو بداهة الصف من المحاربين ينتظم أفراده في أنساق رأسية أي في متوالية من البشر كل فرد في أثر زميله..
وما كان لأحد أن يماري أو يناقش مثل هذه الأنساق سواء كانت في تصميم المعمار أو في ساحات القتال.. لولا ما حدث خلال السنوات الأخيرة من عقد ثلاثينات القرن العشرين.. وفي أقاليم أسبانيا على وجه الخصوص.
في ذلك الزمان والمكان اشتعلت نيران الحرب الأهلية الأسبانية. دامت الحرب ثلاث سنوات بين عامي 1936 و1939 (العام الأخير شهد اندلاع حرب أخرى أشد خطرا وأوسع نطاقا وهي الحرب العالمية الثانية).
وكان طرفا الحرب الاسبانية هما: الوطنيون أو القوميون وهم اليمين الوطني والديني والارستقراطية القديمة وقد انضم إليهم الجنرال فرانكو قائدا لقوات الكتائب الفاشية.
أما الطرف الآخر فكان يتألف من العناصر اللبرالية وقوى اليسار والاشتراكيين والشيوعيين. وعلى المستوى الخارجي نالت قوى اليمين دعما من إيطاليا الفاشية (موسوليني) والمانيا النازية (هتلر) وخاصة بالنسبة لتجريب الأسلحة الجديدة وتكنولوجيا القتال المتقدمة وهو ما تم استخدامه في الحرب العالمية بعد ذلك بفترة وجيزة.
فيما توافدت على اسبانيا للمشاركة مع قوى اليسار ومؤازرتها عناصر من المثقفين والمبدعين والفنانين من بلاد شتى فكان أن جاءهم من أميركا الروائي ارنست همنغواي (1899 - 1691( وجاءهم من انجلترا الروائي جورج أورويل فضلا عن مشاركة شاعر اسبانيا الشهير فدريكو جارسيا لوركا (1898 - 6391(..
والحق أن مشاركة مثل هؤلاء الأدباء وأهل الانتلجنسيا كانت مفيدة معنويا وربما كان فيها ما أشعل في نفوسهم روح الإيثار والإبداع أو حتى المغامرة إلا أنهم كانوا بداهة أقل خبرة بفنون الحرب وأدنى تجربة بشظف القتال.. ومن ثم فقد كان النصر لقوات الفاشست التي دخل قائدها فرانكو ليسيطر على العاصمة مدريد ويفرض على اسبانيا حكمه الديكتاتوري حتى يوم وفاته في عام 1975.
مع ذلك بقي كثير من الإبداع الأدبي كمحصلة للحرب الأهلية الأسبانية وبقيت معها حكاية الطابور.. الخامس التي مازالت قائمة ومتواترة حتى أيامنا.
أصل الحكاية يرجع إلى الجنرال «مولا» الذي كان يزحف على مدريد على رأس أربعة طوابير مسلحة من الجنود والضباط.. ربما راجعه أركان حربه في قلة عدد الطوابير الزاحفة والهادفة بغرض الاستيلاء على عاصمة البلاد.. وكان جوابه الذي مازال مسجلا في دفاتر التاريخ:
ـ لا تخشوا شيئا.. لدينا طابور «خامس» مستعد لانتظارنا والتعاون معنا داخل المدينة ذاتها.
كان الجنرال الاسباني يشير إلى جموع المؤيدين والمتعاطفين ولاسيما العيون والأرصاد والجواسيس الموالون لقواته ممن لا يعرفهم أحد وممن حرصوا على ستر ولائهم بانتظار لحظة الانقضاض المناسبة.
بعدها شاع استعمال هذا التعبير وخاصة حين سعى المحللون إلى تفسير السهولة الغريبة التي استطاعت بها جيوش هتلر أن تغزو أقطارا مجاورة في غرب وشمال أوروبا مثل هولندا أو النرويج.. يومها قال قائلهم:
ـ لم يكن الفضل فقط للقوات الزاحفة، بل كان لديهم المعلومات الموثوقة والاستخبارات الدقيقة والمتعاطفون المتسترون.. كان لديهم الطابور الخامس..
ولأن كل شئ يتغير حتى المصطلحات الراسخة المستقرة، فقد فضل دهاقنة الإعلام الأميركي، وخاصة بعد 11 سبتمبر ألا يستخدموا تعبير الطابور الخامس.. وبدلا منه استقروا على مصطلح «الخلايا النائمة» بمعنى المخططات الكامنة تحت السطح ولكنها لا تلبث أن تنشط للعمل في أي لحظة.. وهو مصطلح سلبي مازال ساريا ومتواترا في مفردات السياسة والميديا الأميركية لزوم الاستمرار في ترويع الجماهير وإدامة استنفارها.
طروادة: بها يحتفل تراث الإغريق وإبداعهم الثقافي الذي لايزال جزءا عزيزا من ذاكرة الإنسانية حتى الآن.. دارت على ساحاتها حرب طروادة الشهيرة التي خلدتها أبيات ملحمة «الإلياذة» المرتبطة باسم هوميروس شاعر الإغريق القديم الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد وإن تنافست على إدعاء مولده ونشأته كثير من حواضر العالم القديم ومنها اثينا وأزمير..
وكم افتتن أدباء الدنيا على مر العصور بإلياذة هوميروس.. وقد ترجمها إلى العربية سليمان البستاني (1856 - 5291( وكان من رجال الأدب وأعلام السياسة:
ولد في لبنان وعاش في كل من القاهرة وبغداد والبصرة وبيروت والآستانة وتولى الوزارة والنيابة في البرلمان واحتشد لترجمة ملحمة هوميروس وأتقن من أجل الترجمة عدة لغات ثم عمد إلى تصديرها بمقدمة ضافية تعد بدورها من عيون الكتابات الأدبية حيث أجمل فيها تاريخ الأدب عند العرب.
وترتبط طروادة بأمور شتى منها طبعا حربها الشهيرة مع اليونان من أجل استرداد هيلين اليونانية الجميلة التي اختطفها أمير طروادة الشاب وكان اسمه باريس..
وعندما أبحرت الأساطيل من أثينا واتجهت شرقا إلى ساحة القتال في طروادة بأرض الأناضول، البلاد التي تغني هوميروس بثرائها وازدهارها على يد مليكها الأشيب الوقور بريام وابنه الفارس الشجاع هكتور فضلا عن ثراء طروادة غنية بمواردها المعدنية والزراعية..
وبهذا كله ربما كانت مؤهلة لكي تهزم غزاة اليونان أو على الأقل تصمد أمامهم، لولا.. أن اصطنع الغزاة حيلة أدخلوا بها حصانا من خشب إلى داخل المدينة وكأنه لعبة أو ملهاة..
لكن كان يختبئ في جوف اللعبة الخشبية عدد من الفرسان الأغارقة الذين ساعدوا على فتح أبواب المدينة واستباحة مرافقها أمام الغزاة القادمين.. ومن هنا أصبح تعبير «حصان طروادة» عَلَما على كل حيلة أو مؤامرة تقصد إلى التضليل والخداع..
ولأن طروادة كانت غنية بمناجم الذهب - على نحو ما تقول أساطير الميثولوجيا - فقد اصطنعوا مصطلح «الوزن الطروادي» أو «نظام طروادة» الذي يتم بمقتضاه وزن وتقدير قيمة المعادن النفيسة وأحيانا المواد الخطيرة (العقاقير الثمينة). والحق أن تلك نسبة غير صحيحة، وأن طروادة لا علاقة لها بالمسألة لا من قريب ولا من بعيد..
والمشكلة هي الخلط بين طروادة (طُروى في الانجليزية) وبين مدينة طروى الفرنسية التي كانت مركزا تجاريا مزدهرا أيام العصور الوسطى وكانت موئلا لأكثر من سوق وأكثر من معرض للتجارة وعرض السلع المهمة في تلك الأيام ابتداء من الذهب والفضة وليس انتهاء بالسكر والمشروبات والحبوب.
. وفي تلك المدينة اعتمدوا تقسيم الرطل (باوند) إلى 12 أوقية وخلعوا على الأجزاء الصغرى تسمية «أونصة طروى» فكان أن خَلَط الناس بينها وبين ملحمة الإلياذة وأسموها «أوقية طروادة» ربما من باب الإعجاب بما أبدعته عبقرية شاعر الإغريق الأكبر هوميروس.
طرابلس: عند شطري الوطن العربي توجد مدينتان باسم واحد: الأولى طرابلس - المشرق في لبنان.. والثانية طرابلس الغرب في ليبيا.. وهذه المشاركة.. هل نقول التآخي في الاسم، تعكس عراقة التاريخ الممتد الذي تصدر عنه المدينتان.. حيث قد يرجع الاسم الموحد إلى لغة اليونان فيفيد المقطع الأول من الاسم بمعنى الثلاثة أو الثلاثي..
فيما يفيد المقطع الثاني «بولِس» بمعنى المدينة أو الحاضرة على نحو ما كانت أثينا أو اسبرطة في دنيا الإغريق. هذا النمط من الحواضر المثلثة كان سائدا منذ أيام النشأة الأولى لكل من المدينتين:
طرابلس - لبنان التي يرجع تشييدها إلى الفينيقيين نحو 800 سنة قبل الميلاد لتكون عاصمة اتحاد لممالك فينقية كانت زاهرة في تلك الفترة الباكرة وظلت على ازدهارها حتى أيام الرومان إلى أن فتحها المسلمون عام 638 للميلاد لتبقى ميناء وحاضرة متوسطية وموئلا للثقافة العربية القومية فضلا عن آثارها التي تجمع بين المسجد الكبير وقلعة دو سان جيل من أيام الحروب الصليبية إضافة إلى حمامات أثرية ومكتبات إسلامية.
طرابلس الإفريقية - التوأم مدينة متوسطية بدورها يعود تاريخها أيضا إلى أيام الرومان (القرن السابع قبل الميلاد) إلى أن فتحتها قوات عمرو بن العاص بعد فتح مصر.. وكان ذلك تحديدا في عام 643 للميلاد ومازالت عاصمة الجماهيرية الليبية.
وشأن كل الحواضر والثغور الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، كان طبيعيا أن تتعرض كل من المدينتين إلى غزوات وحروب، وأن تخضع في هذه المرحلة أو تلك لقوات الغزو الامبريالية على اختلاف العصور والجنسيات: طرابلس لبنان استولى عليها (الصليبيون) بل حّولوها إلى إمارة لاتينية في الفترة 1109 - 9821 للميلاد .
ولكنها استردت طابعها الوطني والقومي وهويتها العربية - الإسلامية بعد أن زحفت قوات السلطان المملوكي قلاوون (1279 - 1290) من القاهرة والشام إلى حيث استعادت طرابلس وطردت منها قوات الاحتلال الأوروبي الذي كان يرفع شعار الصليب.
من ناحيتها أيضا تعرضت طرابلس الغرب - الأفريقية إلى غزوات جحافل قرطاجنة والرومان ثم استولت عليها قوات قبائل الواندال البربرية الأوروبية وبعدها قوات بيزنطة (الدولة الرومانية الشرقية) عام 534 للميلاد إلى أن أضاءت بنور الإسلام واكتسبت هويتها العربية بعد أن وصلتها قوات عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي سرح فاتح منطقة أفريقية إلى حيث أقطار المغرب العربي.
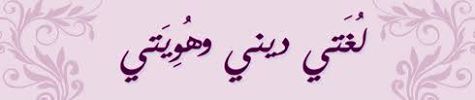
تعليق