التعددية الاثنية والثقافية في أدب الطيب صالح ... بقلم : عبد المنعم عجب الفيا
" إلى الذين يرون بعين واحدة ويتكلمون بلسان واحد ، ويرون الاشياء اما بيضاء واما سوداء "
مصطفى سعيد
في دراسته الرصينة المعنونة " متاهة قوم سود في ثقافة بيضاء" والتي اثارت كثير من الجدل اورد اخي الدكتور الباقر العفيف اسم الطيب صالح كاحد المثقفين الذين يودون لو يهربون من جلدهم السوداني كراهية في السواد. والشاهد الذي يصطحبه العفيف في ذلك هو رأي للطيب صالح حول اسم السودان كعلم على البلد المعروف حيث يقول :" تمنيت لو أن قادتنا سموا هذه البلاد سنار. فالاستعماريون أطلقوا هذا الاسم علي المنطقة التي تمتد من أثيوبيا في الشرق وحتى السنغال في الغرب. الأمم الأخرى أطلقت علي أوطانها أسماء تعنى شيئا بالنسبة لها."
تمنى الطيب صالح لو ان السودان سمى سنار لم يكن بدافع الهرب من السواد كما ظن دكتور العفيف ، و انما حجته في ذلك اننا لسنا السود الوحيدين في العالم وبالتالي فان اسم السودان لا يمثلنا وحدنا. بمعنى انه ليس له دلالة محددة على مجموعة سكانية وبقعة جغرافية ذات خصائص معينة كون امم كثيرة تشترك معنا في هذا السواد، فكلهم سودان ، على وزن بيضان.
لقد كان اختيار اسم للسودان مطروحا بالحاح عشية الاستقلال. وكان اسم سنار من بين اهم الاسماء المرشحة. وقيل ان صاحب هذا الاقتراح هو استاذ الجيل ، جمال محمد أحمد ، ذو الاصل النوبي. وهذا الاقتراح تزكيه عوامل تاريخية. فقد عرف شمال السودان في العالم الخارجي قبل الغزو التركي بسنار والتي امتد ملكها حتى غطى تقريبا كل السودان الشمالي المعروف الان.وتبعا لذلك كان جناح السودانيين بالازهر – آنئذ- يسمى رواق السناريين.
ومعي انني لست من أنصار تغيير اسم السودان الان ، الا ان من كانوا وراء اقتراح سنار لم يستبعدوا اسم السودان كراهية في السواد ، فسنار ايضا ترمز للسواد. فهي مملكة الفونج وهي المملكة الزرقاء، اي السوداء، فالازرق عند السودانيين مرادف للسواد. واذا كان العفيف يخلص في ورقته الى ان حال السودانيين الشماليين لن ينصلح الا اذا اعترفوا بالام الافريقية السوداء، ففي اسم سنار اعترافا بهذه الام السوداء. فقد تاسست سنار بتحالف من القبائل العربية والقبائل الافريقية ممثلة في الفونج والاثنيات الاخرى.
ولهذا السبب نفسه وقع اختيار "الغابة والصحراء" على سنار كرمز على التعددية الاثنية لسكان السودان. واذا كان العفيف قد خلص في دراسته إلى ان الخروج من المتاهة حسب وصفه يكمن في اقرار أهل شمال السودان بالعنصر الافريقي الذي فيهم فانه بذلك يكون قد انتهى الى نفس الرؤية التي دشنتها "الغابة والصحراء" .
ولهذا السبب نفسه وقع اختيار "الغابة والصحراء" على سنار كرمز على التعددية الاثنية لسكان السودان. واذا كان العفيف قد خلص في دراسته إلى ان الخروج من المتاهة حسب وصفه يكمن في اقرار أهل شمال السودان بالعنصر الافريقي الذي فيهم فانه بذلك يكون قد انتهى الى نفس الرؤية التي دشنتها "الغابة والصحراء" .
ويلمح العفيف ايضا الى مؤاخذة الطيب صالح ضمنا حينما يورد في بحثه : " ويعتبر تماهي الشماليين، مع المتنبي، في هجائه لكافور، النوبي، مثالا آخر علي تكوين نفسي منحرف." ربما لم يقصد العفيف بذلك الطيب صالح تحديدا الا ان الاشارة الى المتنبي هنا تستحضر قسرا محبة الطيب صالح للمتنبي. فالمعروف ان الطيب صالح فتن افتتانا عظيما بالمتنبي الا ان هذا الافتتان لم يقترن بكراهية كافور او يتماهي مع هجاء المتنبي ، كافورا.
بل ان الطيب صالح قد تصدي للمنافحة عن كافور في وجه من زعموا ان المتنبي لم يمدحه قط وان مدحه له ذم بما يشبه المدح. فقد ساء بعض العروبيين ان يمدح شاعر العربية الاول عبدا اسود. ومن هؤلاء محمود محمد شاكر الذي زعم أن المتنبي لم يمدح كافوراً الإخشيدي وإنما أضمر له الهجاء والسخرية فيما يظن أنه مدح. وضرب مثلا على ذلك تشبيه المتنبي لكافور مادحا بالشمس "المنيرة السوداء" اذ يرى محمود شاكر أن ليس في هذا مدحاً لكافور وإنما تهكم وسخرية فمن الاستحالة ان تكون هنالك شمس سوداء منيرة.
بل ان الطيب صالح قد تصدي للمنافحة عن كافور في وجه من زعموا ان المتنبي لم يمدحه قط وان مدحه له ذم بما يشبه المدح. فقد ساء بعض العروبيين ان يمدح شاعر العربية الاول عبدا اسود. ومن هؤلاء محمود محمد شاكر الذي زعم أن المتنبي لم يمدح كافوراً الإخشيدي وإنما أضمر له الهجاء والسخرية فيما يظن أنه مدح. وضرب مثلا على ذلك تشبيه المتنبي لكافور مادحا بالشمس "المنيرة السوداء" اذ يرى محمود شاكر أن ليس في هذا مدحاً لكافور وإنما تهكم وسخرية فمن الاستحالة ان تكون هنالك شمس سوداء منيرة.
وكان الدكتور طه حسين قد تصدي بالرد على مثل هذي الدعاوي واثبت ان المتنبي مدح كافور وان مدحه له لم يكن هجاء. اما الطيب صالح فيرد على محمود شاكر في كتابه (في صحبة المتنبي) بقوله: " كون المتنبي مدح كافورا الاخشيدي ، أمر لا مراء فيه."
ثم يدلل كيف للشمس ان تكون سوداء منيرة :" وعلي أيّة حال فنحن اليوم بعد كل ما أفدناه من علوم الفيزياء وخصائص اللون، وما فعله الرسامون التعبيريون، أقدر علي تخيل الشمس كيف تكون منيرة سوداء. وقد وضع أهل دولة غانا نجمة سوداء علي علمهم الوطني، لانهم رأوها أكثر ضواء من نجمة بيضاء. ومن أراد أن يعرف أكثر كيف يكون السواد مضيئا، فليقراء شعر سيدار سنقور وايمي سيزير".
ثم يدلل كيف للشمس ان تكون سوداء منيرة :" وعلي أيّة حال فنحن اليوم بعد كل ما أفدناه من علوم الفيزياء وخصائص اللون، وما فعله الرسامون التعبيريون، أقدر علي تخيل الشمس كيف تكون منيرة سوداء. وقد وضع أهل دولة غانا نجمة سوداء علي علمهم الوطني، لانهم رأوها أكثر ضواء من نجمة بيضاء. ومن أراد أن يعرف أكثر كيف يكون السواد مضيئا، فليقراء شعر سيدار سنقور وايمي سيزير".
الشاهد ان ادب الطيب، على خلاف ما يتصور دكتور العفيف وآخرون ، يقدم نموذجا ممتازا على الصورة التي يطمح اليها العفيف نفسه في دراسته القيمة. فادب الطيب لا يسعي الى الاعتراف بالام الافريقية الذي يتمناه العفيف على السودانيين الشماليين وحسب وانما يذهب ابعد من ذلك ويعترف بافريقية الاب نفسه.
فالمعروف ان الطيب صالح يتخذ من قرية سودانية متخيلة تسمى (ود حامد) مسرحا لاحداث قصصه ورواياته وتمثل هذه القرية صورة مصغرة اثنيا وثقافيا السودان الكبير. فمن هو ود حامد الذي سميت عليه هذه البلدة؟
في قصة "دومة ودحامد" قال الشيخ العجوز لمحدثه الذي جاءهم زائرا من البندر:"..هل أقص عليك يا بني قصة ود حامد ؟
"حدثني ابي عن جدي : كان ود حامد في الزمان السالف مملوكا لرجل فاسق وكان من اولياء الله الصالحين يتكتم ايمانه ولا يجرؤ على الصلاة جهارا حتى لا يفتك به سيده الفاسق . ولما ضاق ذرعا بحياته مع ذلك الكافر دعا الله ان ينقذه منه. فهتف به هاتف ان افرش مصلاتك على الماء ، فاذا وقفت بك على الشاطيء فانزل . وقفت به المصلاة عند موضع الدومة الان ، وكان مكانا خرابا."
اذن ان الجد الذي أسس قرية (ود حامد) مسرح ادب الطيب صالح، افريقي اسود. والكاتب يصور ود حامد وكانها تمثل بداية اولى او اصل اول. كانها انشقت عنها الارض فلا احد يذكر أصل نشاتها. وفي ذلك تماس مع احدث النظريات التي تذهب الى ان افريقيا الموطن الاول للجنس البشري. وكون ان ود حامد افريقي اسود وولي صالح استدعاء لذلك الاصل الاول ممثلا في آدم الذي اشتق اسمه من الادمة وهي السمرة و السواد ومنها الاديم وجه الارض اي التراب.
وهنا لا بد من الاشارة اقتضابا ،ان السواد هو أصل العرب او قل الخضرة والسمرة هي اصلهم. فقد جاء في الحديث الشريف :" بعثت الى الاسود والاحمر " وفهم الصحابة ان الاسود يقصد به العرب ومن شاكلهم والاحمر الامم البيضاء من فرس وروم. وتلك قضية اخرى بنى عليها العفيف أس مقاله ، لا نريد التوسع فيها الان.
في قصة "دومة ودحامد" قال الشيخ العجوز لمحدثه الذي جاءهم زائرا من البندر:"..هل أقص عليك يا بني قصة ود حامد ؟
"حدثني ابي عن جدي : كان ود حامد في الزمان السالف مملوكا لرجل فاسق وكان من اولياء الله الصالحين يتكتم ايمانه ولا يجرؤ على الصلاة جهارا حتى لا يفتك به سيده الفاسق . ولما ضاق ذرعا بحياته مع ذلك الكافر دعا الله ان ينقذه منه. فهتف به هاتف ان افرش مصلاتك على الماء ، فاذا وقفت بك على الشاطيء فانزل . وقفت به المصلاة عند موضع الدومة الان ، وكان مكانا خرابا."
اذن ان الجد الذي أسس قرية (ود حامد) مسرح ادب الطيب صالح، افريقي اسود. والكاتب يصور ود حامد وكانها تمثل بداية اولى او اصل اول. كانها انشقت عنها الارض فلا احد يذكر أصل نشاتها. وفي ذلك تماس مع احدث النظريات التي تذهب الى ان افريقيا الموطن الاول للجنس البشري. وكون ان ود حامد افريقي اسود وولي صالح استدعاء لذلك الاصل الاول ممثلا في آدم الذي اشتق اسمه من الادمة وهي السمرة و السواد ومنها الاديم وجه الارض اي التراب.
وهنا لا بد من الاشارة اقتضابا ،ان السواد هو أصل العرب او قل الخضرة والسمرة هي اصلهم. فقد جاء في الحديث الشريف :" بعثت الى الاسود والاحمر " وفهم الصحابة ان الاسود يقصد به العرب ومن شاكلهم والاحمر الامم البيضاء من فرس وروم. وتلك قضية اخرى بنى عليها العفيف أس مقاله ، لا نريد التوسع فيها الان.
الشاهد أن الام الافريقية التي يطمح دكتور العفيف الى ضرورة الاقرار بانحدارنا منها، نجدها ممثلة في أشهر شخصية روائية في الادب العربي الحديث، وهي شخصية مصطفى سعيد بطل رواية موسم الهجرة الى الشمال. فقد " كان ابوه من العبابدة ، القبيلة التي تعيش بين مصر والسودان . ويقال ان امه رقيق من الجنوب. من قبائل الزاندي أو الباريا."
وحين سألت ايزابيلا سيمور، مصطفى سعيد : "ما جنسك ؟ هل أنت أفريقي ام اسيوى؟ اجابها : " أنا مثل عطيل . عربي أفريقي " .
وعطيل الذي يشبه به مصطفى سعيد نفسه،هو بطل مسرحية (عطيل ) الشهيرة لوليم شكسبير وهي ماخوذة من قصة " القائد المغربي " المنحدر من اصل افريقي والذي نشأ في ايطاليا في القرون الوسطى ، وتبوأ أرفع المناصب العسكرية وتزوج من اجمل بناتها ومن انبل الاسر. ووجه الشبه بين الاثنيين ان كلاهما أسود من افريقيا وكلاهما جاء الى اوربا وحظي بقبول من المجتمع الاوربي. !!
وقد كان الطيب صالح على ادراك كاف بضرورة الوعي بهذ التعددية الاثنية والثقافية وهو يكتب رواية موسم الهجرة الى الشمال اذ انه يقول في سياق حديث عن فانون : " وبهذه المناسبة أنا قرأت فرانز فانون بعد موسم الهجرة ، فوجدت انني متفق معه تمام الاتفاق. " والمعروف ان فانون هو صاحب كتاب " وجوه سود، أقنعة بيضاء" الذي ربما استوحى منه الدكتور الباقر عفيف عنوان بحثه الرصين.
وحين سألت ايزابيلا سيمور، مصطفى سعيد : "ما جنسك ؟ هل أنت أفريقي ام اسيوى؟ اجابها : " أنا مثل عطيل . عربي أفريقي " .
وعطيل الذي يشبه به مصطفى سعيد نفسه،هو بطل مسرحية (عطيل ) الشهيرة لوليم شكسبير وهي ماخوذة من قصة " القائد المغربي " المنحدر من اصل افريقي والذي نشأ في ايطاليا في القرون الوسطى ، وتبوأ أرفع المناصب العسكرية وتزوج من اجمل بناتها ومن انبل الاسر. ووجه الشبه بين الاثنيين ان كلاهما أسود من افريقيا وكلاهما جاء الى اوربا وحظي بقبول من المجتمع الاوربي. !!
وقد كان الطيب صالح على ادراك كاف بضرورة الوعي بهذ التعددية الاثنية والثقافية وهو يكتب رواية موسم الهجرة الى الشمال اذ انه يقول في سياق حديث عن فانون : " وبهذه المناسبة أنا قرأت فرانز فانون بعد موسم الهجرة ، فوجدت انني متفق معه تمام الاتفاق. " والمعروف ان فانون هو صاحب كتاب " وجوه سود، أقنعة بيضاء" الذي ربما استوحى منه الدكتور الباقر عفيف عنوان بحثه الرصين.
وتتجسد التعددية الاثنية في أبهي صورها في شخصية الطاهر ود الرواس وهو من احب الشخصيات الى قلب الراوي ( يمكنك ان تقرأ الكاتب ) واحد شلة محجوب اهل الحل والعقد في ود حامد قبل ان ينفرط عقد المجتمع التقليدي اثر ظهور الاجيال الجديدة بفضل انتشار التعليم الحديث. فقد كان والد ود الرواس عبدا رقيقا يدعى بلال وامه حواء بيت العريبي من ديار الكبابيش بكردفان. وقد تزوج الطاهر ود الرواس بفاطمة بت جبر الدار شقيقة محجوب.
يخصص الطيب صالح فصلا كاملا من فصول رواية "مريود" الاربعة للطاهر ود الرواس حيث يبدا بمونولوج يتحول الى ديالوج حميم بين الراوي محيميد والطاهر يعبر عن علاقة خاصة ربطت بين الاثنين. يقول الطاهر في ذلك الديالوج: " الانسان يا محيميد .. الحياة يا محميد ما فيها غير حاجتين اثنين .. الصداقة والمحبة . ما تقول لي لا حسب ولا نسب ، لا جاه ولا مال .. ابن آدم اذا كان ترك الدنيا وعنده ثقة انسان واحد ، يكون كسبان. وانا المولى عز وجل اكرمني بلحيل . انعم علي بدل النعمة نعمتين .. اداني صداقة محجوب وحب فاطمة بت جبر الدار . "
هنا يحس محيميد بحزن لكونه كان يظن صداقته للطاهر لا تدانيها صداقة " فقد كنت طول حياتي ، اعتبر صداقته شرفا لي . لذلك قلت له برفق : وعبد الحفيظ ..وسعيد ..و.. " قال : " عبد الحفيظ اخوي وسعيد اخوي .. لكين الانسان .. الاخ .. الصديق .. الراجل اليوزن الف راجل .. الكلام على القلوب ، جوه ، جوه ، الحكاية مو الطاهر ود الرواسي .. الحكاية الجد حكاية الطاهر ود بلال .. ولد حواء .. العبد . " ثم قال : " كذابه المره ال تقول ولدت مثل محجوب ود جبر الدار "
يخصص الطيب صالح فصلا كاملا من فصول رواية "مريود" الاربعة للطاهر ود الرواس حيث يبدا بمونولوج يتحول الى ديالوج حميم بين الراوي محيميد والطاهر يعبر عن علاقة خاصة ربطت بين الاثنين. يقول الطاهر في ذلك الديالوج: " الانسان يا محيميد .. الحياة يا محميد ما فيها غير حاجتين اثنين .. الصداقة والمحبة . ما تقول لي لا حسب ولا نسب ، لا جاه ولا مال .. ابن آدم اذا كان ترك الدنيا وعنده ثقة انسان واحد ، يكون كسبان. وانا المولى عز وجل اكرمني بلحيل . انعم علي بدل النعمة نعمتين .. اداني صداقة محجوب وحب فاطمة بت جبر الدار . "
هنا يحس محيميد بحزن لكونه كان يظن صداقته للطاهر لا تدانيها صداقة " فقد كنت طول حياتي ، اعتبر صداقته شرفا لي . لذلك قلت له برفق : وعبد الحفيظ ..وسعيد ..و.. " قال : " عبد الحفيظ اخوي وسعيد اخوي .. لكين الانسان .. الاخ .. الصديق .. الراجل اليوزن الف راجل .. الكلام على القلوب ، جوه ، جوه ، الحكاية مو الطاهر ود الرواسي .. الحكاية الجد حكاية الطاهر ود بلال .. ولد حواء .. العبد . " ثم قال : " كذابه المره ال تقول ولدت مثل محجوب ود جبر الدار "
نشأ بلال كما يورى ابنه الطاهر ، عبدا هملا بلا سيد كل الرقيق لهم اسياد الا بلال . ويقال انه ربما كان من ذرية رقيق كان لملك حكم ذلك الاقليم في الزمن القديم يدعى بندر شاه . ولكن ابراهيم ود طه يؤكد ان بلالا هو الابن الثاني عشر لعيسى ود ضو البيت من جارية له سوداء جميلة ذكية كان يحبها ويؤثرها . ولكنه لم يلحقه بنسبه ولما مات خجل اخوته ان يسترقوه.لذلك نشا بلال لا هو حر يقال له ابن فلان ولا هو عبد يقال له عبد فلان. وكان هو في خاصة نفسه انسانا عجيبا ، جميل الهيئة ، جميل الطباع ، متعففا ورعا ، اخلاقه اخلاق سادة أماجد. ومن عجب انه شب كانه نزل فجاة من السماء ، او انشقت عنه الارض، او انه طلع ن النيل ، شخصا كامل الهيئة والتكوين. فلا انسان من اهل البلد يذكره طفلا ، ولا احد يعلم من رباه ولا احد يقول لك رايت بلالا ، او سمعت بلالا ، الى ان ظهر فجأة وهو فتى يافع ، يلازم الشيخ نصر الله ود حبيب ويقوم على خدمته.
انتبه اهل البلد فجأة الى هذا الانسان البديع الذي يخلب جماله القلب ويفتت صوته الصخر ويلين الحديد. كان حين ينادي بصوته الاعجم : " أشهد الا اله الا اله اشهد ان مهمدا رسول الله الاه " تحس كأن ود حامد كلها بانسها وحيوانها وشجرها وحجارها ، ورملها وطينها ، من اسفلها الى اعلاها ، من برها الى بحرها ، قد اهتزت وارتجت واصابتها قشعريرة. لم يكن دعاؤه دعاء الى الصلاة ، وانما كان دعاء الحياة منذ عهد آدم، ودعاء الموت منذ كان جبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل."
وود الرواس لقب ورثه الطاهر عن ابيه. كان الكاشف ود رحمة الله يقول ان بلال رواس ويسالونه رواس ماذا ، فيجيب " رواس مراكب القدرة " ويقسم انه رآه عدة مرات بين العشاء والفجر وهو قائم وحده في مركب ينقل قوما غريبي الهيئة الى الشاطيء الاخر.
اما والدة الطاهر ود الرواسي فهي حواء بت العريبي. فقد كانت امراة صاعقة الحسن. هبطت من ديار الكبابيش مع ابويها في سنوات قحط وجدب. فماتا عنها ، وبقيت وحدها تمشط وتغزل وتعمل في دور الميسورين في البلد. وصفوا ان وجهها كان كفلق الصباح وشعرها اسود كالليل مسدل فوق ظهرها الى عجيزتها ، وانها كانت فرعاء لفاء طويلة رموش العينيين اسيلة الخدين كأن في فمها مشتار عسل ، وانها كانت مع ذلك شديدة الذكاء، قوية العين ، مهذارا ، حلوة الحديث. فارادها الكثيرون فتمنعت واعتصمت ولم تقبل منهم طالب حلال او حرام. ولكن ولم يعلق قلب حواء هذه دون الناس جميعا الا بلال. فكانت تعرض له وهو في صلاته وعبادته فلا يرد عليها ولا يجاوبها . ولما اعيتها الحيلة ذهبت الى الشيخ نصر الله ود حبيب وشكت له وتذللت وتفرعت فاشار على بلال ان يتزوجها.
فصدع لامر شيخه وتزوج حواء ولكن لم يجتمع بها الا ليلة واحدة بعدها استاذن شيخه ان يسمح له بان يبريء ذمته منها فاذن له وكانت ان حبلت منه بابنه الذي يسمي الطاهر ود الرواس وبعد ان سرحها بلال ابت ان تدخل على رجل آخر وانصرفت لتربية ابنها فكان شانها في ذلك شان المتصوفة العاكفين " .
انتبه اهل البلد فجأة الى هذا الانسان البديع الذي يخلب جماله القلب ويفتت صوته الصخر ويلين الحديد. كان حين ينادي بصوته الاعجم : " أشهد الا اله الا اله اشهد ان مهمدا رسول الله الاه " تحس كأن ود حامد كلها بانسها وحيوانها وشجرها وحجارها ، ورملها وطينها ، من اسفلها الى اعلاها ، من برها الى بحرها ، قد اهتزت وارتجت واصابتها قشعريرة. لم يكن دعاؤه دعاء الى الصلاة ، وانما كان دعاء الحياة منذ عهد آدم، ودعاء الموت منذ كان جبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل."
وود الرواس لقب ورثه الطاهر عن ابيه. كان الكاشف ود رحمة الله يقول ان بلال رواس ويسالونه رواس ماذا ، فيجيب " رواس مراكب القدرة " ويقسم انه رآه عدة مرات بين العشاء والفجر وهو قائم وحده في مركب ينقل قوما غريبي الهيئة الى الشاطيء الاخر.
اما والدة الطاهر ود الرواسي فهي حواء بت العريبي. فقد كانت امراة صاعقة الحسن. هبطت من ديار الكبابيش مع ابويها في سنوات قحط وجدب. فماتا عنها ، وبقيت وحدها تمشط وتغزل وتعمل في دور الميسورين في البلد. وصفوا ان وجهها كان كفلق الصباح وشعرها اسود كالليل مسدل فوق ظهرها الى عجيزتها ، وانها كانت فرعاء لفاء طويلة رموش العينيين اسيلة الخدين كأن في فمها مشتار عسل ، وانها كانت مع ذلك شديدة الذكاء، قوية العين ، مهذارا ، حلوة الحديث. فارادها الكثيرون فتمنعت واعتصمت ولم تقبل منهم طالب حلال او حرام. ولكن ولم يعلق قلب حواء هذه دون الناس جميعا الا بلال. فكانت تعرض له وهو في صلاته وعبادته فلا يرد عليها ولا يجاوبها . ولما اعيتها الحيلة ذهبت الى الشيخ نصر الله ود حبيب وشكت له وتذللت وتفرعت فاشار على بلال ان يتزوجها.
فصدع لامر شيخه وتزوج حواء ولكن لم يجتمع بها الا ليلة واحدة بعدها استاذن شيخه ان يسمح له بان يبريء ذمته منها فاذن له وكانت ان حبلت منه بابنه الذي يسمي الطاهر ود الرواس وبعد ان سرحها بلال ابت ان تدخل على رجل آخر وانصرفت لتربية ابنها فكان شانها في ذلك شان المتصوفة العاكفين " .
وتظهر عبقرية الطيب صالح في نسج قماشة التعدية الثفافية والاثنية لاهل السودان في معرض تقصيه لاصل "بندر شاه" الذي يقال انه كان سيدا لبلال وذلك في رواية (مريود) . يزعم بعض رواة الاخبار في ود حامد ان بندرشاه كان ملكا نصرانيا من ملوك النوبة بسط سلطانه قبلي الى غاية ديار المناصير وبحرى الى حدود الريف وكانت عاصمة ملكه حيث تقوم ود حامد اليوم.
وفي رواية ان ذلك الملك لم يكن نصرانيا ولكنه كان ملكا وثنيا غزا ذلك الاقليم بجيش عظيم من الجنود السود من أعالي النيل ، وانهم أقاموا في نواحي ود حامد وما جاورها مملكة سوداء قوية لم تزل تامر وتنهي حتى حطمها عبد الله جماع ابان صعود نجم ملكة سنار. وقالوا ان اسمه لم يكن بندرشاه بل بانقي او جانقي.
ويرجح بعض المؤرخين ان بندرشاه امير حبشي يدعى مندرس هرب بسبب صراعات على الملك ايام الملك راس تغري الاكبر ، ومعه نساؤه وعياله وعدد من جنده وعبيده. وانهم عبروا النيل الى المتمة ثم قطعوا صحراء بيوضة الى ان وصلوا منعطف النهر حيث تقوم ود حامد الان. فاقاموا هنالك وبنوا بلدا اسموها دابوراس اي الربوة بلغتهم.
وفي رواية ان بندرشاه لم يكن هذا ولا ذاك بل كان رجلا ابيض اللون وفد على ود حامد حيث لا يعلم احد أيام الغارات والهيجات واواخر ملوك سنار فاقام في ود حامد واخذ يعمل في تجارة الرقيق .
اما ابراهيم ود طه وهو راوية ثقة في تاريخ ود حامد فيؤكد ان بندرشاه هو عيسى ود ضو البيت. وكان ضو البيت رجلا من الاشراف وفد على ود حامد من الحجاز وتوطن فيها وتزوج فاطمة بت جبر الدار الاولى من قبيلة الحوامدة اصحاب الاصل والفصل. وان بندرشاه كان لقبه عرف به في صباه."
هكذا باسلوب الروايات التاريخية عن اصل الاجناس ودون تغليب لرواية على اخرى يعرض الطيب صالح لاصل بندرشاه وكانه يريد ان يقول ان اصول السودانيين تعدد بتعدد هذه الروايات.
وفي رواية ان ذلك الملك لم يكن نصرانيا ولكنه كان ملكا وثنيا غزا ذلك الاقليم بجيش عظيم من الجنود السود من أعالي النيل ، وانهم أقاموا في نواحي ود حامد وما جاورها مملكة سوداء قوية لم تزل تامر وتنهي حتى حطمها عبد الله جماع ابان صعود نجم ملكة سنار. وقالوا ان اسمه لم يكن بندرشاه بل بانقي او جانقي.
ويرجح بعض المؤرخين ان بندرشاه امير حبشي يدعى مندرس هرب بسبب صراعات على الملك ايام الملك راس تغري الاكبر ، ومعه نساؤه وعياله وعدد من جنده وعبيده. وانهم عبروا النيل الى المتمة ثم قطعوا صحراء بيوضة الى ان وصلوا منعطف النهر حيث تقوم ود حامد الان. فاقاموا هنالك وبنوا بلدا اسموها دابوراس اي الربوة بلغتهم.
وفي رواية ان بندرشاه لم يكن هذا ولا ذاك بل كان رجلا ابيض اللون وفد على ود حامد حيث لا يعلم احد أيام الغارات والهيجات واواخر ملوك سنار فاقام في ود حامد واخذ يعمل في تجارة الرقيق .
اما ابراهيم ود طه وهو راوية ثقة في تاريخ ود حامد فيؤكد ان بندرشاه هو عيسى ود ضو البيت. وكان ضو البيت رجلا من الاشراف وفد على ود حامد من الحجاز وتوطن فيها وتزوج فاطمة بت جبر الدار الاولى من قبيلة الحوامدة اصحاب الاصل والفصل. وان بندرشاه كان لقبه عرف به في صباه."
هكذا باسلوب الروايات التاريخية عن اصل الاجناس ودون تغليب لرواية على اخرى يعرض الطيب صالح لاصل بندرشاه وكانه يريد ان يقول ان اصول السودانيين تعدد بتعدد هذه الروايات.
ومن عجب ان هذه الرؤية التعددية الثقافية والاثنية المتسامحة والمنفتحة على كل تنويعات الواقع المتشابكة والتي جاءت في صيغ رمزية ايحائية بليغة بعيدا عن الشوفينية والهتافية والشعارات التقريرية ، تعرضت وتتعرض لكثير من سوء الفهم وسوء التخريج من اصحاب النظرة الاحادية الشوفينية. " الذين يرون الاشياء اما سوداء واما بيضاء " . فانصار التوجه العروبي الصرف راوا فيها انتقاصا من عروبتهم بينما راي فيها اصحاب التوجه الافريقاني الاحادي تكريسا لثقافة المركز العربية الاسلامية.
فاذا كان دكتور الباقر عفيف يرى ان حال السودانيين الشماليين لا ينصلح مع ذواتهم وبني جلدتهم من الاقوام الاخرى الا اذا اقروا بالافريقي في داخلهم ، فان دكتور ايلياء حريق، القومي العروبي فتخيل اليه عقيدته العروبية ، ان الاعتراف بالام الافريقية في السوداني الشمالي ، هو أس البلاء !! فلا يتورع من الادعاء ان انحدار مصطفى سعيد من ام جنوبية هو الذي قاده الى الماساة والهلاك لذلك فهو يحذر السوادنيين الشماليين من خطورة الاقرار بالعنصر الافريقي في ذاتهم ، والا كانت نهايتهم مثل نهاية بطل موسم الهجرة الى الشمال!!!
يقول دكتور حريق في مقدمة كتاب (الثقافة والديمقراطية) لمؤلفه الدكتور عبد الله علي ابراهيم : " أن مصطفى سعيد يمثل السودان تمثيلا كليا ، فهو سوداني من أب شمالي وأم جنوبية" وهو " في المظهر الأول يتمتع بعقل بالغ الحدة والذكاء ويبرز في الجامعات البريطانية ومحافلها الفكرية ، وفي المظهر الثاني هو طفل شهواني غر يلاحق اللذة والمتعة حيث يمكنه أن يقتنصها حلالا كانت أو حراما " .
ولما كانت ازدواجية الانتماء هي سبب فشل مصطفى سعيد وتدميره بل أن انتمائه إلى الجانب الأفريقي هو سبب مأساته على رأي الكاتب فأنه يحذرنا من المزاوجة بين الانتماء العربي والأفريقي اذ يرى فيه فصلا بين العقـل والأخلاق.
فاذا كان دكتور الباقر عفيف يرى ان حال السودانيين الشماليين لا ينصلح مع ذواتهم وبني جلدتهم من الاقوام الاخرى الا اذا اقروا بالافريقي في داخلهم ، فان دكتور ايلياء حريق، القومي العروبي فتخيل اليه عقيدته العروبية ، ان الاعتراف بالام الافريقية في السوداني الشمالي ، هو أس البلاء !! فلا يتورع من الادعاء ان انحدار مصطفى سعيد من ام جنوبية هو الذي قاده الى الماساة والهلاك لذلك فهو يحذر السوادنيين الشماليين من خطورة الاقرار بالعنصر الافريقي في ذاتهم ، والا كانت نهايتهم مثل نهاية بطل موسم الهجرة الى الشمال!!!
يقول دكتور حريق في مقدمة كتاب (الثقافة والديمقراطية) لمؤلفه الدكتور عبد الله علي ابراهيم : " أن مصطفى سعيد يمثل السودان تمثيلا كليا ، فهو سوداني من أب شمالي وأم جنوبية" وهو " في المظهر الأول يتمتع بعقل بالغ الحدة والذكاء ويبرز في الجامعات البريطانية ومحافلها الفكرية ، وفي المظهر الثاني هو طفل شهواني غر يلاحق اللذة والمتعة حيث يمكنه أن يقتنصها حلالا كانت أو حراما " .
ولما كانت ازدواجية الانتماء هي سبب فشل مصطفى سعيد وتدميره بل أن انتمائه إلى الجانب الأفريقي هو سبب مأساته على رأي الكاتب فأنه يحذرنا من المزاوجة بين الانتماء العربي والأفريقي اذ يرى فيه فصلا بين العقـل والأخلاق.
طبعا الذي قاد مصطفى سعيد الى الماساة والهلاك لا علاقة له بعرقه العربي او الافريقي. لقد اراد بطل رواية موسم الهجرة الى الشمال ان ينتقم لكرامته من المستعمر الانجليزي من خلال ذهنيته الفحولية التي اوحت إاليه ان التفوق العقلي ليس كافيا لرد الاعتبار لذاته، فينغمس في حياة بوهيمية مع الفتيات الانجليزات ظنا منه ان الثار للكرامة لا يكون الا بهتك عرض الأوربيين. كان يقول : " لهم جئتكم غازيا .." وكان يقول : " ساحرر افريقيا بــ... " اي بفحولتي . حتى قاده ذلك الطريق الى التسبب في انتحار ثلاثة فتيات منهن وقتل من يتزوجها . فينتهي الى السجن ليقضي فيه سبع سنوات. بعد خروجه من السجن يتشرد في أصقاع الارض ثم يعود الى السودان ويختار قرية في الشمال على النيل ليستقر فيها ويتزوج وينجب ويساهم في تطوير القرية وينال تقدير الناس ولكنه يموت غرقا ،أو إنتحارا ، في أحد الفيضانات.
ما غاب على ايلياء حريق ادراكه أن فشل مصطفى سعيد في الانتقام والثار لكرامته بذلك الاسلوب الملتو ، يمثل درسا من الطيب صالح على ضرورة تجاوز مرارات التجربة الاستعمارية والانهماك في معركة التعمير والرقي من خلال العلم والعقل والتعايش السلمي والاحترام الثقافي المتبادل.
ما غاب على ايلياء حريق ادراكه أن فشل مصطفى سعيد في الانتقام والثار لكرامته بذلك الاسلوب الملتو ، يمثل درسا من الطيب صالح على ضرورة تجاوز مرارات التجربة الاستعمارية والانهماك في معركة التعمير والرقي من خلال العلم والعقل والتعايش السلمي والاحترام الثقافي المتبادل.
أما الفريق الاخر الافريقاني، فتصور له نظرته الاحادية، ان قصص الطيب صالح تروج لثقافة المركز الاسلاموعربية.يقول الدكتور محمد جلال هاشم في ورقته الرصينة السودانوعروبية:"إن عالم الطيب صالح القصصي هو نفس عالم ثقافة المركز القائمة على الأسلمة والاستعراب".
ان الاديب القاص يشتغل على واقع خام معطي سلفا ، لا يد له في خلقه. فاذا كان هذا الواقع ذو ثقافة اسلامية عربية كبيئة شمال السودان التي يمتح منها الطيب صالح في تصوير عالمه القصصي فان فنه القصصي لا بد بالضرورة ان يعبر عن هذا الواقع بكل ابعاده الثقافية الاثنية واللغوية، دون التماهي بالطبع مع النزعات العنصرية ، وهذا مع فعله الطيب صالح بتبنيه للرؤية التعددية المتصالحة ، التي تسع الجميع على النحو الذي استعرضناه اعلاه.
فالقرية في ادب الطيب صالح " هي السودان بقبائله المتنافرة ، الراحلة ، والمقيمة ، بحلبه وزنجه ، وعربه المختلفين.. بطبقاته المصطرعة المتقاتلة ، بثقافاته الوافدة والموروثة ، صوفية كانت او علمانية ، بمدنه وفجورها و .. و .. ولا يلزم الكاتب ان يمثل لكل المؤسسات والطبقات والفئات ولكن يكفيه ان يشير ويوميء ويترك للقاريء أن يفهم." أو كما قال عثمان حسن احمد في مقالته السديدة المنشورة بكتاب " عبقري الرواية العربية ".
أم المطلوب من الطيب صالح ان يكتب لنا قصصه بلغة وثقافة الدينكا او الهدندوة او الفور او النوبة حتى نرضى عن انتمائه كسوداني افريقي ؟
ان القبول بالاخر لا يلزم التنازل عن الخصوصية الثقافية والاثنية لارضاء ذلك الاخر. فالعربي او الافروعربي المسلم ، غير مطالب ان يتخلي عن لسانه العربي وعن ثقافته الاسلامية لكي يعيش مع الافريقي في دولة واحدة .كذلك الافريقي غير مطالب ان يتنازل عن لغته الافريقية وديانته اذا كان يدين بغير الاسلام حتى يقبل به العربي المسلم في وطن واحد. والمظلة التي تاوي الجميع دون تمييز هي دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الدستورية المفترضة.
ان الاديب القاص يشتغل على واقع خام معطي سلفا ، لا يد له في خلقه. فاذا كان هذا الواقع ذو ثقافة اسلامية عربية كبيئة شمال السودان التي يمتح منها الطيب صالح في تصوير عالمه القصصي فان فنه القصصي لا بد بالضرورة ان يعبر عن هذا الواقع بكل ابعاده الثقافية الاثنية واللغوية، دون التماهي بالطبع مع النزعات العنصرية ، وهذا مع فعله الطيب صالح بتبنيه للرؤية التعددية المتصالحة ، التي تسع الجميع على النحو الذي استعرضناه اعلاه.
فالقرية في ادب الطيب صالح " هي السودان بقبائله المتنافرة ، الراحلة ، والمقيمة ، بحلبه وزنجه ، وعربه المختلفين.. بطبقاته المصطرعة المتقاتلة ، بثقافاته الوافدة والموروثة ، صوفية كانت او علمانية ، بمدنه وفجورها و .. و .. ولا يلزم الكاتب ان يمثل لكل المؤسسات والطبقات والفئات ولكن يكفيه ان يشير ويوميء ويترك للقاريء أن يفهم." أو كما قال عثمان حسن احمد في مقالته السديدة المنشورة بكتاب " عبقري الرواية العربية ".
أم المطلوب من الطيب صالح ان يكتب لنا قصصه بلغة وثقافة الدينكا او الهدندوة او الفور او النوبة حتى نرضى عن انتمائه كسوداني افريقي ؟
ان القبول بالاخر لا يلزم التنازل عن الخصوصية الثقافية والاثنية لارضاء ذلك الاخر. فالعربي او الافروعربي المسلم ، غير مطالب ان يتخلي عن لسانه العربي وعن ثقافته الاسلامية لكي يعيش مع الافريقي في دولة واحدة .كذلك الافريقي غير مطالب ان يتنازل عن لغته الافريقية وديانته اذا كان يدين بغير الاسلام حتى يقبل به العربي المسلم في وطن واحد. والمظلة التي تاوي الجميع دون تمييز هي دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الدستورية المفترضة.
-------------
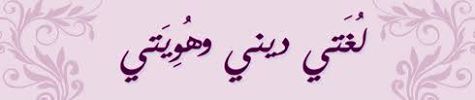
تعليق