[align=justify]أخي الحبيب الغالي الأستاذ بلقاسم علواش سلمه الله،
السلام عليكم،
أعتذر أشد الاعتذار لحضرتك على التأخر في الرد على مشاركتك الطيبة وإضافتك القيمة. وما أخرني في قراءاها أولا ثم الرد عليها ثانيا إلا السفر المتواصل، فاعذرني أيها الأخ الغالي.
العلمانية، في مفهومها التاريخي الأول (= laïcism) هي فك ارتباط عضوي وتشابك بنيوي بين طبقة الكهنة وطبقة العامة في الديانية المسيحية، فهي مرتبطة بها ولا يمكن تخيلها - أي العلمانية - بدونها - أي الديانة المسيحية. أدى فك التشابك هذا إلى نشوء دين يصفه المفكر الفرنسي غوشيه (Gauchet) بأنه "دين الخروج من الدين". أدى هذا الخروج من الدين، بدوره، إلى نشوء ثقافة إلحاد علماني حدت بالفيلسوف الماركسي الفرنسي إرنست بلوخ (Ernst Bloch) إلى اعتباره - أي الإلحاد العلماني - منتجا نصرانيا بامتياز، وهو الذي يفسر مقولته الشهيرة: "فقط المسيحي الحقيقي يمكن أن يكون ملحدا ممتازا، وفقط الملحد الحقيقي يمكن أن يكون مسيحيا ممتازا". وهذا يعني أنه لا يمكن لغير المسيحي أن يعتنق مبادئ العلمانية ويتذوق لطائفها لأنها مرتبطة ارتباطا بنيويا ببنية الديانة النصرانية.
ولقد كانت العلمانية، وما زالت، حلا مناسبا للكثير من مشاكل أوروبا الدينية. أما مشاكل المسلمين الدينية فهي مختلفة وتحتاج إلى حل لها يُسْتَلهم من الينابيع العقلانية في الثقافة العربية الإسلامية، وهي الينابيع التي تحاول الدكتاتوريات السياسية الجاهلية من جهة، والتطرف الديني الجاهلي من جهة أخرى، أن يجففاها إلى الأبد.
تحياتي العطرة مع اعتذاري مرة أخرى في التأخر في الرد على حضرتك[/align].
السلام عليكم،
أعتذر أشد الاعتذار لحضرتك على التأخر في الرد على مشاركتك الطيبة وإضافتك القيمة. وما أخرني في قراءاها أولا ثم الرد عليها ثانيا إلا السفر المتواصل، فاعذرني أيها الأخ الغالي.
العلمانية، في مفهومها التاريخي الأول (= laïcism) هي فك ارتباط عضوي وتشابك بنيوي بين طبقة الكهنة وطبقة العامة في الديانية المسيحية، فهي مرتبطة بها ولا يمكن تخيلها - أي العلمانية - بدونها - أي الديانة المسيحية. أدى فك التشابك هذا إلى نشوء دين يصفه المفكر الفرنسي غوشيه (Gauchet) بأنه "دين الخروج من الدين". أدى هذا الخروج من الدين، بدوره، إلى نشوء ثقافة إلحاد علماني حدت بالفيلسوف الماركسي الفرنسي إرنست بلوخ (Ernst Bloch) إلى اعتباره - أي الإلحاد العلماني - منتجا نصرانيا بامتياز، وهو الذي يفسر مقولته الشهيرة: "فقط المسيحي الحقيقي يمكن أن يكون ملحدا ممتازا، وفقط الملحد الحقيقي يمكن أن يكون مسيحيا ممتازا". وهذا يعني أنه لا يمكن لغير المسيحي أن يعتنق مبادئ العلمانية ويتذوق لطائفها لأنها مرتبطة ارتباطا بنيويا ببنية الديانة النصرانية.
ولقد كانت العلمانية، وما زالت، حلا مناسبا للكثير من مشاكل أوروبا الدينية. أما مشاكل المسلمين الدينية فهي مختلفة وتحتاج إلى حل لها يُسْتَلهم من الينابيع العقلانية في الثقافة العربية الإسلامية، وهي الينابيع التي تحاول الدكتاتوريات السياسية الجاهلية من جهة، والتطرف الديني الجاهلي من جهة أخرى، أن يجففاها إلى الأبد.
تحياتي العطرة مع اعتذاري مرة أخرى في التأخر في الرد على حضرتك[/align].


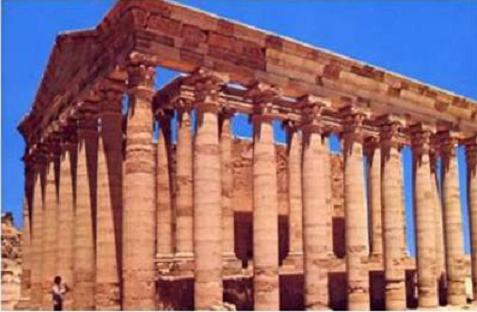
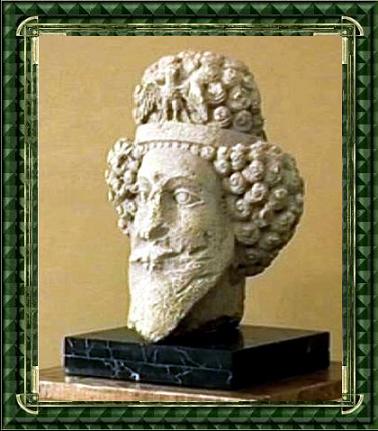
تعليق