نبدأ على بركة الله موضوعا جديدا بعنوان:
ملتقى الحضارات..ملتقى الانسانيّة
تمهيد:
إذا سألت عن أقدم آثار عُثر عليها تدل على وجود إنسان عاقل متكلم لديه نوع من الثقافة والقدرة على إجادة استخدام الأدوات والصيد والرسم على الجدران .. فهذه يعود تاريخها إلى قرابة 50 ألف .. ولا يعني هذا بالضرورة عدم وجود آثار أقدم .. لكن لم يتم العثور عليها حتى الآن .
تعود أقدم مستحثة لإنسان يشبه الإنسان المعاصر إلى قرابة 200 ألف سنة (عثر عليها في إثيوبيا) .. وهذا أيضاً لا يعني أن الإنسان المعاصر ظهر في تلك الفترة بالتحديد ..
الآثار التي تمّ العثور عليها ويتصل تاريخها بما قبل 50 ألف عام تدل على وجود بطء شديد جداً في تطور الأدوات الحجرية المستخدمة وعدم وجود مظاهر حضارية أخرى ولكن فجأة في حدود الـ 50 ألف سنة تحدث طفرة هائلة حول العالم في كمية الآثار المتطورة التي تدل على حدوث تغير جذري بين تاركي تلك الآثار .. وتحديداً خارج إفريقيا السوداء .. في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا ..
نجد أن البشر في هذه الفترة أصبحوا يدفنون موتاهم في قبور ويستخدمون جلود الحيوانات لصنع الملابس ويقومون بالصيد بطرق أكثر تطوراً (كاستخدام الفخاخ أو استدراج الحيوانات للمنحدرات) .. وكذلك انتشار الرسوم على جدران الكهوف وتنظيم أماكن المعيشة والطقوس الدينية (كوضع أغراض داخل القبور) .
وجود هولاء الناس لا شك فيه اطلاقاً .. (وقد لاحظ آثارهم حتى القدماء لذا نجد العرب قالوا بوجود أمة "البِنّ" و"الحِنّ" سفكت الدماء قبل آدم بآلاف السنين كما ذكر ابن كثير في تاريخه - مجرد كلام مؤرخين - وأن الله سلّط عليهم الجن فقتلوهم وأبادوهم! .. والفرس سموهم الطمّ والرمّ! .. واليونان سموهم التيتان !!) .... ولكن هل لهولاء علاقة بآدم ؟؟ .. الله أعلم .. وإن كان لهم علاقة .. فأيهم؟! .. هل هم الذين ظهروا قبل 200 ألف سنة .. أم الذين ظهروا قبل 50 ألف سنة ..
لا توجد لدينا روايات صحيحة ولا علم يمكننا الوثوق بنتائجه.
مقدّمة:
عرفت بلدان شمال افريقيا حضارة مزدهرة ظهرت منذ ما يقارب 10000 سنة مضت. تمّ هذا الاكتشاف بجهة قفصة من البلاد التونسيّة ممّا جعل المستكشفين يطلقون عليها الحضارة «القبصيّة» .
أظهرت الدراسات أن السكان الذين عاشوا في تلك الفترة بالجنوب التونسي قد تميّزت حياتهم بالرفاهيّة لتمكّنهم من استغلال الأراضي واستطاعتهم تربية المواشي وهو ما يجعلهم الأوائل في ترويض الحيوانات من غزلان وماعز وخرفان وأول الشعوب في التاريخ التي قامت برعي الأغنام، كما ظهرت أنواع جديدة من أسلحة الصيد وهي رؤوس السهام. كما تم اكتشاف أوان من الفخار تحمل الزخارف وكذلك أحجار مصقولة وملساء تستعمل لطحن الحبوب مما يدل على تعاطي الزراعة..
هناك ما يدل على تحضر القبصيين فقد كانوا يتزينّون بقلادات من خرزات مصنوعة من قشور بيض النعام..
من جانب آخر، فإن سكان تلك الفترة كانوا على اتصال بالشعوب الأخرى. فقد تمّ اكتشاف قطع صغيرة من الصخور البركانية مستوردة من ايطاليا وهذا يثبت اتصال المجموعات البشرية المنتمية للعصر الحجري الحديث، وهذا ما يثبت تطويع البحر وامتلاكهم لمعدات تعاطي الملاحة في حوض البحر الأبيض المتوسط..
الحضارة القبصيّة:
الحضارة القبصية (نسبة إلى مدينة قفصة بتونس، ذلك أن أول الحفريات حول هذه الحضارة وأكبرها قامت قرب هذه المدينة) في الفترة الممتدة بين 10.000 و 6.000 سنة قبل عصرنا الحاضر، أي في آخر العصر الحجري القديم وفي العصر الحجري الوسيط وفي العصر الحجري الحديث، وذلك في المناطق الداخلية من المغرب العربي الحالي، خاصة في تونس وفي الجزائر، وفي بعض المناطق ببرقة في ليبيا.
تقسيم الحضارة القبصية
تقسّم الحضارة القبصية تقليديا إلى قسمين، هما الحضارة القبصية المثالية والحضارة القبصية العليا. أظهرت الدراسات الأولى (1910 - 1974) أن الحضارة الأولى سبقت الثانية (إذ أن الطبقات الجيولوجية لأحافير الحضارة الأولى نوجد تحت طبقات أحافير الحضارة الثانية، ومن هنا كانت التسمية). ومنذ سنة 1974، أثبتت الدراسات الحديثة أن الحضارتين لا تتلاحقان وإنما تتزامنان. هناك تسميتان أخريان، هما الحضارة القبصية الشرقية و الحضارة القبصية الغربية. ويتمثل الفرق بين الحضارتين في تمركزها ونوع صناعاتها.
الحضارة القبصية المثالية أو الشرقية
تمركزت الحضارة القبصية المثالية أو الشرقية في وسط تونس (حول قفصة) وفي شرق الجزائر (حول تبسة)، وتميزت بصناعة أدوات حجرية كبيرة، مصنوعة من صفيحات صوّانية ذات قفا منحوت بحدة، منها الشفرات والمكاشط (المساحج) وخاصة الأزاميل (28,7 - 48,7% من جميع الأدوات المكتشفة). لم يكن الشكل الهندسي لهذه الأدوات مهمّا لديهم، ولكنّه يميل إلى الشكل المثلث. أما صناعة الأدوات العظمية فهي نادرة لديهم وغير متطورة، وهي متمثلة في مثاقب ضيقة مستدقة الطرفين.
الحضارة القبصية العليا أو الغربية
تمركزت الحضارة القبصية العليا أو الغربية في وسط الجزائر (حول سطيف) وجنوبها، وتميزت بصناعة أدوات حجرية صغيرة ومتنوعة ذات شكل مثلث أوشبه منحرف، أحيانا مثلّمة أومسنّنة، منها الشفرات والمثاقب والنصال و نادرا الأزاميل. بدأ القبصيون بتصغير حجم الأدوات الحجرية منذ حوالي 8.000 سنة قبل الحاضر. أما صناعة الأدوات العظمية فقد كانت متطورة وشائعة لديهم.
القبصيون من ناحية علم الإنسان:
كان القبصيون من جنس الإنسان العاقل الحديث، من النوع المتوسطي الأولي (وهو النوع الرئيسي) والنوع المشتي الأفلي والنوع المشتاني.
حياة القبصيين
في تلك الحقبة الزمنية، كان المناخ المغاربي شبيها بالمناخ الحالي لأفريقيا الشرقية، حيث كانت السهول مكسوّة بالأعشاب (مروج عشبية) والمرتفعات مكسوة بالأشجار (غابات).
السكن لدى القبصيين
سكن القبصيون أكواخا صنعوها من أغصان الشجر، كما سكن الرعاة المغارات في الجبال أثناء فصل الصيف.
نجد، في الأماكن التي سكن فيها القبصيون، كديات (مرتفعات) تبلغ مساحتها بضعة أمتار مربعة وتصل أحيانا إلى مئات الأمتار المربعة، ويبلغ ارتفاعها بين أقل من متر إلى ثلاثة أمتار أو أكثر. وتحوي هذه الكديات قواقع للحلزون كاملة و مهشمة، وكمية كبيرة من الرماد والأحجار المحترقة، وأحيانا مقابر. تسمى هذه الكديات بالرَمَادِيات أو الكُدْيَات السُود.
ترحال القبصيين
سكن القبصيون المناطق الداخلية من المغرب العربي الحالي، في المروج العشبية وعلى ضفاف البحيرات والصحراء (التي كانت مكسوة بالعشب). غير أنهم كانوا رُحّلاً، إذ كانوا يتنقلون بين الصحراء في الشتاء والمرتفعات في الصيف، مرورا بالأودية في الربيع والخريف.
القوت الغذائي للقبصيين
عاش القبصيون على أنواع عديدة من الحيوانات، إذ تراوح قوتهم الغذائي الحيواني من الثيران والغزلان إلى الأرانب البرية والحلازين، كما تمثل قوتهم النباتي في الثمار والحبوب والفواكه الجافة والعساقل.
قام القبصيون، في العصر الحجري الحديث، منذ 6.500 سنة قبل الحاضر، بتدجين الخرفان والماعز والثياثل والرعي بها، فضلا عن مواصلتهم لصيد الحيوانات الأخرى، إذ يعدّ القبصيون أول الرعاة في تاريخ الإنسانية. أظهرت بعض الأبحاث أن بعض المجتمعات القبصية قامت بنوع من الزراعة البدائية.
1- عسقل جمع: عَسَاقِلُ. | جُزْءٌ مِنْ سَاقٍ نَبَاتِيَّةٍ أَوْ مِنْ جِذْرٍ نَبَاتِيٍّ يَحْتَوِي عَلَى مَوَادَّ غِذَائِيَّةٍ.
المعتقدات الدينية لدى القبصيين
لا تتوفر أدلة كبيرة عن المعتقدات والأديان القبصية، غير أن الحفريات أظهرت أن طرق دفنهم لموتاهم توحي بأنه كانت لديهم معتقدات بحياة أخرى بعد الموت، إذ كانوا يدفنون موتاهم في أوضاع مختلفة (منها الوضع الجانبي المثني)، مزينة أبدانهم بحجر المُغْرَة، مرفقين بأدواتهم وأوانيهم.
الفنون لدى القبصيين
كان فن التزيين والزينة متطورا لديهم، إذ كان القبصيون يركّبون قلادات من خرزات مصنوعة من قشور بيض النعام، كما قاموا بنقوشات صخرية، بعضها لها وظيفة تحديد النفوذ المكاني للرعاة وبعضها تعليمي.
قام القبصيون، منذ 7.000 سنة قبل الحاضر، بصناعة أواني فخارية بسيطة، ثم قاموا بتطويرها في العصر الحجري الحديث، منذ 6.200 سنة قبل الحاضر، فأصبحت متنوّعة وجميلة كما قاموا أيضا باستعمال قشور بيض النعام في صناعة الأواني واستعملوها كقوارير بيضية الشكل وكؤوس وأكواب وصحون.
ملتقى الحضارات..ملتقى الانسانيّة
تمهيد:
إذا سألت عن أقدم آثار عُثر عليها تدل على وجود إنسان عاقل متكلم لديه نوع من الثقافة والقدرة على إجادة استخدام الأدوات والصيد والرسم على الجدران .. فهذه يعود تاريخها إلى قرابة 50 ألف .. ولا يعني هذا بالضرورة عدم وجود آثار أقدم .. لكن لم يتم العثور عليها حتى الآن .
تعود أقدم مستحثة لإنسان يشبه الإنسان المعاصر إلى قرابة 200 ألف سنة (عثر عليها في إثيوبيا) .. وهذا أيضاً لا يعني أن الإنسان المعاصر ظهر في تلك الفترة بالتحديد ..
الآثار التي تمّ العثور عليها ويتصل تاريخها بما قبل 50 ألف عام تدل على وجود بطء شديد جداً في تطور الأدوات الحجرية المستخدمة وعدم وجود مظاهر حضارية أخرى ولكن فجأة في حدود الـ 50 ألف سنة تحدث طفرة هائلة حول العالم في كمية الآثار المتطورة التي تدل على حدوث تغير جذري بين تاركي تلك الآثار .. وتحديداً خارج إفريقيا السوداء .. في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا ..
نجد أن البشر في هذه الفترة أصبحوا يدفنون موتاهم في قبور ويستخدمون جلود الحيوانات لصنع الملابس ويقومون بالصيد بطرق أكثر تطوراً (كاستخدام الفخاخ أو استدراج الحيوانات للمنحدرات) .. وكذلك انتشار الرسوم على جدران الكهوف وتنظيم أماكن المعيشة والطقوس الدينية (كوضع أغراض داخل القبور) .
وجود هولاء الناس لا شك فيه اطلاقاً .. (وقد لاحظ آثارهم حتى القدماء لذا نجد العرب قالوا بوجود أمة "البِنّ" و"الحِنّ" سفكت الدماء قبل آدم بآلاف السنين كما ذكر ابن كثير في تاريخه - مجرد كلام مؤرخين - وأن الله سلّط عليهم الجن فقتلوهم وأبادوهم! .. والفرس سموهم الطمّ والرمّ! .. واليونان سموهم التيتان !!) .... ولكن هل لهولاء علاقة بآدم ؟؟ .. الله أعلم .. وإن كان لهم علاقة .. فأيهم؟! .. هل هم الذين ظهروا قبل 200 ألف سنة .. أم الذين ظهروا قبل 50 ألف سنة ..
لا توجد لدينا روايات صحيحة ولا علم يمكننا الوثوق بنتائجه.
الحضارة القبصية
مقدّمة:
عرفت بلدان شمال افريقيا حضارة مزدهرة ظهرت منذ ما يقارب 10000 سنة مضت. تمّ هذا الاكتشاف بجهة قفصة من البلاد التونسيّة ممّا جعل المستكشفين يطلقون عليها الحضارة «القبصيّة» .
أظهرت الدراسات أن السكان الذين عاشوا في تلك الفترة بالجنوب التونسي قد تميّزت حياتهم بالرفاهيّة لتمكّنهم من استغلال الأراضي واستطاعتهم تربية المواشي وهو ما يجعلهم الأوائل في ترويض الحيوانات من غزلان وماعز وخرفان وأول الشعوب في التاريخ التي قامت برعي الأغنام، كما ظهرت أنواع جديدة من أسلحة الصيد وهي رؤوس السهام. كما تم اكتشاف أوان من الفخار تحمل الزخارف وكذلك أحجار مصقولة وملساء تستعمل لطحن الحبوب مما يدل على تعاطي الزراعة..
هناك ما يدل على تحضر القبصيين فقد كانوا يتزينّون بقلادات من خرزات مصنوعة من قشور بيض النعام..
من جانب آخر، فإن سكان تلك الفترة كانوا على اتصال بالشعوب الأخرى. فقد تمّ اكتشاف قطع صغيرة من الصخور البركانية مستوردة من ايطاليا وهذا يثبت اتصال المجموعات البشرية المنتمية للعصر الحجري الحديث، وهذا ما يثبت تطويع البحر وامتلاكهم لمعدات تعاطي الملاحة في حوض البحر الأبيض المتوسط..
الحضارة القبصيّة:
الحضارة القبصية (نسبة إلى مدينة قفصة بتونس، ذلك أن أول الحفريات حول هذه الحضارة وأكبرها قامت قرب هذه المدينة) في الفترة الممتدة بين 10.000 و 6.000 سنة قبل عصرنا الحاضر، أي في آخر العصر الحجري القديم وفي العصر الحجري الوسيط وفي العصر الحجري الحديث، وذلك في المناطق الداخلية من المغرب العربي الحالي، خاصة في تونس وفي الجزائر، وفي بعض المناطق ببرقة في ليبيا.
تقسيم الحضارة القبصية
تقسّم الحضارة القبصية تقليديا إلى قسمين، هما الحضارة القبصية المثالية والحضارة القبصية العليا. أظهرت الدراسات الأولى (1910 - 1974) أن الحضارة الأولى سبقت الثانية (إذ أن الطبقات الجيولوجية لأحافير الحضارة الأولى نوجد تحت طبقات أحافير الحضارة الثانية، ومن هنا كانت التسمية). ومنذ سنة 1974، أثبتت الدراسات الحديثة أن الحضارتين لا تتلاحقان وإنما تتزامنان. هناك تسميتان أخريان، هما الحضارة القبصية الشرقية و الحضارة القبصية الغربية. ويتمثل الفرق بين الحضارتين في تمركزها ونوع صناعاتها.
الحضارة القبصية المثالية أو الشرقية
تمركزت الحضارة القبصية المثالية أو الشرقية في وسط تونس (حول قفصة) وفي شرق الجزائر (حول تبسة)، وتميزت بصناعة أدوات حجرية كبيرة، مصنوعة من صفيحات صوّانية ذات قفا منحوت بحدة، منها الشفرات والمكاشط (المساحج) وخاصة الأزاميل (28,7 - 48,7% من جميع الأدوات المكتشفة). لم يكن الشكل الهندسي لهذه الأدوات مهمّا لديهم، ولكنّه يميل إلى الشكل المثلث. أما صناعة الأدوات العظمية فهي نادرة لديهم وغير متطورة، وهي متمثلة في مثاقب ضيقة مستدقة الطرفين.
الحضارة القبصية العليا أو الغربية
تمركزت الحضارة القبصية العليا أو الغربية في وسط الجزائر (حول سطيف) وجنوبها، وتميزت بصناعة أدوات حجرية صغيرة ومتنوعة ذات شكل مثلث أوشبه منحرف، أحيانا مثلّمة أومسنّنة، منها الشفرات والمثاقب والنصال و نادرا الأزاميل. بدأ القبصيون بتصغير حجم الأدوات الحجرية منذ حوالي 8.000 سنة قبل الحاضر. أما صناعة الأدوات العظمية فقد كانت متطورة وشائعة لديهم.
القبصيون من ناحية علم الإنسان:
كان القبصيون من جنس الإنسان العاقل الحديث، من النوع المتوسطي الأولي (وهو النوع الرئيسي) والنوع المشتي الأفلي والنوع المشتاني.
حياة القبصيين
في تلك الحقبة الزمنية، كان المناخ المغاربي شبيها بالمناخ الحالي لأفريقيا الشرقية، حيث كانت السهول مكسوّة بالأعشاب (مروج عشبية) والمرتفعات مكسوة بالأشجار (غابات).
السكن لدى القبصيين
سكن القبصيون أكواخا صنعوها من أغصان الشجر، كما سكن الرعاة المغارات في الجبال أثناء فصل الصيف.
نجد، في الأماكن التي سكن فيها القبصيون، كديات (مرتفعات) تبلغ مساحتها بضعة أمتار مربعة وتصل أحيانا إلى مئات الأمتار المربعة، ويبلغ ارتفاعها بين أقل من متر إلى ثلاثة أمتار أو أكثر. وتحوي هذه الكديات قواقع للحلزون كاملة و مهشمة، وكمية كبيرة من الرماد والأحجار المحترقة، وأحيانا مقابر. تسمى هذه الكديات بالرَمَادِيات أو الكُدْيَات السُود.
ترحال القبصيين
سكن القبصيون المناطق الداخلية من المغرب العربي الحالي، في المروج العشبية وعلى ضفاف البحيرات والصحراء (التي كانت مكسوة بالعشب). غير أنهم كانوا رُحّلاً، إذ كانوا يتنقلون بين الصحراء في الشتاء والمرتفعات في الصيف، مرورا بالأودية في الربيع والخريف.
القوت الغذائي للقبصيين
عاش القبصيون على أنواع عديدة من الحيوانات، إذ تراوح قوتهم الغذائي الحيواني من الثيران والغزلان إلى الأرانب البرية والحلازين، كما تمثل قوتهم النباتي في الثمار والحبوب والفواكه الجافة والعساقل.
قام القبصيون، في العصر الحجري الحديث، منذ 6.500 سنة قبل الحاضر، بتدجين الخرفان والماعز والثياثل والرعي بها، فضلا عن مواصلتهم لصيد الحيوانات الأخرى، إذ يعدّ القبصيون أول الرعاة في تاريخ الإنسانية. أظهرت بعض الأبحاث أن بعض المجتمعات القبصية قامت بنوع من الزراعة البدائية.
1- عسقل جمع: عَسَاقِلُ. | جُزْءٌ مِنْ سَاقٍ نَبَاتِيَّةٍ أَوْ مِنْ جِذْرٍ نَبَاتِيٍّ يَحْتَوِي عَلَى مَوَادَّ غِذَائِيَّةٍ.
المعتقدات الدينية لدى القبصيين
لا تتوفر أدلة كبيرة عن المعتقدات والأديان القبصية، غير أن الحفريات أظهرت أن طرق دفنهم لموتاهم توحي بأنه كانت لديهم معتقدات بحياة أخرى بعد الموت، إذ كانوا يدفنون موتاهم في أوضاع مختلفة (منها الوضع الجانبي المثني)، مزينة أبدانهم بحجر المُغْرَة، مرفقين بأدواتهم وأوانيهم.
الفنون لدى القبصيين
كان فن التزيين والزينة متطورا لديهم، إذ كان القبصيون يركّبون قلادات من خرزات مصنوعة من قشور بيض النعام، كما قاموا بنقوشات صخرية، بعضها لها وظيفة تحديد النفوذ المكاني للرعاة وبعضها تعليمي.
قام القبصيون، منذ 7.000 سنة قبل الحاضر، بصناعة أواني فخارية بسيطة، ثم قاموا بتطويرها في العصر الحجري الحديث، منذ 6.200 سنة قبل الحاضر، فأصبحت متنوّعة وجميلة كما قاموا أيضا باستعمال قشور بيض النعام في صناعة الأواني واستعملوها كقوارير بيضية الشكل وكؤوس وأكواب وصحون.
























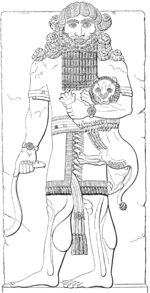










تعليق