"عليسة وتأسيس قرطاج" بقلم محمد حسين فنطر المختص في التاريخ القديم والآثار الفينقية البونية وتاريخ الأديان
تتظافر الوثائق التاريخية والأثرية لتثبت أن تأسيس قرطاج يعود الى نهاية القرن التاسع قبل ميلاد المسيح ولا شيء يحول دون قبول الرواية القائلة بأنّها أسّست قبل الألعاب الأولمبية الأولى بثمان وثلاثين سنة مع العلم أنّ الألعاب الأولمبية الأولى نظمت سنة ستّ وسبعين وسبعمائة ق.م.
وبتأسيس قرطاج تخلّى الفينيقيون عن سياسة المصارف الوقتية وتوخوا سياسة جديدة تقوم على المستوطنات القارّة والحضور الدائم ودون ما دخول في التفاصيل حول الأسباب والأهداف التي أدت إلى تأسيس قرطاج، فثابت أنّ ما صنّف حول الأميرة عليسة يمتّ الى الخيال بخيوط وله نصيب من الواقع المعيش إذ هي قصة خيالية من وحي الواقع شأنها في ذلك شأن الأساطير جميعها على أنّ الذين أوردوها وتناقلوها لم يتردّدوا في إثرائها بعناصر اقتبسوها من محيطهم ومما تميّزت به عصورهم والأجيال المتعاقبلة. كذلك فعل ورجليوس Virgile وأثراها يوستنوس Justin والسابقون واللاحقون. أمّا الأسطورة فهذه خلاصتها.
عليسة بنت متّن ملك صور أميرة فينيقية أوصي لها بالعرش ولأخيها بجمليون ولكن، بعد وفاة الملك، تنكّر الشعب لتلك الوصيّة وقضى أن يستأثر بجمليون بالعرش وقد تمّ ذلك فعلا. فلم يكن للأميرة إلاّ قبول الأمر الواقع هذا وزفّوها لخالها زكربعل وكان رئيس كهنة معبد ملقرت إله صور وحامي حماها.
ولمّا كان لزوج عليسة ثروة طائلة مغرية تسيل اللّعاب وكان من ذوي الحضور الملحوظ عند أهل الحلّ والعقد في صور، فلا غرو أن يثير الحسد والريبة لدى ملك حسود جشع حقود ممّا جعله لم يتردد في اغتيال خاله وزوج أخته مخترقا حدود الدّين وصلة الرّحم للسطو على ثروته، فلمّا ترملت عليسة ولم يكن لها سند لجأت إلى حيلة حمتها من جشع أخيها الملك وإجرامه فباتت تغالطه مقنعة إيّاه أنّها تبغي العيش في القصر الملكي، بعيدا عن أطياف الموت التي ما انفكّت تحوم في بيت زوجها وتقوّض مضجعها وحاكت خطة هروبها بمساعدة ثلة من بعول المدينة وكبار التجار الذين كانوا يخافون جبروت الملك وأمرت عليسة بترتيب كل شيء تحت طيّ الخفاء.
ولمّا حان الوقت، أقلع الأسطول واندّس في عرض البحر حتّى أصبح بعيدا لا تطوله يد الملك وتمكنت عليسة من السيطرة على عيونه وخدمته، فما أن أبحر الأسطول حتى بادرت الأميرة المهاجرة بإلقاء أكياس في البحر قالت إنّها تحتوي على كنوز زوجها الشهيد، وقد رمتها في اليمّ قربانا لروحه الطّاهرة حتّى تطمئن وتشملها السكينة وفي ذلك رسالة الى من قد يريد التمرّد للاستيلاء على الكنوز المندسّة في بطون السفن، فما بقي للجميع إلاّ مواصلة الرحلة نحو شاطئ السلامة.
وقبل أن يوجه الأسطول الجؤجؤ نحو غربي المتوسط، ألقى مراسيه في جزيرة قبرص وفيها عقدت الأميرة معاهدة مع رئيس الكهنوت في معبد آلهة الجمال عشترت، وهي آلهة الخصب والحب للأحياء وحماية الموتى في قبورهم وفي عبورهم الى مدينة الأرواح وتحيط بعنايتها من في البحر ومن في الحرب وساحة الوغى.
فبمقتضى اتفاق تمّ الوصول اليه بعد مفاوضات جادّة، انضم رئيس كهنوت عشترت وبيته الى رفاق الأميرة كما انضافت اليهم فتيات تمّ اختطافهن على شاطئ الجزيرة حيث كنّ يؤدين شعيرة البغاء المقدّس كما تقتضيه طقوس الآلهة عشترت، وهي شعيرة تحدّث مؤرخون كثيرون عنها، وهي من الشعائر المعروفة لدى عديد الشعوب.

استقبل القبارصة عليسة بحفاوة وسخرّوا لها ولرفقائها وسائل الرّاحة والاستجمام، ولمّا حان الرحيل أبى الكاهن الا أن يشاطر الأميرة عناء السفر فانضمّ الى ركبها صحبة زوجته وأبنائه بعد أن تأكد من بقاء الكهانة في قدس عشترت له ولبنيه. هذا وقد أخذت عليسة ثلّة من الفتيات اللاتي كن يهبن بتولتهن إلى الآلهة وينوس Vénus وهي آلهة الحب والخصب عند الرومان، وقد أطاق يوستينوس هذا الثيونيم Théonyme الروماني على الآلهة الفينيقية عشترت، على أنّه يسميها تارة يونو Junon وطورا وينوس Vénus وهما في الواقع آلهتان مختلفتان، ومعنى ذلك أنّ لعشترت خصائص تقرّبها من يونو وخصائص أخرى تقربها من وينوس حتى أنّها تجمع بين وظائف هذه وتلك.
أمّا فيما يتعّلق بالفتيات اللاتي يهبن بتولتهنّ الى عشترت، فتلك معتقدات معروفة في الشرق القديم من ضفاف دجلة الى سواحل البحر المتوسط، فقد كانت معروفة لدى الايلوميين Elymes وهم قوم يعيشون في غربيّ صقلية ولهم قدس للإلهة وينوس تمارس فيه شعيرة البغاء المقدس، ومضمونها أنّ تقيم الفتيات العذارى في المعبد أو علي شاطئ البحر ويزاوجن من يتقدم إليهن فتلك هي الشعيرة التي يسميها المؤرخون البغاء المقدّس la prostitution sacrée، وقد وصلتنا عنها أصداء كثيرة في كتب القدماء ويبدو أ هذه الشعيرة كانت تمارس في سقّة Sicca، وهي التي أصبحت تسمّى بعد الغزو الروماني Sicca Veneria إشارة إلى علاقتها بوينوس وهي التي سمّا الادريسي "شق بنارية"، وخلفتها مدينة الكاف في الشمال الغربي التونسي.
وأوضح ما لدينا حول هذا الموضوع، نص ورد في الفصل التاسع والتسعين بعد المائة من السفر الأول من تاريخ هيرودوتس وهو كالتالي: «إن أكبر المخزيات في بابل شعيرة تقليدية مضمونها أن تقيم كل امرأة في معبد افروديت مرّة في حياتها وتجامع غريبا أيّا كان. كثيرات هنّ اللاتي يفخرن بالثراء ويعتبرن من غير اللائق بهنّ الاحتكاك بالنساء الأخريات، فتراهن يتوجهن إلى المقدس على متن عربات مغطاة ويمكثن هناك ومعهنّ حشد من الوصيفات والخدم، وأغلبهنّ يتوخّين السلوك التالي: يجلسن في حرم أفروديت المقدّس وعلى رؤوسهنّ تيجان من حبال وهنّ جماعات مقبلات وجماعات مغادرات وبين امرأة وأخرى ممرّات تحدّها حبال من كلّ الجهات، ويشقّ الغرباء تلك الممرّات ويختار كلّ واحد منهم المرأة التي يريد مزاوجتها، مع العلم أنّ المرأة التي تأتي هذا المكان لا تعود إلى بيتها قبل أن يلقي أحد الغرباء نقودا على ركبتيها، وتزاوجه داخل الفضاء المقدس. وعند القاء النقوط لابدّ له من قراءة الكلمات التالية: أمرك باسم الإلهة موليتّا Mylitta، وموليتّا هو اسم أفروديت عند الأشورييين، ومهما تضاءلت قيمة تلك النقود فلا خوف من أن ترفضها المرأة، فلا يحقّ لها ذلك لأنّها نقود مقدّسة، وعلى المرأة أن تخطو خطى أول من يلقي إليها شيئا دون أن تنفر من أحد.
وبعد المزاوجة، تكون قد قامت بواجباتها الدينية فتعود الى بيتها ولن يستطيع كسبها بعد ذلك أحد مهما قدّم إليها. فالنّساء اللاتي لهنّ طلعة صبيحة وهيئة مغرية سرعان ما يعدن الى بيوتهنّ. أمّا القبيحات فقد تطول إقامتهن في المعبد قبل أن تتمكّن من القيام بما يقتضيه الواجب، فمن النساء من تبقين ثلاث أو أربع سنوات داخل الحرم.
لقد أشارت آيات العهد القديم الى شعيرة البغاء المقدس، وقد تفشّى بين قبائل بني إسرائيل تحت تأثير المعتقدات الكنعانية، مع العلم أنّ بني إسرائيل في غالبهم كنعانيون اتبعوا رسالة موسى واعتنقوا ديانته. ومهما يكن من أمر، فآيات التوراة تثبت هي الأخرى وجود البغاء المقدس في يورشليم، فلا يجوز للمؤرخ التشهير ولا التنويه بالشعائر الدينية أيّا كانت اذ لا يحقّ النظر إلى الحضارات القديمة الا من خلال منظارها الخاص ودون حكم لها أو عليها وليس ذلك باليسير.
وبعد هذا الاستطراد، نعود الى عليسة وسفرها الطويل المرهق المحفوف بالأخطار، فقد أرسى الأسطول في ثغر من ثغور شبه الجزيرة التي ستحتضن المستوطنة الجديدة، وحلّت عليسة ورفاقها بأرض معطاء مستفيدين من كرم يربص، ملك المكسويين الذين كانوا اذاك يعمّرون الربوع الممتدة بين جبل بعل ذي القرنين وخليج تونس.
ولعل ربوع المكسويّين كانت تغطي ضواحي قرطاج، حلق الواد والكرم. وبعد الترحاب ومراسم تبادل الهدايا كان لابد لعليسة ورفاقها من فضاء يجدون فيه نصيبا من الرّاحة. ولمّا كان الأهليون يخشون مكوث دخلاء غرباء في ربوعهم، لجأت الأميرة الى حيلة جلد الثور وتتمثل في طلب تناء قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها ما يغطيه جلد الثور، مع العلم أن جلد الثور يسمّى باللغة الإغريقية بيرصا Byrsa، وفي اللغة الفينيقية كلمة برصة تعني الأطم أو القلعة، فإستبهلوها واستجابوا لطلبها علّهم كانوا يريدون معرفة ما عساها أن تفعل بأرض تساوي مساحتها ما يغطّيه جلد ثور.
وما أن تمّ الاتفاق حتى بادرت عليسة بتقطيع جلد الثّور سيرا رقيقا طويلا مكّنها من تسييج مساحة كافية لإقامة مستوطنة فسيحة الأرجاء، ولعلّها بجلد الثور طوّقت الربوة التي ستتخذها أطما يشرف على المستوطنة ويكون لسكّانها ملجأ عند الاقتضاء.
وممّا تداوله بعض المصنّفين القدامى طرفة حول أسّ المستوطنة مضمونها أنّ المعول أخرج رأس ثور فلم تطمئّن عليسة ورفاقها لما منّت به الأرض بل تشاءموا لأنّ الثور ينبئ بالمشقة والعبوديّة، فهو نير ومحراث، فتركوا ذلك المكان واتجهوا إلى موقع ثان يحفرونه لتهيئة الأسّ، فأبرز معول الحفار رأس حصان، وهو رمز القوّة والطوق الى الحرب، فأقيمت قرطاج في ذلك المكان الميمون وسرعان ما ازدهرت مستوطنة عليسة ونمت أخبارها إلى القبائل، فباتت تتردّد عليه الوفود وأرسلت إليها وتيكة سفارة لتقديم الهدايا ولتهنئة المستوطنين وتشجيعهم على البقاء والاستثمار.
كان أمراء القبائل يلتقطون الأخبار عن عليسة ومدينتها وكلهم معجبون بجمالها وحذقها، وكان من بينهم يربص Hiarbas وهو ملك قبيلة المكسويين، فما أن بانت الأميرة حتى افتتن بجمالها المشرقي المشرق وأصبح مسكونا بعشقها لا يفكّر إلاّ فيها وفي الزّواج بها، فأرسل الى قرطاج يطلب عشرة من أعيان سكانها، ولمّا مثّلوا بين يديه أعرب لهم عما يخالجه متحدثا عن حبه لعليسة وعن عزمه على الزواج بها، فأدهشهم وما كانوا يتوقعون ذلك ولكن كيف العمل؟
فإن أجيب الملك بالرفض كانت العاقبة وخيمة، إذ تصبح الحرب حتمية، وقد تذهب المستوطنة الفتية أدراج الرياح، فرجعوا الى ديارهم معتقدين ألاّ سبيل للتخلص من مأزق كهذا إلاّ بواسطة الحيلة. فلما مثلوا بين يدي عليسة لم يخبروها بما جرى، بل قالوا إنّ ملك المكسويين يطلب من أهل قرطاج أن يرسلوا إليها بعض الذين يعلّمونه وشعبه مبادئ الحضارة وأضافوا أنّ ليس من اليسير على المواطن القرطاجي أن يعيش حياة شظف بين أفراد قبيلة خشنة متهورة. فقرّعتهم الملكة وأنكرت عليهم التعالي وحبّ الذّات، فأردوفوا أذاك معربين عما يريده منها يربص، فأجابت وقد وقعت في الفخ أنّها مستعدة للذهاب حيث يناديها مصير قرطاج، وطلبت أن يمهلوها ثلاثة أشهر للنظر في شؤونها وشؤون مدينتها.
وقد أحسنت المناورة مع البقاء مخلصة لروح زوجها دون أن تستفزّ الملك الذي بات يحاصرها فضلا عن ضغوط رفاقها الذين كانوا يؤيّدون زواجا يرون فيه حماية لمستوطنتهم وازدهارها، ثمّ بعد مماطلة جمعت بين الوعود المغرية والذرائع الماكرة، هيأت الأميرة محرقة مُدعيّة أنها تبغي تقديم قربان حذو مقرّ سكناها، ولمّا تجمع الناس يترقبونها خرجت من بيتها وانبرت على منصّة تشرف على الأطيمة، وقالت إنّها ستلتحق بروح زوجها مخلصة لذكراه، ثمّ جرّدت سيفا وأغمدته في صدرها وارتمت في نار الأطيم المؤججة ضحية مقدّسة لذكرى فقيدها وحرصا على ديمومة مدينتها، وقد سمْتها بكلمتين فينيقيتين قرت حدشت، مع العلم أنّ قرت تعني مدينة وحدشت صفة تفيد الحداثة، فقرت حدشت تعني مدينة حديثة أو جديدة من حيث الزمن ومعنى ذلك أنّها أنشأت بعد جديرة Gadir في اسبانيا ولكشة Lixus في المغرب ووتيكة Utica، ومن حيث الوظيفة ومعنى ذلك أنّها مستوطنة قارة توفّر كل ما يحتاجه بناتها ومعمّروها زمنيّا واقتصاديّا وسياسيا واجتماعيا فهي مسؤولة عن تصريف جميع شؤونها.
تلك هي اسطورة قرطاج التي ساهمت في نحت ملامحها أجيال مختلفة الزمن والثقافة، ففيها عناصر تعود الى صور وأخرى جاد بها الخيال الإغريقي الروماني الذي عايشها طيلة قرون عديدةن ولعلّها تمتد من ميناندروس الأفسسي Ménandre d'Ephèse وهو من مصنّفي القرن السادس قبل ميلاد المسيح الى الأسقف الاغريقي أوستاثيوس Eustathe الذي عاش خلال القرن الثاني عشر.
وهكذا نتبيّن أنّ الذين تداولوا اسطورة عليسة في أفواههم وتناقلها حبر أقلامهم تقاسموا ثمانية عشر قرنا لقراءتها ونسخها والتعليق عليها مع ممارسة الحذف والاضافة عن وعي وعن غير وعي شأنها في ذلك شأن الأساطير والملاحم لدى كل الشعوب في مختلف العصور.
وأيّا كان الأمر، فأسطورة قرطاج لها أصول فينيقية صورية (نسبة لمدينة صور)، ومنها معبد ملقرت وكاهنه الأول ولعله كان يسمّى زكربعل وهو علم معروف لدى الفينيقيين في الشرق والمغرب لاسيما في قرطاج.
أمّا معبد ملقرت المشار إليه في الأسطورة، فلقد زاره المؤرخ الاغريقي هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد أثناء مروره بمدينة صور، ولكم شهادته كما وردت في الفصل الرابع والأربعين في السفر الثاني من تاريخه: «لقد شاهدت ذلك المعبد الممهور بأثمن الهدايا ومنها نصبان، أحدهما من ذهب خالص والآخر من زمرد يشعّ بريقا ساطعا في ظلمة الليل، وتجاذبت أطراف الحديث مع كهنة الاله، وسألت كما زمنا مرّ على إقامة مقدسهم، فتبينت أنّهم لا يتفقون هم أيضا مع الإغريق، وقد أجابوا أنّ هذا المقدس تزامن بناؤه مع تأسيس صور، وصور عامرة منذ ألفين وثلاثمائة سنة» فلا شكّ أنّ هذه المعطيات تلوّح إلى العمق الفينيقي الصوري في نسيج الأسطورة.
ولمّا تتوقّف سفن عليسة بجزيرة قبرص، توفّرت لحوك الأسطورة عناصر جديدة تثري نسيجها وكأنّها المشهد الثاني في المسرحيّة، فلقد حطّ الأسطول بشاطئ من شواطئ قبرص وتمّ الاتصال بجالية فينيقية الأصول، وقد كشف الغطاء عن بقايا معبد مخصوص لعبادة عشترت في مدينة كانت تسمى قتيون Kition، وهي التي تركت مكانها لمدينة لرنقة Larnaca فمعبد عشترت بمدينة قتيون ينشر شيئا من المصداقية على المرحلة القبرصية من أسطورة عليسة، مع العلم أنّ أقدم أساسات المعبد الفينيقي القبرصي ترقى إلى القرن التّاسع قبل ميلاد المسيح على أن الموقع كان آهلا بالقبارصة قبل نشأة المستوطنة الفينيقية، فالجالية التي خرجت من صور حلّت بقتيون وجدتها آهلة فانتصبت بجوارها وتعايشت مع سكانها دون اقصاء وسمّت قريتها قرت حدشت، ولعلّها سمّيت كذلك بالنسبة لقتيون القبرصية الأصول والتي كانت قبل أن تكون القرية الفينيقية المحدثة.
وفي قبرص تمّ اختطاف العذارى اللائي كنّ على الشاطئ تبغين إهداء بتولتهنّ الى الربّة عشترت، فهل إهداء البتولة في قبرص من تقاليد الفينيقيين أمّ هي شعيرة من ثوابت الجزيرة؟ فلا شك أنّ قبرص ساهمت في حوك أسطورة عليسة التي غادرت مياه قبرص ومعها جزء منها سيكون له تأثيره في سبك الحضارة البونية في غرب البحر المتوسّط، ثمّ إنّ المجموعة أصبحت بعد مرورها بقبرص متكاملة فيها ما يستوجبه بناء مستوطنة تستطيع البقاء ففيها القدس والحلّ وفيها الأنوثة والرّجولة، فمشروع مدينة متكامل أتى به المهاجرون وكأنّ أسطولهم سفينة نوح تبحث عن شاطئ السلامة لتلقي مراسيها حتى يطمئن من عليها وينتشروا في الأرض.
ما انفك الأسطول يمخر البحر أياما عديدة بلياليها حتى شقّ أمواج خليج يشرف عليه جبل ذو قرنين، فاقترب من الشاطئ ونزل الجميع وجرّت السفن نحو اليابسة فسرعان ما انتشر خبر وجودهم، وكان الاتصال بالأهليين وأولي الأمر عندهم، ولا شكّ أنّ ظروف اللقاء وملابساته وفّرت للأسطورة خيوطا تساهم في حوكها ومنها عشق الملك يربص لعليسة ولعلّ رأس الثور ورأس الحصان المشار إليهما عند حفر الأساسات من رصيد هؤلاء المزارعين المغرمين بالخيل والفروسية.
أمّا حيلة جلد الثور، فثابت أنّها من خيال الإغريقي والتّورية الجناسيّة Calembour وذلك على أساس علاقة صوتية بين الكلمة الإغريقية بورصة Bursa وإحدى الكلمتين التاليتين: الأولى بيرصة وهي من معجم اللغة الآرميّة ومعناها القلعة والثانية برصة وقد أثبتها ابن منظور في لسان العرب حيث قال: البرصة بضمّ الباء هيّ البلّوقة بضمّ اللام وجمعها براص بباء مجرورة، وهي أمكنة من الرمل الأبيض ولا تنبت شيئا، فكلا الكلمتين تنسجم مع السياق، ذلك أن حلّت بشاطئ رماله ممتدة تشرف عليه ربوة كالحصن الحصين. هذا وقد فضّل غالب المؤرخين فرضية القلعة.
وممّا تجدر الإشارة اليه وجود كلمة بأرصة مسطورة على عملة قرطاجية وقد تكون هذه الكلمة البونيّة أساس التورية الجناسية المشار إليها، ومن الذين تناولوا تلك النقود بالدرس وتحليل كلمة بأرصة رأوا أنّها تتركب من حرف ب الذي يحدّد المكان فبكلمة بأرصة يعلن المكلّفين بضرب العملة أنّ النقود التي تحمل تلك العبارة ضربت بأرض الوطن أي بقرطاج نفسها مع العلم أنّ كلمة أرصة تعني الأرض بمعنى الوطن. أمّا إذا اعتبرنا بأرصة كلمة واحدة تتركب من أربعة حروف يجوز اعتبارها منطلق التورية الجناسية التي أوحت بحيلة جلد الثور.
وخلاصة القول إن أسطورة قرطاج استمدت سداها ولحمتها من مصادر ثلاثة وهي مدينة صور وجزيرة قبرص والسواحل الشرقية من لوبة لكنّها ما انفكت تتجدد أخذا وحذفا من جيل الى جيل ومن فيه إلى فيه ومن قلم إلى قلم حتى وصلت إلينا في زيّها الحالي.
فكأن كل من رواها اضاف إليها ما كان يريده لها وحذف منها ما يستوجبه سياق روايته أو ملحمته فضلا عمّا تفرضه قراءته للأحداث ورؤيته لتاريخ الفينيقيين وثقافتهم، فلم يتحرج الشاعر اللاتيني ورجليوس Virgile من حشر قصة حبّ بين الأمير الطروادي أنيوس Enée الذي خرج من طروادة هائما على وجهه على متن سفينة عبثت بها الرياح، كادت تلتهمها الأمواج العارمة، ولئن قلت لم يتحرج الشاعر اللاتيني فذلك إشارة إلى البون الشاسع بين زمن انيوس وزمن عليسة، فالأمير الطروادي عاش في نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد وقصّة الأميرة عليسة لم تكن قبل نهاية القرن التاسع قبل الميلاد، فبينهما فاصل زمني ينيف عن قرنين.
هذا وقد تغنى ورجليوس بمغامرة أنيوس الطروادي مع عليسة الفينيقية الصورية في بداية القرن الأول قبل الميلاد وكان ذلك بطلب من الإمبراطور أجوستوس Auguste الذي تبوّأ عرش الامبراطورية الرومانية من سنة 27 قبل الميلاد الى سنة 14 بعد الميلاد وهو الذي أحيا قرطاج بعد موتها عملا بوصية أبيه المتبنّي يوليوس قيصر Jules César.
أمّا الأسباب والأهداف التاريخية التي أنجبت قرطاج، فقد يستشفّها المؤرخ في الأوضاع التي سيطرت في الشرق والغرب: فشرقا كانت المدن الفينيقية اذ ذاك تعيش خطرا أشوريّا يهدّد كيانها وأموالها: وقد كان ملوك أشور يعبرون الفرات في طريقهم نحو السواحل الكنعانية يغنمون، وفي حولياتهم ما يفيد أنّ أول حملة قام بها الأشوريون نحو البحر وجبال الأرز تعود الى عهد تجلتفليسر الأول (1120 ـ 1074 قبل ميلاد المسيح) وتواصلت الحملات الأشورية ومنها غزوات اشورناصر بعلالثاني (888ـ859 ق. م) وفي حولياته ما يشير إلى ما كانت تعانيه المدن الفينيقية من جبروت ملوك أشور، وثبت أنهم كانوا يردون ضمّها والقضاء على كيانها السياسي واستغلال قدراتها الاقتصادية ووضع ايديهم على كنوزها. فليس من الغريب أن تتوقع المدن الفينيقية هذا التصعيد في سياسة الأشوريين إزاءهم ولا يستغرب أن تفكّر في حل يخلّصها من الملزمة. بات الغول الأشوري يتهيّأ للإجهاز على فريسته وتهشيم هياكلها.
أليس الحل في الهروب بعيدا حيث لا يستطيع الاشوريون ملاحقة الكنوز الفينيقية؟ تلك هي الظروف القاسية التي سيطرت على حياة صور وصيدا وجبيل وبيريت وارواد وغيرها من مدن السواحل الكنعانية، وقد أصابها الوهن من جراء ذلك ممّا أثر على حضور الفينيقيين في غربي البحر الأبيض المتوسط حيث كانوا أسيادا ينفردون بالكسب والسلطان وقد تزامن الخطر الأشوري مع استفاقة المدن اليونانية والإغريقية من سباتها، وقد استفادت من تجارب الفينيقيين الذين كانوا يترددون عليهم وفي بطون سفنهم بضاعة الشرق وحضارتها الأصلية وكم اينعت فسائل الشرق في ارض الإغريق.
قد يطول الكلام عمّا يدين به الإغريق الى الفينيقيين وليس المجال هنا لتناول مثل هذه القضايا الخطيرة بل نكتفي بالإشارة إلى الكتابة الأبجدية التي ابتدعوها كما ابتدعوا الانسان الفرد l'individu المؤمن بفرديته وحريته وقدرته على صناعة مصيره بعيدا عن القبيلة والعشيرة دون ما انفصال عنها، بل كفرد حرّ يساهم في بناء مجتمع يتعدى الأواصر الدموية العرقية وينبت المواطنة.
فالكتابة الأبجدية والفرد المؤمن بفرديته وذاته مكسبان يدين بهما الإغريق إلى أولئك الذين كانوا يأتونهم من السواحل الفينيقية على متن سفن حبلى بروائع البضاعة والحضارة فهم القدميون الذين تحدثت عنهم كتب الاغريق واليونان ورفعت ذكرهم، ولمّا استيقظ الإغريق من سبات دام قرونا طويلة واستفادوا من تجارب القدميين الفينيقيين أضحوا يلاحقونهم ويزاحمونهم في غرب البحر المتوسط بهجرة منظمة تشرف عليها المدينة الدولة، وأخرى غير منظمة يتزعمها مغامرون قادرون على الإغراء والقيادة والقدميّون اسم اشتقه الاغريق من اسم قدموس وهو بدوره مشتق من قدم وهي كلمة كنعانية تعني الشرق فقدموس جذوره مشرقية، فهو الذي أقبل من الشرق، فالقدميّون هم المشارقة الذين يأتون من حيث تشرق الشمس.
* محاضرة قُدمت بتاريخ 3 ديسمبر 2015 في إطار ندوة علمية نظمتها الجمعية التونسية للتاريخ والتربية على المواطنة حول "المرأة والمجتمع في تونس عبر التاريخ"
تتظافر الوثائق التاريخية والأثرية لتثبت أن تأسيس قرطاج يعود الى نهاية القرن التاسع قبل ميلاد المسيح ولا شيء يحول دون قبول الرواية القائلة بأنّها أسّست قبل الألعاب الأولمبية الأولى بثمان وثلاثين سنة مع العلم أنّ الألعاب الأولمبية الأولى نظمت سنة ستّ وسبعين وسبعمائة ق.م.
وبتأسيس قرطاج تخلّى الفينيقيون عن سياسة المصارف الوقتية وتوخوا سياسة جديدة تقوم على المستوطنات القارّة والحضور الدائم ودون ما دخول في التفاصيل حول الأسباب والأهداف التي أدت إلى تأسيس قرطاج، فثابت أنّ ما صنّف حول الأميرة عليسة يمتّ الى الخيال بخيوط وله نصيب من الواقع المعيش إذ هي قصة خيالية من وحي الواقع شأنها في ذلك شأن الأساطير جميعها على أنّ الذين أوردوها وتناقلوها لم يتردّدوا في إثرائها بعناصر اقتبسوها من محيطهم ومما تميّزت به عصورهم والأجيال المتعاقبلة. كذلك فعل ورجليوس Virgile وأثراها يوستنوس Justin والسابقون واللاحقون. أمّا الأسطورة فهذه خلاصتها.
عليسة بنت متّن ملك صور أميرة فينيقية أوصي لها بالعرش ولأخيها بجمليون ولكن، بعد وفاة الملك، تنكّر الشعب لتلك الوصيّة وقضى أن يستأثر بجمليون بالعرش وقد تمّ ذلك فعلا. فلم يكن للأميرة إلاّ قبول الأمر الواقع هذا وزفّوها لخالها زكربعل وكان رئيس كهنة معبد ملقرت إله صور وحامي حماها.
ولمّا كان لزوج عليسة ثروة طائلة مغرية تسيل اللّعاب وكان من ذوي الحضور الملحوظ عند أهل الحلّ والعقد في صور، فلا غرو أن يثير الحسد والريبة لدى ملك حسود جشع حقود ممّا جعله لم يتردد في اغتيال خاله وزوج أخته مخترقا حدود الدّين وصلة الرّحم للسطو على ثروته، فلمّا ترملت عليسة ولم يكن لها سند لجأت إلى حيلة حمتها من جشع أخيها الملك وإجرامه فباتت تغالطه مقنعة إيّاه أنّها تبغي العيش في القصر الملكي، بعيدا عن أطياف الموت التي ما انفكّت تحوم في بيت زوجها وتقوّض مضجعها وحاكت خطة هروبها بمساعدة ثلة من بعول المدينة وكبار التجار الذين كانوا يخافون جبروت الملك وأمرت عليسة بترتيب كل شيء تحت طيّ الخفاء.
ولمّا حان الوقت، أقلع الأسطول واندّس في عرض البحر حتّى أصبح بعيدا لا تطوله يد الملك وتمكنت عليسة من السيطرة على عيونه وخدمته، فما أن أبحر الأسطول حتى بادرت الأميرة المهاجرة بإلقاء أكياس في البحر قالت إنّها تحتوي على كنوز زوجها الشهيد، وقد رمتها في اليمّ قربانا لروحه الطّاهرة حتّى تطمئن وتشملها السكينة وفي ذلك رسالة الى من قد يريد التمرّد للاستيلاء على الكنوز المندسّة في بطون السفن، فما بقي للجميع إلاّ مواصلة الرحلة نحو شاطئ السلامة.
وقبل أن يوجه الأسطول الجؤجؤ نحو غربي المتوسط، ألقى مراسيه في جزيرة قبرص وفيها عقدت الأميرة معاهدة مع رئيس الكهنوت في معبد آلهة الجمال عشترت، وهي آلهة الخصب والحب للأحياء وحماية الموتى في قبورهم وفي عبورهم الى مدينة الأرواح وتحيط بعنايتها من في البحر ومن في الحرب وساحة الوغى.
فبمقتضى اتفاق تمّ الوصول اليه بعد مفاوضات جادّة، انضم رئيس كهنوت عشترت وبيته الى رفاق الأميرة كما انضافت اليهم فتيات تمّ اختطافهن على شاطئ الجزيرة حيث كنّ يؤدين شعيرة البغاء المقدّس كما تقتضيه طقوس الآلهة عشترت، وهي شعيرة تحدّث مؤرخون كثيرون عنها، وهي من الشعائر المعروفة لدى عديد الشعوب.

استقبل القبارصة عليسة بحفاوة وسخرّوا لها ولرفقائها وسائل الرّاحة والاستجمام، ولمّا حان الرحيل أبى الكاهن الا أن يشاطر الأميرة عناء السفر فانضمّ الى ركبها صحبة زوجته وأبنائه بعد أن تأكد من بقاء الكهانة في قدس عشترت له ولبنيه. هذا وقد أخذت عليسة ثلّة من الفتيات اللاتي كن يهبن بتولتهن إلى الآلهة وينوس Vénus وهي آلهة الحب والخصب عند الرومان، وقد أطاق يوستينوس هذا الثيونيم Théonyme الروماني على الآلهة الفينيقية عشترت، على أنّه يسميها تارة يونو Junon وطورا وينوس Vénus وهما في الواقع آلهتان مختلفتان، ومعنى ذلك أنّ لعشترت خصائص تقرّبها من يونو وخصائص أخرى تقربها من وينوس حتى أنّها تجمع بين وظائف هذه وتلك.
أمّا فيما يتعّلق بالفتيات اللاتي يهبن بتولتهنّ الى عشترت، فتلك معتقدات معروفة في الشرق القديم من ضفاف دجلة الى سواحل البحر المتوسط، فقد كانت معروفة لدى الايلوميين Elymes وهم قوم يعيشون في غربيّ صقلية ولهم قدس للإلهة وينوس تمارس فيه شعيرة البغاء المقدس، ومضمونها أنّ تقيم الفتيات العذارى في المعبد أو علي شاطئ البحر ويزاوجن من يتقدم إليهن فتلك هي الشعيرة التي يسميها المؤرخون البغاء المقدّس la prostitution sacrée، وقد وصلتنا عنها أصداء كثيرة في كتب القدماء ويبدو أ هذه الشعيرة كانت تمارس في سقّة Sicca، وهي التي أصبحت تسمّى بعد الغزو الروماني Sicca Veneria إشارة إلى علاقتها بوينوس وهي التي سمّا الادريسي "شق بنارية"، وخلفتها مدينة الكاف في الشمال الغربي التونسي.
وأوضح ما لدينا حول هذا الموضوع، نص ورد في الفصل التاسع والتسعين بعد المائة من السفر الأول من تاريخ هيرودوتس وهو كالتالي: «إن أكبر المخزيات في بابل شعيرة تقليدية مضمونها أن تقيم كل امرأة في معبد افروديت مرّة في حياتها وتجامع غريبا أيّا كان. كثيرات هنّ اللاتي يفخرن بالثراء ويعتبرن من غير اللائق بهنّ الاحتكاك بالنساء الأخريات، فتراهن يتوجهن إلى المقدس على متن عربات مغطاة ويمكثن هناك ومعهنّ حشد من الوصيفات والخدم، وأغلبهنّ يتوخّين السلوك التالي: يجلسن في حرم أفروديت المقدّس وعلى رؤوسهنّ تيجان من حبال وهنّ جماعات مقبلات وجماعات مغادرات وبين امرأة وأخرى ممرّات تحدّها حبال من كلّ الجهات، ويشقّ الغرباء تلك الممرّات ويختار كلّ واحد منهم المرأة التي يريد مزاوجتها، مع العلم أنّ المرأة التي تأتي هذا المكان لا تعود إلى بيتها قبل أن يلقي أحد الغرباء نقودا على ركبتيها، وتزاوجه داخل الفضاء المقدس. وعند القاء النقوط لابدّ له من قراءة الكلمات التالية: أمرك باسم الإلهة موليتّا Mylitta، وموليتّا هو اسم أفروديت عند الأشورييين، ومهما تضاءلت قيمة تلك النقود فلا خوف من أن ترفضها المرأة، فلا يحقّ لها ذلك لأنّها نقود مقدّسة، وعلى المرأة أن تخطو خطى أول من يلقي إليها شيئا دون أن تنفر من أحد.
وبعد المزاوجة، تكون قد قامت بواجباتها الدينية فتعود الى بيتها ولن يستطيع كسبها بعد ذلك أحد مهما قدّم إليها. فالنّساء اللاتي لهنّ طلعة صبيحة وهيئة مغرية سرعان ما يعدن الى بيوتهنّ. أمّا القبيحات فقد تطول إقامتهن في المعبد قبل أن تتمكّن من القيام بما يقتضيه الواجب، فمن النساء من تبقين ثلاث أو أربع سنوات داخل الحرم.
لقد أشارت آيات العهد القديم الى شعيرة البغاء المقدس، وقد تفشّى بين قبائل بني إسرائيل تحت تأثير المعتقدات الكنعانية، مع العلم أنّ بني إسرائيل في غالبهم كنعانيون اتبعوا رسالة موسى واعتنقوا ديانته. ومهما يكن من أمر، فآيات التوراة تثبت هي الأخرى وجود البغاء المقدس في يورشليم، فلا يجوز للمؤرخ التشهير ولا التنويه بالشعائر الدينية أيّا كانت اذ لا يحقّ النظر إلى الحضارات القديمة الا من خلال منظارها الخاص ودون حكم لها أو عليها وليس ذلك باليسير.
وبعد هذا الاستطراد، نعود الى عليسة وسفرها الطويل المرهق المحفوف بالأخطار، فقد أرسى الأسطول في ثغر من ثغور شبه الجزيرة التي ستحتضن المستوطنة الجديدة، وحلّت عليسة ورفاقها بأرض معطاء مستفيدين من كرم يربص، ملك المكسويين الذين كانوا اذاك يعمّرون الربوع الممتدة بين جبل بعل ذي القرنين وخليج تونس.
ولعل ربوع المكسويّين كانت تغطي ضواحي قرطاج، حلق الواد والكرم. وبعد الترحاب ومراسم تبادل الهدايا كان لابد لعليسة ورفاقها من فضاء يجدون فيه نصيبا من الرّاحة. ولمّا كان الأهليون يخشون مكوث دخلاء غرباء في ربوعهم، لجأت الأميرة الى حيلة جلد الثور وتتمثل في طلب تناء قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها ما يغطيه جلد الثور، مع العلم أن جلد الثور يسمّى باللغة الإغريقية بيرصا Byrsa، وفي اللغة الفينيقية كلمة برصة تعني الأطم أو القلعة، فإستبهلوها واستجابوا لطلبها علّهم كانوا يريدون معرفة ما عساها أن تفعل بأرض تساوي مساحتها ما يغطّيه جلد ثور.
وما أن تمّ الاتفاق حتى بادرت عليسة بتقطيع جلد الثّور سيرا رقيقا طويلا مكّنها من تسييج مساحة كافية لإقامة مستوطنة فسيحة الأرجاء، ولعلّها بجلد الثور طوّقت الربوة التي ستتخذها أطما يشرف على المستوطنة ويكون لسكّانها ملجأ عند الاقتضاء.
وممّا تداوله بعض المصنّفين القدامى طرفة حول أسّ المستوطنة مضمونها أنّ المعول أخرج رأس ثور فلم تطمئّن عليسة ورفاقها لما منّت به الأرض بل تشاءموا لأنّ الثور ينبئ بالمشقة والعبوديّة، فهو نير ومحراث، فتركوا ذلك المكان واتجهوا إلى موقع ثان يحفرونه لتهيئة الأسّ، فأبرز معول الحفار رأس حصان، وهو رمز القوّة والطوق الى الحرب، فأقيمت قرطاج في ذلك المكان الميمون وسرعان ما ازدهرت مستوطنة عليسة ونمت أخبارها إلى القبائل، فباتت تتردّد عليه الوفود وأرسلت إليها وتيكة سفارة لتقديم الهدايا ولتهنئة المستوطنين وتشجيعهم على البقاء والاستثمار.
كان أمراء القبائل يلتقطون الأخبار عن عليسة ومدينتها وكلهم معجبون بجمالها وحذقها، وكان من بينهم يربص Hiarbas وهو ملك قبيلة المكسويين، فما أن بانت الأميرة حتى افتتن بجمالها المشرقي المشرق وأصبح مسكونا بعشقها لا يفكّر إلاّ فيها وفي الزّواج بها، فأرسل الى قرطاج يطلب عشرة من أعيان سكانها، ولمّا مثّلوا بين يديه أعرب لهم عما يخالجه متحدثا عن حبه لعليسة وعن عزمه على الزواج بها، فأدهشهم وما كانوا يتوقعون ذلك ولكن كيف العمل؟
فإن أجيب الملك بالرفض كانت العاقبة وخيمة، إذ تصبح الحرب حتمية، وقد تذهب المستوطنة الفتية أدراج الرياح، فرجعوا الى ديارهم معتقدين ألاّ سبيل للتخلص من مأزق كهذا إلاّ بواسطة الحيلة. فلما مثلوا بين يدي عليسة لم يخبروها بما جرى، بل قالوا إنّ ملك المكسويين يطلب من أهل قرطاج أن يرسلوا إليها بعض الذين يعلّمونه وشعبه مبادئ الحضارة وأضافوا أنّ ليس من اليسير على المواطن القرطاجي أن يعيش حياة شظف بين أفراد قبيلة خشنة متهورة. فقرّعتهم الملكة وأنكرت عليهم التعالي وحبّ الذّات، فأردوفوا أذاك معربين عما يريده منها يربص، فأجابت وقد وقعت في الفخ أنّها مستعدة للذهاب حيث يناديها مصير قرطاج، وطلبت أن يمهلوها ثلاثة أشهر للنظر في شؤونها وشؤون مدينتها.
وقد أحسنت المناورة مع البقاء مخلصة لروح زوجها دون أن تستفزّ الملك الذي بات يحاصرها فضلا عن ضغوط رفاقها الذين كانوا يؤيّدون زواجا يرون فيه حماية لمستوطنتهم وازدهارها، ثمّ بعد مماطلة جمعت بين الوعود المغرية والذرائع الماكرة، هيأت الأميرة محرقة مُدعيّة أنها تبغي تقديم قربان حذو مقرّ سكناها، ولمّا تجمع الناس يترقبونها خرجت من بيتها وانبرت على منصّة تشرف على الأطيمة، وقالت إنّها ستلتحق بروح زوجها مخلصة لذكراه، ثمّ جرّدت سيفا وأغمدته في صدرها وارتمت في نار الأطيم المؤججة ضحية مقدّسة لذكرى فقيدها وحرصا على ديمومة مدينتها، وقد سمْتها بكلمتين فينيقيتين قرت حدشت، مع العلم أنّ قرت تعني مدينة وحدشت صفة تفيد الحداثة، فقرت حدشت تعني مدينة حديثة أو جديدة من حيث الزمن ومعنى ذلك أنّها أنشأت بعد جديرة Gadir في اسبانيا ولكشة Lixus في المغرب ووتيكة Utica، ومن حيث الوظيفة ومعنى ذلك أنّها مستوطنة قارة توفّر كل ما يحتاجه بناتها ومعمّروها زمنيّا واقتصاديّا وسياسيا واجتماعيا فهي مسؤولة عن تصريف جميع شؤونها.
تلك هي اسطورة قرطاج التي ساهمت في نحت ملامحها أجيال مختلفة الزمن والثقافة، ففيها عناصر تعود الى صور وأخرى جاد بها الخيال الإغريقي الروماني الذي عايشها طيلة قرون عديدةن ولعلّها تمتد من ميناندروس الأفسسي Ménandre d'Ephèse وهو من مصنّفي القرن السادس قبل ميلاد المسيح الى الأسقف الاغريقي أوستاثيوس Eustathe الذي عاش خلال القرن الثاني عشر.
وهكذا نتبيّن أنّ الذين تداولوا اسطورة عليسة في أفواههم وتناقلها حبر أقلامهم تقاسموا ثمانية عشر قرنا لقراءتها ونسخها والتعليق عليها مع ممارسة الحذف والاضافة عن وعي وعن غير وعي شأنها في ذلك شأن الأساطير والملاحم لدى كل الشعوب في مختلف العصور.
وأيّا كان الأمر، فأسطورة قرطاج لها أصول فينيقية صورية (نسبة لمدينة صور)، ومنها معبد ملقرت وكاهنه الأول ولعله كان يسمّى زكربعل وهو علم معروف لدى الفينيقيين في الشرق والمغرب لاسيما في قرطاج.
أمّا معبد ملقرت المشار إليه في الأسطورة، فلقد زاره المؤرخ الاغريقي هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد أثناء مروره بمدينة صور، ولكم شهادته كما وردت في الفصل الرابع والأربعين في السفر الثاني من تاريخه: «لقد شاهدت ذلك المعبد الممهور بأثمن الهدايا ومنها نصبان، أحدهما من ذهب خالص والآخر من زمرد يشعّ بريقا ساطعا في ظلمة الليل، وتجاذبت أطراف الحديث مع كهنة الاله، وسألت كما زمنا مرّ على إقامة مقدسهم، فتبينت أنّهم لا يتفقون هم أيضا مع الإغريق، وقد أجابوا أنّ هذا المقدس تزامن بناؤه مع تأسيس صور، وصور عامرة منذ ألفين وثلاثمائة سنة» فلا شكّ أنّ هذه المعطيات تلوّح إلى العمق الفينيقي الصوري في نسيج الأسطورة.
ولمّا تتوقّف سفن عليسة بجزيرة قبرص، توفّرت لحوك الأسطورة عناصر جديدة تثري نسيجها وكأنّها المشهد الثاني في المسرحيّة، فلقد حطّ الأسطول بشاطئ من شواطئ قبرص وتمّ الاتصال بجالية فينيقية الأصول، وقد كشف الغطاء عن بقايا معبد مخصوص لعبادة عشترت في مدينة كانت تسمى قتيون Kition، وهي التي تركت مكانها لمدينة لرنقة Larnaca فمعبد عشترت بمدينة قتيون ينشر شيئا من المصداقية على المرحلة القبرصية من أسطورة عليسة، مع العلم أنّ أقدم أساسات المعبد الفينيقي القبرصي ترقى إلى القرن التّاسع قبل ميلاد المسيح على أن الموقع كان آهلا بالقبارصة قبل نشأة المستوطنة الفينيقية، فالجالية التي خرجت من صور حلّت بقتيون وجدتها آهلة فانتصبت بجوارها وتعايشت مع سكانها دون اقصاء وسمّت قريتها قرت حدشت، ولعلّها سمّيت كذلك بالنسبة لقتيون القبرصية الأصول والتي كانت قبل أن تكون القرية الفينيقية المحدثة.
وفي قبرص تمّ اختطاف العذارى اللائي كنّ على الشاطئ تبغين إهداء بتولتهنّ الى الربّة عشترت، فهل إهداء البتولة في قبرص من تقاليد الفينيقيين أمّ هي شعيرة من ثوابت الجزيرة؟ فلا شك أنّ قبرص ساهمت في حوك أسطورة عليسة التي غادرت مياه قبرص ومعها جزء منها سيكون له تأثيره في سبك الحضارة البونية في غرب البحر المتوسّط، ثمّ إنّ المجموعة أصبحت بعد مرورها بقبرص متكاملة فيها ما يستوجبه بناء مستوطنة تستطيع البقاء ففيها القدس والحلّ وفيها الأنوثة والرّجولة، فمشروع مدينة متكامل أتى به المهاجرون وكأنّ أسطولهم سفينة نوح تبحث عن شاطئ السلامة لتلقي مراسيها حتى يطمئن من عليها وينتشروا في الأرض.
ما انفك الأسطول يمخر البحر أياما عديدة بلياليها حتى شقّ أمواج خليج يشرف عليه جبل ذو قرنين، فاقترب من الشاطئ ونزل الجميع وجرّت السفن نحو اليابسة فسرعان ما انتشر خبر وجودهم، وكان الاتصال بالأهليين وأولي الأمر عندهم، ولا شكّ أنّ ظروف اللقاء وملابساته وفّرت للأسطورة خيوطا تساهم في حوكها ومنها عشق الملك يربص لعليسة ولعلّ رأس الثور ورأس الحصان المشار إليهما عند حفر الأساسات من رصيد هؤلاء المزارعين المغرمين بالخيل والفروسية.
أمّا حيلة جلد الثور، فثابت أنّها من خيال الإغريقي والتّورية الجناسيّة Calembour وذلك على أساس علاقة صوتية بين الكلمة الإغريقية بورصة Bursa وإحدى الكلمتين التاليتين: الأولى بيرصة وهي من معجم اللغة الآرميّة ومعناها القلعة والثانية برصة وقد أثبتها ابن منظور في لسان العرب حيث قال: البرصة بضمّ الباء هيّ البلّوقة بضمّ اللام وجمعها براص بباء مجرورة، وهي أمكنة من الرمل الأبيض ولا تنبت شيئا، فكلا الكلمتين تنسجم مع السياق، ذلك أن حلّت بشاطئ رماله ممتدة تشرف عليه ربوة كالحصن الحصين. هذا وقد فضّل غالب المؤرخين فرضية القلعة.
وممّا تجدر الإشارة اليه وجود كلمة بأرصة مسطورة على عملة قرطاجية وقد تكون هذه الكلمة البونيّة أساس التورية الجناسية المشار إليها، ومن الذين تناولوا تلك النقود بالدرس وتحليل كلمة بأرصة رأوا أنّها تتركب من حرف ب الذي يحدّد المكان فبكلمة بأرصة يعلن المكلّفين بضرب العملة أنّ النقود التي تحمل تلك العبارة ضربت بأرض الوطن أي بقرطاج نفسها مع العلم أنّ كلمة أرصة تعني الأرض بمعنى الوطن. أمّا إذا اعتبرنا بأرصة كلمة واحدة تتركب من أربعة حروف يجوز اعتبارها منطلق التورية الجناسية التي أوحت بحيلة جلد الثور.
وخلاصة القول إن أسطورة قرطاج استمدت سداها ولحمتها من مصادر ثلاثة وهي مدينة صور وجزيرة قبرص والسواحل الشرقية من لوبة لكنّها ما انفكت تتجدد أخذا وحذفا من جيل الى جيل ومن فيه إلى فيه ومن قلم إلى قلم حتى وصلت إلينا في زيّها الحالي.
فكأن كل من رواها اضاف إليها ما كان يريده لها وحذف منها ما يستوجبه سياق روايته أو ملحمته فضلا عمّا تفرضه قراءته للأحداث ورؤيته لتاريخ الفينيقيين وثقافتهم، فلم يتحرج الشاعر اللاتيني ورجليوس Virgile من حشر قصة حبّ بين الأمير الطروادي أنيوس Enée الذي خرج من طروادة هائما على وجهه على متن سفينة عبثت بها الرياح، كادت تلتهمها الأمواج العارمة، ولئن قلت لم يتحرج الشاعر اللاتيني فذلك إشارة إلى البون الشاسع بين زمن انيوس وزمن عليسة، فالأمير الطروادي عاش في نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد وقصّة الأميرة عليسة لم تكن قبل نهاية القرن التاسع قبل الميلاد، فبينهما فاصل زمني ينيف عن قرنين.
هذا وقد تغنى ورجليوس بمغامرة أنيوس الطروادي مع عليسة الفينيقية الصورية في بداية القرن الأول قبل الميلاد وكان ذلك بطلب من الإمبراطور أجوستوس Auguste الذي تبوّأ عرش الامبراطورية الرومانية من سنة 27 قبل الميلاد الى سنة 14 بعد الميلاد وهو الذي أحيا قرطاج بعد موتها عملا بوصية أبيه المتبنّي يوليوس قيصر Jules César.
أمّا الأسباب والأهداف التاريخية التي أنجبت قرطاج، فقد يستشفّها المؤرخ في الأوضاع التي سيطرت في الشرق والغرب: فشرقا كانت المدن الفينيقية اذ ذاك تعيش خطرا أشوريّا يهدّد كيانها وأموالها: وقد كان ملوك أشور يعبرون الفرات في طريقهم نحو السواحل الكنعانية يغنمون، وفي حولياتهم ما يفيد أنّ أول حملة قام بها الأشوريون نحو البحر وجبال الأرز تعود الى عهد تجلتفليسر الأول (1120 ـ 1074 قبل ميلاد المسيح) وتواصلت الحملات الأشورية ومنها غزوات اشورناصر بعلالثاني (888ـ859 ق. م) وفي حولياته ما يشير إلى ما كانت تعانيه المدن الفينيقية من جبروت ملوك أشور، وثبت أنهم كانوا يردون ضمّها والقضاء على كيانها السياسي واستغلال قدراتها الاقتصادية ووضع ايديهم على كنوزها. فليس من الغريب أن تتوقع المدن الفينيقية هذا التصعيد في سياسة الأشوريين إزاءهم ولا يستغرب أن تفكّر في حل يخلّصها من الملزمة. بات الغول الأشوري يتهيّأ للإجهاز على فريسته وتهشيم هياكلها.
أليس الحل في الهروب بعيدا حيث لا يستطيع الاشوريون ملاحقة الكنوز الفينيقية؟ تلك هي الظروف القاسية التي سيطرت على حياة صور وصيدا وجبيل وبيريت وارواد وغيرها من مدن السواحل الكنعانية، وقد أصابها الوهن من جراء ذلك ممّا أثر على حضور الفينيقيين في غربي البحر الأبيض المتوسط حيث كانوا أسيادا ينفردون بالكسب والسلطان وقد تزامن الخطر الأشوري مع استفاقة المدن اليونانية والإغريقية من سباتها، وقد استفادت من تجارب الفينيقيين الذين كانوا يترددون عليهم وفي بطون سفنهم بضاعة الشرق وحضارتها الأصلية وكم اينعت فسائل الشرق في ارض الإغريق.
قد يطول الكلام عمّا يدين به الإغريق الى الفينيقيين وليس المجال هنا لتناول مثل هذه القضايا الخطيرة بل نكتفي بالإشارة إلى الكتابة الأبجدية التي ابتدعوها كما ابتدعوا الانسان الفرد l'individu المؤمن بفرديته وحريته وقدرته على صناعة مصيره بعيدا عن القبيلة والعشيرة دون ما انفصال عنها، بل كفرد حرّ يساهم في بناء مجتمع يتعدى الأواصر الدموية العرقية وينبت المواطنة.
فالكتابة الأبجدية والفرد المؤمن بفرديته وذاته مكسبان يدين بهما الإغريق إلى أولئك الذين كانوا يأتونهم من السواحل الفينيقية على متن سفن حبلى بروائع البضاعة والحضارة فهم القدميون الذين تحدثت عنهم كتب الاغريق واليونان ورفعت ذكرهم، ولمّا استيقظ الإغريق من سبات دام قرونا طويلة واستفادوا من تجارب القدميين الفينيقيين أضحوا يلاحقونهم ويزاحمونهم في غرب البحر المتوسط بهجرة منظمة تشرف عليها المدينة الدولة، وأخرى غير منظمة يتزعمها مغامرون قادرون على الإغراء والقيادة والقدميّون اسم اشتقه الاغريق من اسم قدموس وهو بدوره مشتق من قدم وهي كلمة كنعانية تعني الشرق فقدموس جذوره مشرقية، فهو الذي أقبل من الشرق، فالقدميّون هم المشارقة الذين يأتون من حيث تشرق الشمس.
* محاضرة قُدمت بتاريخ 3 ديسمبر 2015 في إطار ندوة علمية نظمتها الجمعية التونسية للتاريخ والتربية على المواطنة حول "المرأة والمجتمع في تونس عبر التاريخ"









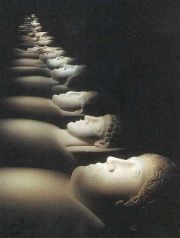









تعليق