أضع ما وجدته في جعبتي بعد النظر في معجم لسان العرب لابن منظور
ومختار الصحاح للرازي : عن مادة : الفعل ( ل ك ك )
يقول صاحب اللسان :
لَكَّ الرجلَ يَلُكُّه لَكّاً. ضربه بجُمْعه في قفاه، وقيل: هو إذا ضربه ودفعه، وقيل لَكَّه ضربه مثل صَكّه. الأَصمعي: صَكَمْته ولَكَمْتُه وصَكَكْتُه ودَكَكْنُه و(لَكَكْتُه) كُلُّه إذا دفعته.
واللِّكاكُ: الزِّحامُ.
وفي الصحاح يقول صاحب المعجم :
لَكّهُ، أي ضربه، مثل صكَّهُ.
=====
أما مادة الفعل الرباعي : لكلك (ل ك ل ك )
فلم توردها المعاجم التي في حوزتي أو مما اطلعت عليه .
لذا فأراها لفظة غير فصحى , وربما تحرفت من الفعل الثلاثي (لكَّ )
إلى العامية , من دفع المرأة الكلام متتابعا في ثرثرة متواصلة .فيتزاحم في خروجه .
ومن لديه علم بإضافة جديدة فليتكرم علينا بها . مع جزيل الشكر
والله تعالى أعلى وأعلم .
ومختار الصحاح للرازي : عن مادة : الفعل ( ل ك ك )
يقول صاحب اللسان :
لَكَّ الرجلَ يَلُكُّه لَكّاً. ضربه بجُمْعه في قفاه، وقيل: هو إذا ضربه ودفعه، وقيل لَكَّه ضربه مثل صَكّه. الأَصمعي: صَكَمْته ولَكَمْتُه وصَكَكْتُه ودَكَكْنُه و(لَكَكْتُه) كُلُّه إذا دفعته.
واللِّكاكُ: الزِّحامُ.
وفي الصحاح يقول صاحب المعجم :
لَكّهُ، أي ضربه، مثل صكَّهُ.
=====
أما مادة الفعل الرباعي : لكلك (ل ك ل ك )
فلم توردها المعاجم التي في حوزتي أو مما اطلعت عليه .
لذا فأراها لفظة غير فصحى , وربما تحرفت من الفعل الثلاثي (لكَّ )
إلى العامية , من دفع المرأة الكلام متتابعا في ثرثرة متواصلة .فيتزاحم في خروجه .
ومن لديه علم بإضافة جديدة فليتكرم علينا بها . مع جزيل الشكر
والله تعالى أعلى وأعلم .
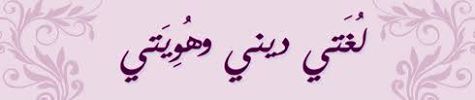
تعليق