جمع ما فيه ياء النسب ...
أساتذة وأساتيذ ... وجمع ما فيه ياء النسب ...
أساتيذ جمع أستاذ إذا اعتبرنا أستاذ على وزن فعلال وجمعها فعاليل
نحو: قنطار قناطير، خلْخال خلاخيل، شُحرور شحارير، تلميذ تلاميذ، قنديل قناديل، عصفور عصافير.
وأساتيذ جمع أستاذ على اعتبار أن أستاذ على وزن أفعال وجمعها أفاعيل
نحو: إعصار أعاصير، إكليل أكاليل، أسلوب أساليب، إبريق أباريق.
أما "أساتذة" على وزن "أفاعلة" فالمفروض أن تكون جمعا قياسيا لكلمة "أستاذيّ" بياء النسب، وذلك لأن كتب النحو والصرف تقول أن ما فيه ياء النسب يجمع على "أفاعلة".
وعلى هذا يفترض أن يكون "الأستاذي" أو "الأساتيذي" هو الشخص المتمتع بدرجة الأستاذية بدليل نسبته إليها، وأن "الأساتذة" تعني جماعة "الأستاذيين" أو "الأساتيذيين" المتمتعين بدرجة "الأستاذية" أو "الأساتيذية"، وأن "أساتذة" هي الجمع القياسي لكلمة "أستاذيّ" أو "أساتيذيّ" بالياء المشددة لا كلمة "أستاذ" التي ينبغي جمعها على أساتيذ فقط.
أمثلة على الجمع بصيغة أفاعلة ومفرد ما فيه ياء النسب:
منصوري (مناصيري) تجمع على مناصرة
أفريقي (أفاريقي) تجمع على أفارقة
أمزيغي (أمازيغي) تجمع على أمازغة
أشعري (أشاعري) تجمع على أشاعرة
مغربي (مغاربي) تجمع على مغاربة
مشرقي (مشارقي) تجمع على مشارقة
نابلسي (نبالسي) تجمع على نبالسة
ثعلبي (ثعالبي) تجمع على ثعالبة
شركسي (شراكسي) تجمع على شراكسة
منذري (مناذري) تجمع على مناذرة
سلجوقي (سلاجيقي) تجمع على سلاجقة
قرموطي (قراميطي) تجمع على قرامطة
مطراني (مطاريني) تجمع على مطارنة
غساني (غساسيني) تجمع على غساسنة
قرآني (قرائيني) تجمع على قرائنة (وهم المدعوون بالقرآنيين)
إبريقي (أباريقي) (بائع الأباريق) تجمع على أبارقة، أما إبريق فتجمع على أباريق
إبليسي (أباليسي) (المنتسب لإبليس) تجمع على أبالسة، أما إبليس فتجمع على أباليس
وهلم جرا ...
علما بأن صيغ الجموع المختلفة لنفس الكلمة المفردة يكون لها معان مختلفة عندما يختلف السياق. تأمل في أعين (جمع العين المبصرة) وعيون (جمع عين الماء)، وتأمل في حُمُر (جمع الحمار الوحشي)، وحمير (جمع الحمار الأهلي) الواردة في القرآن الكريم على سبيل المثال.
المشاركة الأصلية بواسطة عبد الله لالي
مشاهدة المشاركة
أساتيذ جمع أستاذ إذا اعتبرنا أستاذ على وزن فعلال وجمعها فعاليل
نحو: قنطار قناطير، خلْخال خلاخيل، شُحرور شحارير، تلميذ تلاميذ، قنديل قناديل، عصفور عصافير.
وأساتيذ جمع أستاذ على اعتبار أن أستاذ على وزن أفعال وجمعها أفاعيل
نحو: إعصار أعاصير، إكليل أكاليل، أسلوب أساليب، إبريق أباريق.
أما "أساتذة" على وزن "أفاعلة" فالمفروض أن تكون جمعا قياسيا لكلمة "أستاذيّ" بياء النسب، وذلك لأن كتب النحو والصرف تقول أن ما فيه ياء النسب يجمع على "أفاعلة".
وعلى هذا يفترض أن يكون "الأستاذي" أو "الأساتيذي" هو الشخص المتمتع بدرجة الأستاذية بدليل نسبته إليها، وأن "الأساتذة" تعني جماعة "الأستاذيين" أو "الأساتيذيين" المتمتعين بدرجة "الأستاذية" أو "الأساتيذية"، وأن "أساتذة" هي الجمع القياسي لكلمة "أستاذيّ" أو "أساتيذيّ" بالياء المشددة لا كلمة "أستاذ" التي ينبغي جمعها على أساتيذ فقط.
أمثلة على الجمع بصيغة أفاعلة ومفرد ما فيه ياء النسب:
منصوري (مناصيري) تجمع على مناصرة
أفريقي (أفاريقي) تجمع على أفارقة
أمزيغي (أمازيغي) تجمع على أمازغة
أشعري (أشاعري) تجمع على أشاعرة
مغربي (مغاربي) تجمع على مغاربة
مشرقي (مشارقي) تجمع على مشارقة
نابلسي (نبالسي) تجمع على نبالسة
ثعلبي (ثعالبي) تجمع على ثعالبة
شركسي (شراكسي) تجمع على شراكسة
منذري (مناذري) تجمع على مناذرة
سلجوقي (سلاجيقي) تجمع على سلاجقة
قرموطي (قراميطي) تجمع على قرامطة
مطراني (مطاريني) تجمع على مطارنة
غساني (غساسيني) تجمع على غساسنة
قرآني (قرائيني) تجمع على قرائنة (وهم المدعوون بالقرآنيين)
إبريقي (أباريقي) (بائع الأباريق) تجمع على أبارقة، أما إبريق فتجمع على أباريق
إبليسي (أباليسي) (المنتسب لإبليس) تجمع على أبالسة، أما إبليس فتجمع على أباليس
وهلم جرا ...
علما بأن صيغ الجموع المختلفة لنفس الكلمة المفردة يكون لها معان مختلفة عندما يختلف السياق. تأمل في أعين (جمع العين المبصرة) وعيون (جمع عين الماء)، وتأمل في حُمُر (جمع الحمار الوحشي)، وحمير (جمع الحمار الأهلي) الواردة في القرآن الكريم على سبيل المثال.

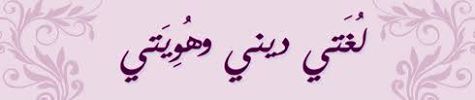
تعليق